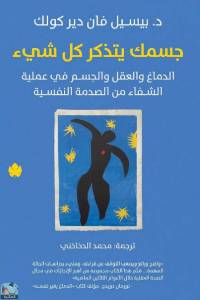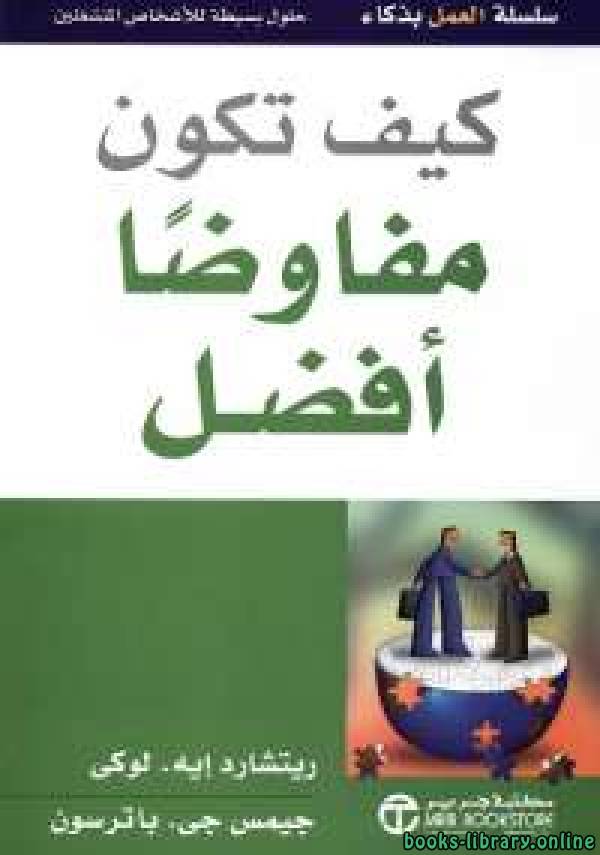❞حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ❝ - المكتبة
حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ - المكتبة - ❞حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ❝
دليل الكتب والمؤلفين ودور النشر والفعاليات الثقافيّة ، اقتباسات و مقتطفات من الكتب ، أقوال المؤلفين ، اقتباسات ومقاطع من الكتب مصنّفة حسب التخصص ، نصيّة وصور من الكتب ، وملخصات للكتب فيديو ومراجعات وتقييمات 2025
إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
-
❞ ملخص كتاب "قد نفسك أولا"
كيف تصنع قيادة ملهمة تبدأ بمعرفة نفسك؟ 📕 فائدة من كتاب "قد نفسك أولا":
1. السيطرة على الأفكار والمشاعر الداخلية :
يشير الكتاب إلى أن التحدي الأكبر للقادة ليس فقط في التعامل مع العوامل الخارجية، مثل الضغوط والتحديات المهنية، بل في التغلب على الضوضاء الداخلية، المتمثلة في القلق والأفكار السلبية. القدرة على التحكم في هذه العوامل الداخلية تمنح القائد وضوحًا في التفكير واتزانًا في اتخاذ القرارات.. ❝ ⏤مجموعة من المؤلفينملخص كتاب "قد نفسك أولا"
كيف تصنع قيادة ملهمة تبدأ بمعرفة نفسك؟
📕 فائدة من كتاب "قد نفسك أولا":1. السيطرة على الأفكار والمشاعر الداخلية يشير الكتاب إلى أن التحدي الأكبر للقادة ليس فقط في التعامل مع العوامل الخارجية، مثل الضغوط والتحديات المهنية، بل في التغلب على الضوضاء الداخلية، المتمثلة في القلق والأفكار السلبية. القدرة على التحكم في هذه العوامل الداخلية تمنح القائد وضوحًا في التفكير واتزانًا في اتخاذ القرارات.
2. تعزيز الصفاء الذهني والإبداع يُبرز الكتاب أهمية ممارسات مثل التأمل وتمارين التنفس كوسائل فعالة في تهدئة العقل وزيادة التركيز. هذه الممارسات لا تساعد فقط في التخلص من التوتر، بل تفتح المجال أمام التفكير الإبداعي، مما يمكن القادة من إيجاد حلول مبتكرة واتخاذ قرارات أكثر حكمة.
3. القيادة تبدأ من الداخل قبل التأثير على الآخرين يوضح الكتاب أن القيادة الحقيقية لا تبدأ بإدارة فريق أو توجيه الآخرين، بل بتطوير الذات أولًا. القادة العظماء يعملون على تنمية مهاراتهم الذاتية، وضبط أفكارهم، والتعامل مع نقاط ضعفهم قبل أن يسعوا للتأثير في من حولهم. هذا يعزز من مصداقيتهم ويجعل تأثيرهم أكثر استدامة.
4. إعادة التفكير في مفهوم القيادة يعيد الكتاب تعريف القيادة على أنها ليست مجرد منصب أو سلطة، بل رحلة شخصية نحو التأثير الإيجابي. القائد الحقيقي هو من يستطيع أن يجد القوة والحكمة داخل نفسه، ومن ثم يستخدمها لصنع تغيير إيجابي في بيئته. هذا المفهوم يشجع على التحول من القيادة التقليدية التي تركز على التحكم، إلى قيادة تعتمد على الإلهام والتوجيه الأخلاقي.
5. أهمية العزلة كأداة للتطوير الذاتي يؤكد الكتاب أن العزلة ليست مجرد انقطاع عن الآخرين، بل هي وسيلة فعالة لإعادة التركيز على الأهداف والتفكير العميق في القرارات. تمنح العزلة القائد فرصة لتقييم ذاته، وتقوية شجاعته الأخلاقية، مما يساعده على اتخاذ قرارات صائبة مبنية على رؤية واضحة.
6. تحقيق تأثير إيجابي مستدام يبرز الكتاب أن القيادة الفعالة لا تقتصر على تحقيق إنجازات قصيرة المدى، بل تهدف إلى خلق تأثير إيجابي مستدام. من خلال تطوير الذات والوضوح الداخلي، يصبح القائد أكثر قدرة على إلهام الآخرين، وتعزيز بيئة إيجابية تدعم النمو والنجاح المشترك.
قراءة ملخص كتاب قد نفسك أولا ⏤ مجموعة من المؤلفين -
❞ 📕 فائدة من كتاب "الانضباط العاطفي" :
السيطرة على مشاعرك ليست خيارًا، بل مهارة. تعلم كيف تُتقن الكونغ فو العاطفي!
فهم المشاعر وتحليلها: :
يُعلمك الكتاب كيفية التعرف على المشاعر، سواء كانت إيجابية أو سلبية، واستخدامها كفرص للنمو الشخصي بدلًا من كونها عبئًا نفسيًا.. ❝ ⏤شارلز مانز📕 فائدة من كتاب "الانضباط العاطفي" :
السيطرة على مشاعرك ليست خيارًا، بل مهارة. تعلم كيف تُتقن الكونغ فو العاطفي!فهم المشاعر وتحليلها: يُعلمك الكتاب كيفية التعرف على المشاعر، سواء كانت إيجابية أو سلبية، واستخدامها كفرص للنمو الشخصي بدلًا من كونها عبئًا نفسيًا.
تعزيز التفكير الإيجابي والسيطرة العقلية: يبرز أهمية العقل في قيادة المشاعر من خلال تبني التفكير الواضح واتخاذ قرارات واعية تساهم في تحسين المزاج والسعادة.
التكامل بين العقل والجسد: يقدم الكتاب أدوات عملية مثل التأمل وتمارين التنفس الواعي التي تعمل على تحسين الحالة الجسدية وبالتالي تعزيز القدرة على التحكم في العواطف.
تطوير السلام الداخلي من خلال الروحانية: يشدد على أهمية الروحانية، مع الإشارة إلى ممارسات دينية كالصلاة والذكر، لتحقيق توازن داخلي وسلام نفسي.
تحويل التحديات العاطفية إلى فرص للنمو: يُظهر كيف يمكن تحويل المشاعر السلبية مثل الغضب والقلق إلى أدوات للتعلم والتطور بدلاً من أن تكون مجرد عقبات.
اختيار المشاعر وتحقيق جودة الحياة: يُبرز مفهوم أن التحكم بالعواطف ليس قمعًا لها، بل هو خيار واعٍ يمكن أن يؤدي إلى حياة أكثر سعادة وتوازنًا.
اخيرا يمثل الكتاب دليلًا عمليًا يربط بين العقل والجسد والروح، مما يمكِّنك من مواجهة تحديات الحياة وتحقيق توازن داخلي يحفزك على التطور والسعادة.
قراءة ملخص كتاب الانضباط العاطفي ⏤ شارلز مانز -
-
❞ ملخص كتاب " كيف تكون مفاوضا أفضل ؟ " حلول بسيطة للأشخاص المنشغلين.
1- ما المفاوضة وما أنواعها ؟ :
التفاوض هو عملية تهدف إلى تقليل الصراعات وحسم الخلافات بشكل يحقق الفائدة للطرفين بأقل الخسائر. يمكن تقسيم المفاوضات إلى نوعين: 1- مفاوضات مكسب - خسارة: حيث يكون المكسب لطرف واحد على حساب الآخر، مثل التفاوض على سعر سيارة، حيث كلما قل السعر بالنسبة للمشتري، كان ذلك خسارة للبائع والعكس. 2- مفاوضات مكسب - مكسب: حيث يسعى الطرفان لتحقيق فائدة متبادلة، ويكون للعلاقات دور فعال. في هذا النوع، يمكن تلبية احتياجات الطرف الآخر بطريقة تكون ذات قيمة أقل لك ولكن قيمة عالية له، مما يحول المفاوضة إلى مكسب للطرفين. على سبيل المثال، يمكن أن تعرض شراء شقة بسعر أقل للبائع الذي يريد بيعها بسرعة للسفر، وبذلك يتحقق مكسب للطرفين. . ❝ ⏤مجموعة من المؤلفينملخص كتاب " كيف تكون مفاوضا أفضل ؟ " حلول بسيطة للأشخاص المنشغلين.
1- ما المفاوضة وما أنواعها ؟ التفاوض هو عملية تهدف إلى تقليل الصراعات وحسم الخلافات بشكل يحقق الفائدة للطرفين بأقل الخسائر. يمكن تقسيم المفاوضات إلى نوعين: 1- مفاوضات مكسب - خسارة: حيث يكون المكسب لطرف واحد على حساب الآخر، مثل التفاوض على سعر سيارة، حيث كلما قل السعر بالنسبة للمشتري، كان ذلك خسارة للبائع والعكس. 2- مفاوضات مكسب - مكسب: حيث يسعى الطرفان لتحقيق فائدة متبادلة، ويكون للعلاقات دور فعال. في هذا النوع، يمكن تلبية احتياجات الطرف الآخر بطريقة تكون ذات قيمة أقل لك ولكن قيمة عالية له، مما يحول المفاوضة إلى مكسب للطرفين. على سبيل المثال، يمكن أن تعرض شراء شقة بسعر أقل للبائع الذي يريد بيعها بسرعة للسفر، وبذلك يتحقق مكسب للطرفين.
2- المفاهيم المتعلقة بعملية التفاوض لإتقان مهارة التفاوض والحصول على أفضل النتائج، من المهم فهم بعض المفاهيم الأساسية: 1- البدائل: امتلاك خيارات بديلة يمنحك القدرة على المساومة أو الانسحاب من الصفقة إذا لم تكن الشروط ملائمة. بدون بدائل، ستكون تحت رحمة الطرف الآخر. 2- السعر المعقول: هذا هو السعر الذي ينسحب عنده كل من البائع والمشتري إذا لم يعد السعر مجديًا لهما. تحديد السعر المعقول للطرفين يساعد في تجنب صفقات غير مرضية. 3- منطقة الاتفاق: هي النطاق السعري الذي يمكن للطرفين الاتفاق عليه ويشعران بالرضا تجاهه. للوصول إلى هذه المنطقة، يجب استخدام مهارات الاستماع بفعالية. الاستماع الجيد يعزز فهم احتياجات الطرف الآخر ويساعد في تحسين التواصل واتخاذ القرارات. التركيز على ما يقوله الطرف الآخر، تجنب الإلهاءات، وتدوين الملاحظات يمكن أن يحسن عملية التفاوض بشكل كبير. تجنب الجدال والمقاطعة، إلا إذا كان ذلك بهدف طلب توضيح.
3- في أثناء التفاوض مرحلة الصراع أمر لا مفر منه، حيث تحدث نتيجة الاختلافات في الأهداف والمنافسات والعداوات. من الأفضل معالجة الصراعات بسرعة بدلاً من تركها للوقت لحلها.
هناك خمس استراتيجيات لحل الصراعات، تختلف باختلاف طبيعة المشكلة: 1- الانسحاب: مناسبة للمشكلات التافهة، لكنها تؤجل المواجهة. 2- التهدئة: تستخدم عندما يكون هناك خطر تدمير العلاقة بين الطرفين، وتمنح الوقت للبحث عن حل. 3- التسوية: تُستخدم عندما يكون الطرفان متساويين في القوة ويرفضان التنازل. 4- الإكراه أو التنافس: تُستخدم عندما يتوقع كل طرف صراعًا من الطرف الآخر. 5- التعاون: مناسبة لعلاقات طويلة المدى وأهداف مشتركة، لكنها تستهلك الكثير من الوقت، مما يجعلها غير مناسبة للحلول السريعة. لإتقان فن المفاوضة وحل الصراعات، يجب أن تكون حازمًا في الدفاع عن حقوقك. يُمكنك القول بـ"لا" بوضوح مع تقديم بديل، كما يُمكنك امتصاص غضب الآخرين عن طريق الاستماع لهم وتقديم أسئلة مفتوحة لفهم المشكلة. إذا كنت أنت الغاضب، فحاول تهدئة نفسك بالتنزه والتفكير بهدوء.
4- كيف تعد لتفاوض ناجح ؟ محترفو التفاوض لا يرتجلون بل يستعدون جيدًا، يقضون ساعات في البحث حول القضية، بدائلهم، تحديد سعرهم المعقول، وتوقع سعر الطرف الآخر. يتضمن التفاوض خمس مراحل: 1- التعارف: بناء علاقة وتقييم الطرف الآخر، مما يعزز الثقة ويهيئ الجو للتفاوض. 2- بدء المفاوضة: تحديد أهداف الطرف الآخر، واختيار ترتيب مناقشتها. 3- مرحلة الصراع: اكتشاف ما يحتاجه الطرف الآخر، والبقاء مرنًا لتقديم تنازلات أو تعديل الأهداف. 4- الاستماع التأملي: ترديد عرض الطرف الآخر على شكل سؤال لإعطائه فرصة لتحسين موقفه أو لتبرير عرضه، مما يتيح وقتًا للتفكير. 5- التوصل إلى اتفاق: يجب أن يكون الاتفاق مكتوبًا وملزمًا، مع تحديد عواقب لعدم الالتزام، ويُوثّق بالتوقيعات النهائية. هذه الخطوات تضمن تفاوضًا فعالًا يؤدي إلى نتائج مرضية لكلا الطرفين.
5- أخطاء ومآزق شائعة التفاوض في الواقع مليء بالتحديات، ويستخدم محترفو التفاوض حيلًا للتأثير على الطرف الآخر. معرفة هذه الحيل والطرق لإبطالها هو دفاعك الأفضل: 1- المقايضون الصارمون (مكسب - خسارة): يهدفون لتحقيق مكاسب على حساب الطرف الآخر، مما يدفع المبتدئين لتقديم تنازلات. للحماية، ارفع سقف توقعاتك وقدم عرضًا كبيرًا يمنحك مساحة للتفاوض. 2- خدعة "المفاوض الطيب والمفاوض الشرير": حيث يظهر اثنان، أحدهما منفعل والآخر طيب، لجعلك تشعر بالذنب وتقديم التنازلات. لتجنب ذلك، التزم بخطتك وأهدافك ولا تنخدع بالمواقف المتباينة. 3- التعجل في إنهاء الاتفاق: قد يستغل الطرف الآخر استعجالك للموافقة على شروطه. لتجنب هذا، خطط وقتك بذكاء وراجع كل بند بعناية. 4- التحكيم والوساطة عند الفشل: إذا تعثرت المفاوضات وكان المكسب كبيرًا، يمكن اللجوء إلى التحكيم (طرف ثالث محايد يقرر النتائج) أو الوساطة (طرف ثالث يساعد على الوصول إلى اتفاق ملائم). اتباع هذه الاستراتيجيات سيمكنك من الحفاظ على موقفك وتحقيق أهدافك خلال التفاوض.
قراءة ملخص كتاب كيف تكون مفاوضًا أفضل؟ ⏤ مجموعة من المؤلفين -
حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ مكتبة جرير التنمية البشرية تنمية بشرية almokawil كتب تنمية الذات بناء الذات علم الشخصية و علم النفس تطوير الذات مهارات 50 نصيحة لتنمية تقديرك لذاتك #تنمية_ذاتية تنميةبشرية تنمية بشرية وتطوير ذات مهارات تطوير الذات التنمية الذاتية كتب التنميه البشريه مهارات التواصل #كتب_تنمية علوم اجتماعية طب نفسي #تنمية_بشرية النفس البشرية لغة الجسد موارد بشرية 2024 Amr Hashem Rabie النجاح وتطوير الذات مجموعة من المؤلفين “تنمية
-
❞ ملخص كتاب " كيف تتحدث إلى أي شخص" 92 خدعة صغيرة للوصول إلى علاقات إنسانية أكثر نجاحًا
كتاب كيف تتحدث إلى أي شخص من تأليف ليل لوندز هو مصدر قيم للتواصل الفعال مع الآخرين وتطوير مهارات التحدث. يقدم الكتاب العديد من النصائح والاستراتيجيات التي تساعدك في التواصل مع أي شخص بثقة وفعالية.
1 - فهم أساسيات التواصل::
يبدأ الكتاب بشرح أساسيات التواصل وأهميتها في الحياة اليومية والعلاقات الشخصية والمهنية. . ❝ ⏤ليل لوندزملخص كتاب " كيف تتحدث إلى أي شخص" 92 خدعة صغيرة للوصول إلى علاقات إنسانية أكثر نجاحًا
كتاب كيف تتحدث إلى أي شخص من تأليف ليل لوندز هو مصدر قيم للتواصل الفعال مع الآخرين وتطوير مهارات التحدث. يقدم الكتاب العديد من النصائح والاستراتيجيات التي تساعدك في التواصل مع أي شخص بثقة وفعالية.1 - فهم أساسيات التواصل: يبدأ الكتاب بشرح أساسيات التواصل وأهميتها في الحياة اليومية والعلاقات الشخصية والمهنية.
2 - تطوير مهارات الاستماع: يشدد الكتاب على أهمية الاستماع الفعّال وكيفية تحسين هذه المهارة لفهم مشاعر واحتياجات الآخرين.
3 - التحدث بثقة: يقدم الكتاب نصائح حول كيفية التحدث بثقة وجعل صوتك ولغتك الجسدية تعبر عن اتزانك واستقرارك.
4 - التفاعل مع شخصيات مختلفة: يتعامل الكتاب مع كيفية التعامل مع أشخاص ذوي شخصيات متنوعة وكيفية التكيف معهم.
5 - حل النزاعات: يقدم الكتاب استراتيجيات لحل النزاعات بفعالية وبناء علاقات إيجابية.
6- الاستفادة من التواصل الرقمي: يتناول الكتاب كيفية التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني بشكل فعّال.
7 - تجنب الأخطاء الشائعة: يُظهر الكتاب أخطاء التواصل الشائعة وكيفية تجنبها.
خلاصة كتاب " كيف تتحدث إلى أي شخص " يعتبر دليلًا قيمًا لتطوير مهارات التواصل وتحسين العلاقات الشخصية والمهنية. يقدم الكتاب استراتيجيات عملية وأمثلة تطبيقية تساعدك على تحسين قدراتك في التفاوض والتحدث بثقة مع أي شخص تقابله.
قراءة ملخص كتاب كيف تتحدث إلى أي شخص ⏤ ليل لوندز

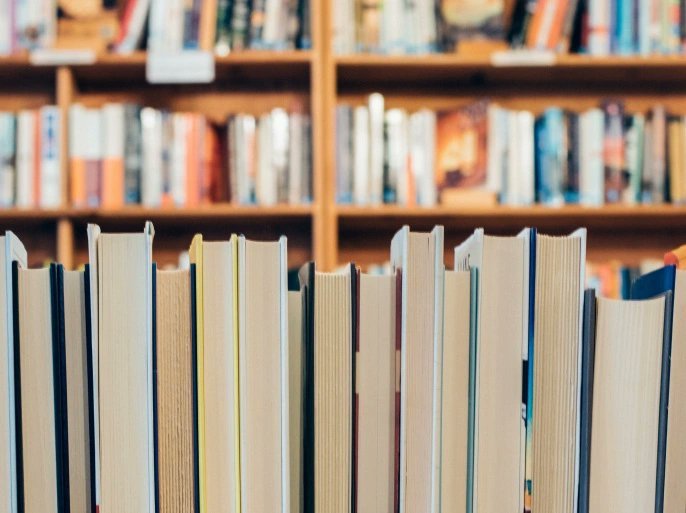











 23
23
 4
4
 3
3
 1
1
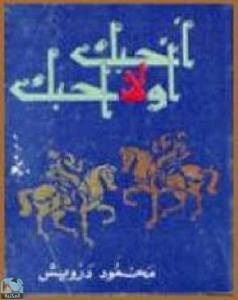 22
22
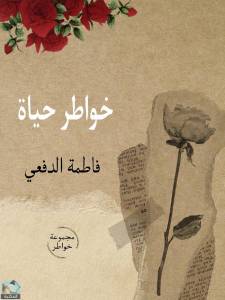 17
17
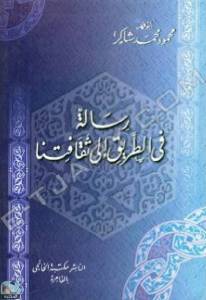 11
11
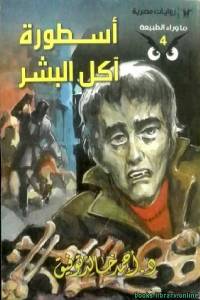 16
16
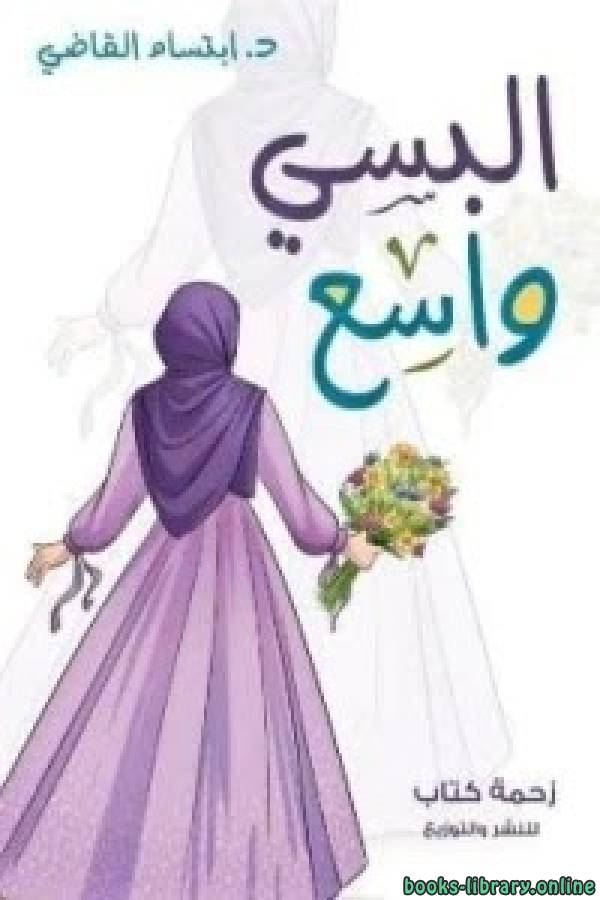 45
45
 المزيد في كتب عشاق الرسالة
المزيد في كتب عشاق الرسالة
 0
0








 3
3
 9
9
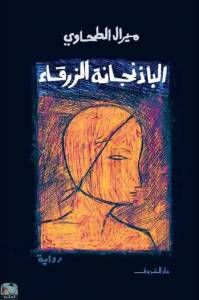 1
1
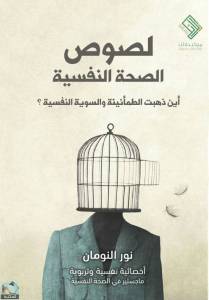 1
1
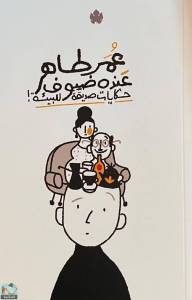 9
9
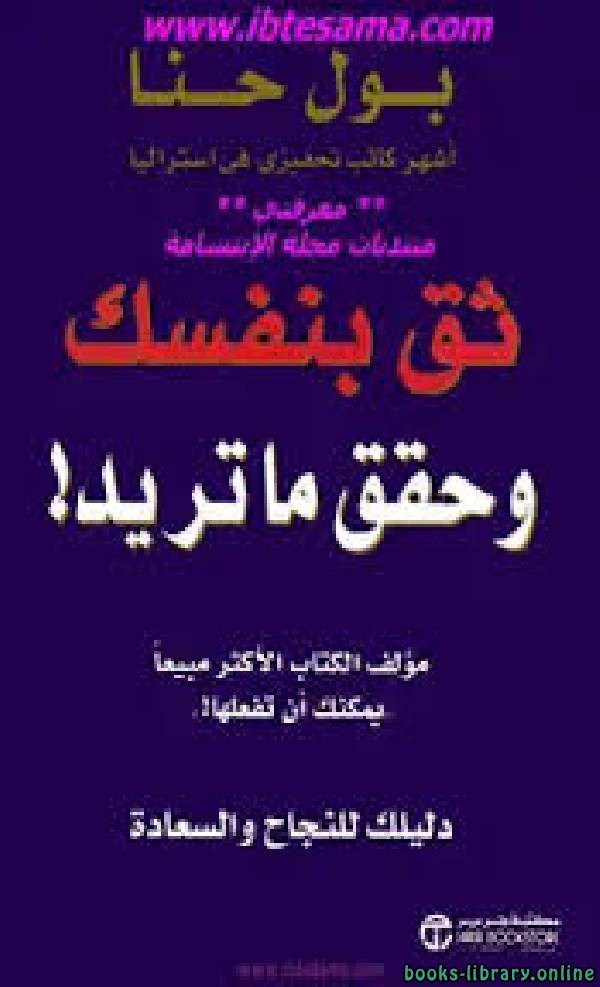 2
2
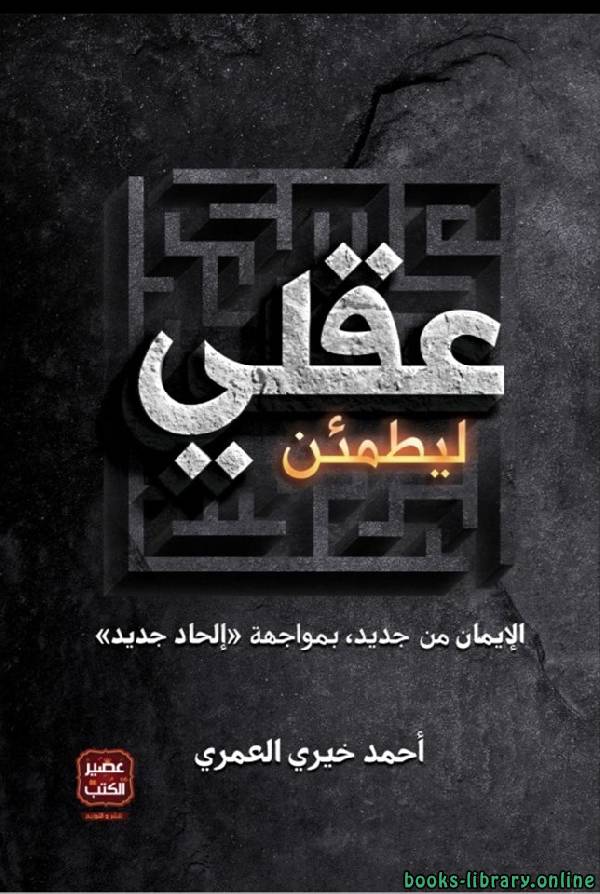 20
20
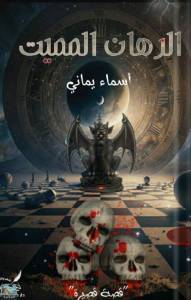 4
4
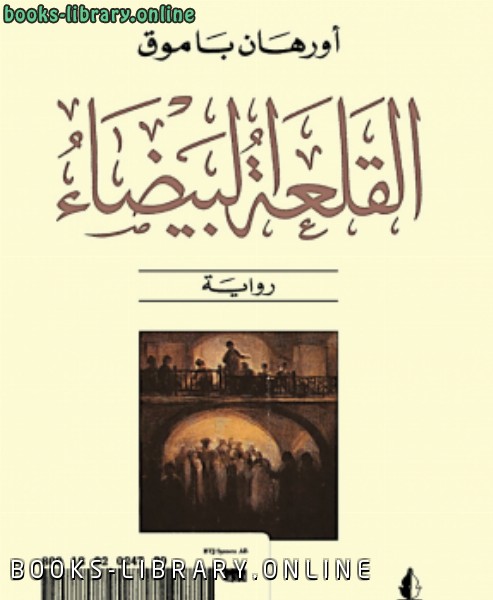 4
4
 153
153
 1
1
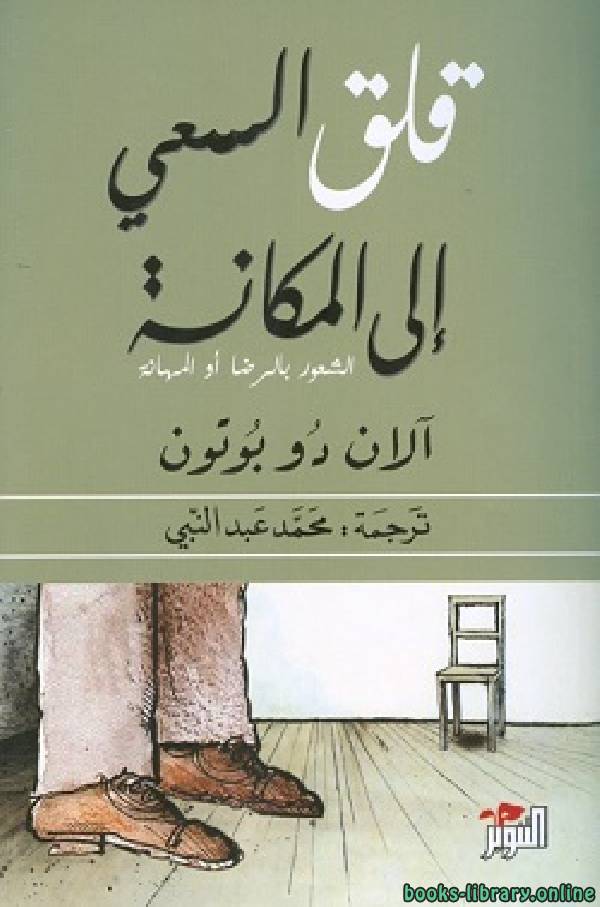 46
46
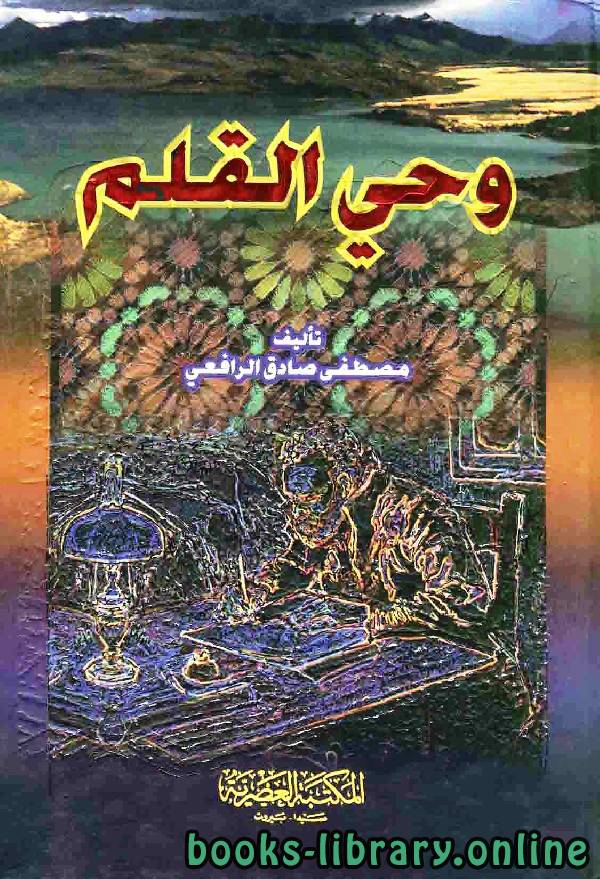 254
254
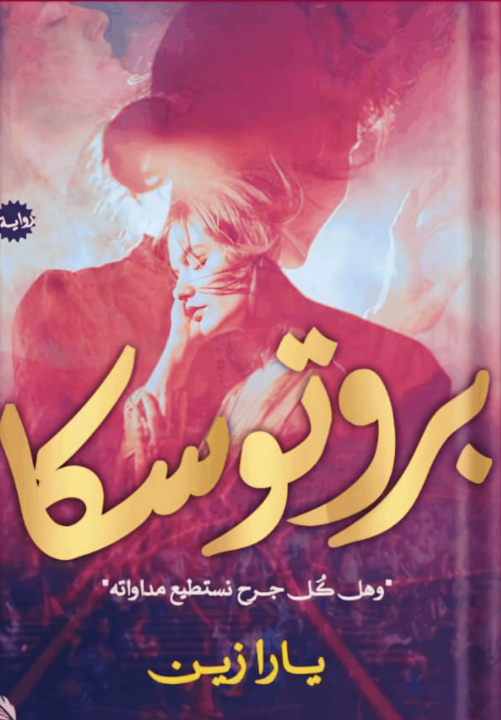 10
10
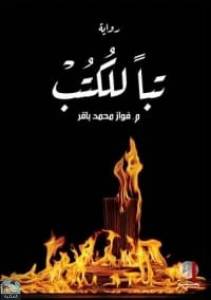 9
9
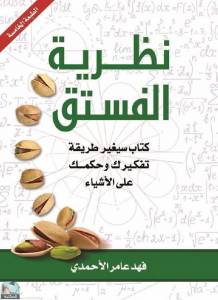 214
214
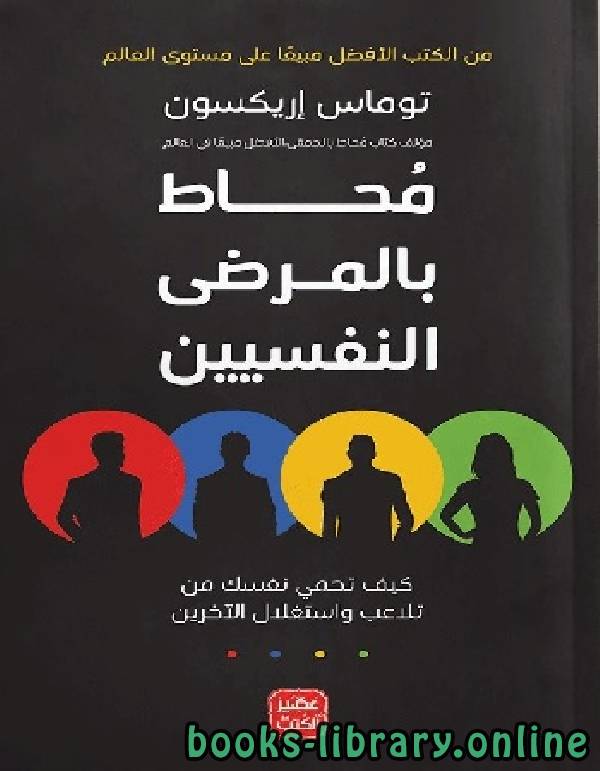 40
40
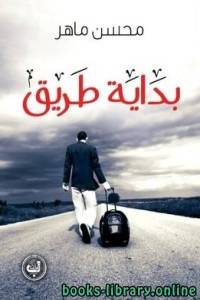 16
16
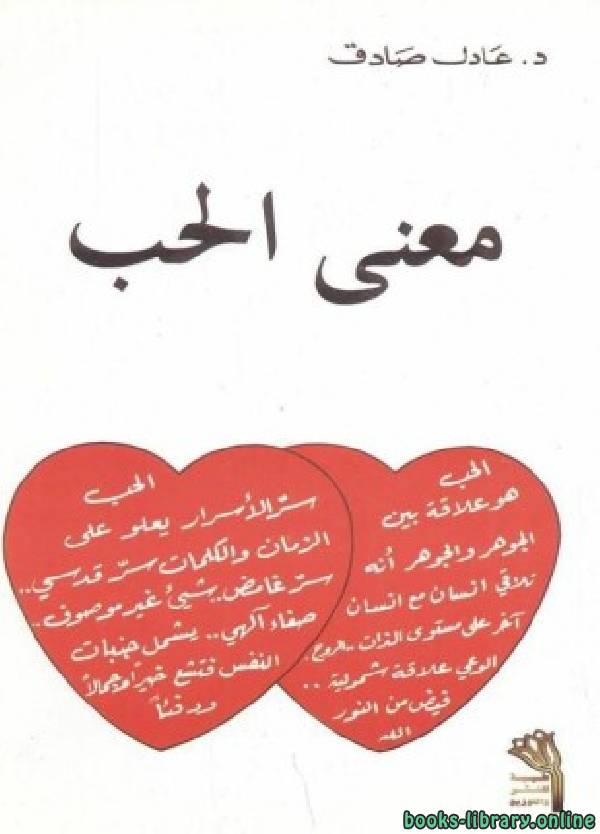 8
8
 3
3
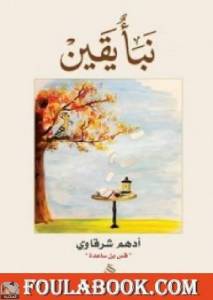 116
116