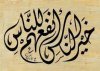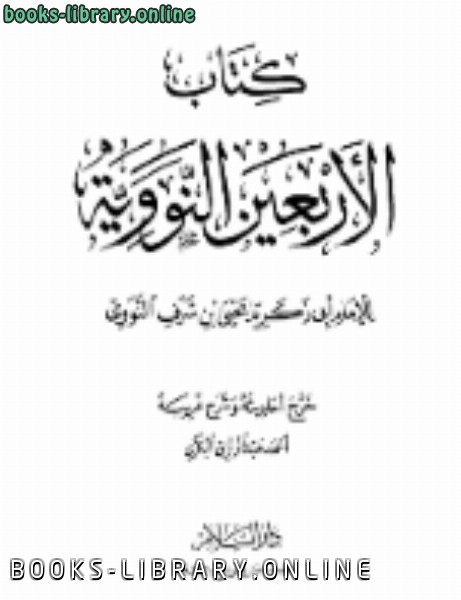❞ مقاصد ❝ 💬 اقتباسات من الكتب 📖
- مقاصد 💬 اقتباسات من الكتب 📖
█ حصريا تحميل كتاب مجاناً PDF اونلاين 2025
إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
اقتباسات في ❞مقاصد❝
-
❞ {1 رمضان - الحديث الأوَّل} عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: خيرُكم قرني ثم الذينَ يلونَهم ثمَّ الَّذينَ يلونهمْ، ثمَّ يخلفُ قومٌ تسبقُ شهاداتُهم أيمانَهم وأيمانُهم شهاداتَهم . وفي رواية: خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ مِن بَعْدِهِمْ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهادَتُهُمْ أيْمانَهُمْ، وأَيْمانُهُمْ شَهادَتَهُمْ . ********** الشرح ********** فقد فاضَلَ النَّبيُّ ﷺ بين المُسلِمين على أساسِ قُوَّةِ التدَيُّنِ وقوَّةِ الإيمانِ، كما فاضَلَ في أحاديثَ مُتعَدِّدةٍ بين أصحابِه رَضِيَ اللهُ عنهم وغيرِهم، وفي هذا الحديثُ بَيانٌ جَلِيٌّ لفَضلِ الصَّحابةِ رضِيَ اللهُ عنهم وفَضْلِ التَّابعين وتابِعيهم، وفيه يقولُ عبْدُ اللهِ بنُ مَسْعودٍ رضِيَ اللهُ عنه: «سُئِلَ النَّبيُّ ﷺ: أَيُّ النَّاسِ خيرٌ» مِن غَيْرِهمْ أو أفضلُ مِنهمْ؟ فقالَ النَّبيُّ ﷺ مُوضِّحًا أنَّ أفْضَلَ النَّاسِ هُم أهلُ زَمانِه ومَن عاصَرَ النُّبوَّةَ، وهمُ الصَّحابةُ رضِيَ اللهُ عنهم، والمرادُ بالقَرْنِ: أهلُ زَمانٍ واحدٍ، ثُمَّ القَرْنُ الذي يكونُ بعْدَ الصَّحابة، وهم التَّابِعون، ثُمَّ القَرْنُ الذي يَلي التَّابعين، وهمْ أتباعُ التَّابعين؛ فالصَّحابةُ همْ أفضلُ المسلمينَ؛ لأنَّهم عاصَروا النَّبيَّ ﷺ فقد وضَّح لهمْ أُمورَ الدِّينِ وأخَذُوه عنه مُباشرةً، فهمْ أفضلُ النَّاسِ عِلمًا بسُنَّةِ النَّبيِّ ﷺ ومَقاصدِ التَّشْريعِ، وعلى أَيديهمْ تمَّ نَشْرُ الدِّينِ في الفُتوحاتِ والغَزواتِ، ثمَّ أخَذَ التَّابِعونَ العِلمَ مِنهمْ وتابَعوا مَسيرةَ الجِهادِ، وهكذا كان أتباع التابعين على عهدهم، إلى أنْ تباعدَ الزَّمانُ عنْ زَمانِ النُّبوَّةِ، فابتعدوا عن الهَدْي والسُّنَّةِ وصَحيحِ الدِّينِ شَيئًا فَشيئًا. ثم يَأتي زَمانٌ وهو الجيل الرابع ومن بعدهم يَتهَاونُ فيه النَّاسُ في أمرِ الدِّينِ بعْدَ أنْ كانوا يَخافونَ مِن الشُّبُهاتِ، فتسبقُ شهادةُ أحدِهمْ يمينَه، ويَسبِقُ يمينُه شَهادتَه، وهذا كِنايةٌ عن كَثرةِ شَهادةِ الزُّورِ واليمينِ، فيَشْهَدونَ دُونَ أنْ تُطلَبَ منهمُ الشَّهادةُ؛ استِهْتارًا وليسَ منْ بابِ الحِرصِ على إيصالِ الحقوقِ لأصحابِها، وكذلكَ يُقسِمونَ بالأَيْمانِ مِثل الشَّهادةِ دونَ أنْ يُطلَبَ منهم الأَيْمانُ. ولكن يجب على الباحث أن يعلم أنَّ من بعد القرون الذهبية ليسوا سواء في الفضل فالجيل الرابع أحسن من الجيل الخامس والخامس أحسن من السادس وهكذا، وهذا لحديث الزبير بن عدي وفيه: أَتَيْنَا أنَسَ بنَ مَالِكٍ، فَشَكَوْنَا إلَيْهِ ما نَلْقَى مِنَ الحَجَّاجِ، فَقالَ: اصْبِرُوا؛ فإنَّه لا يَأْتي علَيْكُم زَمَانٌ إلَّا الذي بَعْدَهُ شَرٌّ منه، حتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ. سَمِعْتُهُ مِن نَبِيِّكُمْ ﷺ وحديث الباب يبدو مخالِفًا في الظَّاهِرِ للحديثِ الآخَرِ عند ابنِ ماجَهْ: «خَيْرُ الشُّهُودِ مَنْ أدَّى شهادَتَهُ قَبْلَ أنْ يُسأَلَها»، والجَمعُ بينهما إمَّا بأن يُحمَلَ الذَّمُّ على من بادر بالشَّهادةِ في حَقِّ من هو عالمٌ بها قبل أن يسألها صاحِبُها، ويكونُ المدحُ لمن كانت عنده شهادةٌ لأحَدٍ لا يَعلَمُ بها، فيُخبِرُه ليستشهِدَ به عند القاضي، أو يُحمَلَ الذَّمُّ على الشَّهادة الباطلة التي هي شهادة الزور. أمَّا المبادرةُ إلى الشَّهادةِ الصَّحيحةِ مِن أجْلِ إظهارِ الحَقِّ، وإعانةِ المظلومِ، ودَفْعِ الظُّلمِ عنه، فإنها عمَلٌ صالحٌ يُؤجَرُ ويثابُ عليه صاحِبُه، والأحاديثُ يُفَسِّرُ بَعْضُها بعضًا. وذَكَر إبراهيمُ النَّخعيُّ -راوي الحديثِ-: وكان أصحابُنا ينهَونَنا -وفي روايةٍ للبُخاري: «يَضرِبونَنا»- وهم صِغارٌ أن نحلِفَ بالشَّهادةِ والعَهدِ، يريد: أُشهِدُ اللهَ، وعلى عَهدِ اللهِ؛ لأنهما يمينانِ مُغَلَّظانِ، وهذا مما لا يستوجِبُ في حَقِّهما أن يكونا عُرضةً وعادةً للحالِفِ، ووجهُ النَّهيِ عنهما كما ذُكِرَ أن قَولَه: أشهَدُ باللهِ، يقتضي معنى العِلمِ بالقَطْعِ، وعَهدُ اللهِ لا يقدِرُ أحَدٌ على التزامِه بما يجِبُ فيه. وعلى العموم فَذَيْلُ الحديث ليس مراد كتابنا هذا، فمرادنا بيان فضل العصور الثلاثة، وأنَّ الراوي منهم بجماعة ممن بعده. وفي الحَديثِ: إشارةٌ إلى لُزومِ اتِّباعِ سَبيلِ القُرونِ الثَّلاثةِ الأُولى؛ فإنَّ مَن قَرُبَ زَمنُه مِن زَمنِ النُّبوَّةِ فهو أَوْلَى بالفضْلِ والعِلمِ والتَّأسِّي والاقتداءِ بهَدْيِ النَّبيِّ ﷺ. وفيه: أنَّ عدد من بعد العصري الذهبي ولو كثُر، لا يجعلهم يرتقون إلى مرتبة أصحاب العصور الذهبيَّة. وفيه: أنَّ فضل العصور الثلاثة لا يبلغه أحد، فهم معدَّول بتعديل رسول الله ﷺ، فهم على العدالة الأصلية حتَّى تأتي قرينة صريحة بينة واضحة لا وهمية ولا ظنية، تخرجهم من عدالتهم الأصلية إلى غير ذلك، وبه فالعدل من التابعين أو أتباعهم، هو بجماعة ممن هم بعدهم، ول علا شأنهم. وفيه: ذَمُّ التَّساهُل في أُمورِ الشَّهاداتِ والأَيْمانِ.. ❝ ⏤الدُّكتُور: عِصَامُ الدِّينِ إِبْرَاهِيمَ النُّقَيْلِي❞ ﴿1 رمضان - الحديث الأوَّل﴾
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: خيرُكم قرني ثم الذينَ يلونَهم ثمَّ الَّذينَ يلونهمْ، ثمَّ يخلفُ قومٌ تسبقُ شهاداتُهم أيمانَهم وأيمانُهم شهاداتَهم .
وفي رواية: خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ مِن بَعْدِهِمْ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهادَتُهُمْ أيْمانَهُمْ، وأَيْمانُهُمْ شَهادَتَهُمْ .فقد فاضَلَ النَّبيُّ ﷺ بين المُسلِمين على أساسِ قُوَّةِ التدَيُّنِ وقوَّةِ الإيمانِ، كما فاضَلَ في أحاديثَ مُتعَدِّدةٍ بين أصحابِه رَضِيَ اللهُ عنهم وغيرِهم، وفي هذا الحديثُ بَيانٌ جَلِيٌّ لفَضلِ الصَّحابةِ رضِيَ اللهُ عنهم وفَضْلِ التَّابعين وتابِعيهم، وفيه يقولُ عبْدُ اللهِ بنُ مَسْعودٍ رضِيَ اللهُ عنه: «سُئِلَ النَّبيُّ ﷺ: أَيُّ النَّاسِ خيرٌ» مِن غَيْرِهمْ أو أفضلُ مِنهمْ؟ فقالَ النَّبيُّ ﷺ مُوضِّحًا أنَّ أفْضَلَ النَّاسِ هُم أهلُ زَمانِه ومَن عاصَرَ النُّبوَّةَ، وهمُ الصَّحابةُ رضِيَ اللهُ عنهم، والمرادُ بالقَرْنِ: أهلُ زَمانٍ واحدٍ، ثُمَّ القَرْنُ الذي يكونُ بعْدَ الصَّحابة، وهم التَّابِعون، ثُمَّ القَرْنُ الذي يَلي التَّابعين، وهمْ أتباعُ التَّابعين؛ فالصَّحابةُ همْ أفضلُ المسلمينَ؛ لأنَّهم عاصَروا النَّبيَّ ﷺ فقد وضَّح لهمْ أُمورَ الدِّينِ وأخَذُوه عنه مُباشرةً، فهمْ أفضلُ النَّاسِ عِلمًا بسُنَّةِ النَّبيِّ ﷺ ومَقاصدِ التَّشْريعِ، وعلى أَيديهمْ تمَّ نَشْرُ الدِّينِ في الفُتوحاتِ والغَزواتِ، ثمَّ أخَذَ التَّابِعونَ العِلمَ مِنهمْ وتابَعوا مَسيرةَ الجِهادِ، وهكذا كان أتباع التابعين على عهدهم، إلى أنْ تباعدَ الزَّمانُ عنْ زَمانِ النُّبوَّةِ، فابتعدوا عن الهَدْي والسُّنَّةِ وصَحيحِ الدِّينِ شَيئًا فَشيئًا.** ******** الشرح **********
ثم يَأتي زَمانٌ وهو الجيل الرابع ومن بعدهم يَتهَاونُ فيه النَّاسُ في أمرِ الدِّينِ بعْدَ أنْ كانوا يَخافونَ مِن الشُّبُهاتِ، فتسبقُ شهادةُ أحدِهمْ يمينَه، ويَسبِقُ يمينُه شَهادتَه، وهذا كِنايةٌ عن كَثرةِ شَهادةِ الزُّورِ واليمينِ، فيَشْهَدونَ دُونَ أنْ تُطلَبَ منهمُ الشَّهادةُ؛ استِهْتارًا وليسَ منْ بابِ الحِرصِ على إيصالِ الحقوقِ لأصحابِها، وكذلكَ يُقسِمونَ بالأَيْمانِ مِثل الشَّهادةِ دونَ أنْ يُطلَبَ منهم الأَيْمانُ.
ولكن يجب على الباحث أن يعلم أنَّ من بعد القرون الذهبية ليسوا سواء في الفضل فالجيل الرابع أحسن من الجيل الخامس والخامس أحسن من السادس وهكذا، وهذا لحديث الزبير بن عدي وفيه: أَتَيْنَا أنَسَ بنَ مَالِكٍ، فَشَكَوْنَا إلَيْهِ ما نَلْقَى مِنَ الحَجَّاجِ، فَقالَ: اصْبِرُوا؛ فإنَّه لا يَأْتي علَيْكُم زَمَانٌ إلَّا الذي بَعْدَهُ شَرٌّ منه، حتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ. سَمِعْتُهُ مِن نَبِيِّكُمْ ﷺ
وحديث الباب يبدو مخالِفًا في الظَّاهِرِ للحديثِ الآخَرِ عند ابنِ ماجَهْ: «خَيْرُ الشُّهُودِ مَنْ أدَّى شهادَتَهُ قَبْلَ أنْ يُسأَلَها»، والجَمعُ بينهما إمَّا بأن يُحمَلَ الذَّمُّ على من بادر بالشَّهادةِ في حَقِّ من هو عالمٌ بها قبل أن يسألها صاحِبُها، ويكونُ المدحُ لمن كانت عنده شهادةٌ لأحَدٍ لا يَعلَمُ بها، فيُخبِرُه ليستشهِدَ به عند القاضي، أو يُحمَلَ الذَّمُّ على الشَّهادة الباطلة التي هي شهادة الزور.
أمَّا المبادرةُ إلى الشَّهادةِ الصَّحيحةِ مِن أجْلِ إظهارِ الحَقِّ، وإعانةِ المظلومِ، ودَفْعِ الظُّلمِ عنه، فإنها عمَلٌ صالحٌ يُؤجَرُ ويثابُ عليه صاحِبُه، والأحاديثُ يُفَسِّرُ بَعْضُها بعضًا.
وذَكَر إبراهيمُ النَّخعيُّ -راوي الحديثِ-: وكان أصحابُنا ينهَونَنا -وفي روايةٍ للبُخاري: «يَضرِبونَنا»- وهم صِغارٌ أن نحلِفَ بالشَّهادةِ والعَهدِ، يريد: أُشهِدُ اللهَ، وعلى عَهدِ اللهِ؛ لأنهما يمينانِ مُغَلَّظانِ، وهذا مما لا يستوجِبُ في حَقِّهما أن يكونا عُرضةً وعادةً للحالِفِ، ووجهُ النَّهيِ عنهما كما ذُكِرَ أن قَولَه: أشهَدُ باللهِ، يقتضي معنى العِلمِ بالقَطْعِ، وعَهدُ اللهِ لا يقدِرُ أحَدٌ على التزامِه بما يجِبُ فيه.
وعلى العموم فَذَيْلُ الحديث ليس مراد كتابنا هذا، فمرادنا بيان فضل العصور الثلاثة، وأنَّ الراوي منهم بجماعة ممن بعده.
وفي الحَديثِ: إشارةٌ إلى لُزومِ اتِّباعِ سَبيلِ القُرونِ الثَّلاثةِ الأُولى؛ فإنَّ مَن قَرُبَ زَمنُه مِن زَمنِ النُّبوَّةِ فهو أَوْلَى بالفضْلِ والعِلمِ والتَّأسِّي والاقتداءِ بهَدْيِ النَّبيِّ ﷺ.
وفيه: أنَّ عدد من بعد العصري الذهبي ولو كثُر، لا يجعلهم يرتقون إلى مرتبة أصحاب العصور الذهبيَّة.
وفيه: أنَّ فضل العصور الثلاثة لا يبلغه أحد، فهم معدَّول بتعديل رسول الله ﷺ، فهم على العدالة الأصلية حتَّى تأتي قرينة صريحة بينة واضحة لا وهمية ولا ظنية، تخرجهم من عدالتهم الأصلية إلى غير ذلك، وبه فالعدل من التابعين أو أتباعهم، هو بجماعة ممن هم بعدهم، ول علا شأنهم.
وفيه: ذَمُّ التَّساهُل في أُمورِ الشَّهاداتِ والأَيْمانِ. ❝
⏤ الدُّكتُور: عِصَامُ الدِّينِ إِبْرَاهِيمَ النُّقَيْلِي -
❞ {مقدمة سلسلة أحاديث رمضان} لله حمدي وإليه أسند * وما ينوب فعليه أعتمد ثمَّ على نبيِّه محمــــــــدِ * خير صلاة وسلام سرمدِ وبعد: فقد يظن البعض أن علم الحديث علم خاص بسرد الأحاديث وسماعها وحسب، والصحيح؛ أنَّ علم الحديث هو علم شامل، فيشمل كل العلوم الأخرى، فهو يشمل علم العقيدة، وعلم التفسير، وعلم الفقه، وعلم القواعد الفقهية، وعلم أصول الفقه، والقواعد أصول الفقه، وعلم البلاغة، واللغة وغيرها... وكل هذا لأنَّ علم الحديث هو الأصل لكل العلوم، سواء أكانت أصلية أم فرعية (آلات العلوم الأصلية) والأصلية هي الفقه والتفسير والحديث، وحتى العلوم الأصلية فإنَّ علم الحديث هو المهيمن عليها، فكل من الفقه والتفسير مع أنهما أصليَّان إلَّا إنهما مُستخرجان من علم الحديث، فالتفسير إن لم يكن من تفسير رسول الله ﷺ أو ما علمَّه لأصحابه فلا خير فيه، إلا إن لم يكن في الآية حديث، فبقول الصحابة فيها، وقول الصحابة ليس بدعة بل هو مما تعلموه من رسول الله ﷺ؛ فإن لم يكن في قول الصحابة شيء فبقول التابعين وأتباعهم، وأقوال هؤلاء ليس ببدعة بل هو مما تعلموه من الصحابة والصحابة بدورهم تعلموه من النبي ﷺ، فإن لم يوجد شيء ممَّل سبق نستعمل قواعد التفسير، وقواعد التفسير وأصوله هما بذاتهما تمَّ استنباطهما من حديث رسول الله، فأصل أصول التفسير أن تفسر القرآن بالقرآن، وهذا تعلمناه من الحديث، من ذلك تفسير النبي ﷺ لقوله تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ}[الأنعام: 82]، فشق ذلِكَ علَى المسلِمينَ فقَالوا: يا رسولَ اللَّهِ وأيُّنا لا يظلِمُ نفسَهُ؟ قالَ: ليسَ ذلِكَ، إنَّما هوَ الشِّركُ ألَم تسمَعوا ما قالَ لقمانُ لابنِهِ: {يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}[لقمان: 13] . وأمَّا الفقه فكلُّه مستخرج من علم الحديث، وهذا معلوم مشهور مأثور، فإن كانت أصول العلوم كذلك ففروعه من باب أولى، سيقول القائل إنَّ القواعد الفقهية وأصول الفقه هي استنباطية جائت من عقول العلماء، نقول: أنَّ العلماء استنبطوها من حديث رسول الله ﷺ، فمثلا قاعدة: الأمور بمقاصدها، التي عبَّر عنها ابن سند المالكي في منظومته منظومة القواعد الفقهية قال: إنَّ الأمور هنَّ بالمقاصد * ................. فهذا مستنبط من قول النبي ﷺ: إنَّما الأعمال بالنيَّات... . وهكذا إلى سائر العلوم الشرعية فكلها مستنبطة من علم الحديث، ومن جملة هذه العلوم علوم العقيدة، فأصل أصول علم العقيدة هو حديث جبريل ﷺ، وفيه كل أبواب أصول العقيدة ، فقد جمع النبي ﷺ في حديث واحد كل مباني العقيدة. والعقيدة عند أهل السنة لا تستحكم من قلب المسلم إلا بثلاثة أعمال: 1 – أعمال القلب. 2 – وأعمال اللسان. 3 – وأعمال الجوارح. ومرادها هو أن تعتقد بأن ˝لا إله إلا الله˝ بقلبك، وتنطق بها بلسانك، وتعمل بها جوارحك. وهذه المباني الثلاثة لا تتمُّ إلا ببعضها فهي كالعقد الدريُّ المنظوم، إن سللت درة منه تساقطت البقية، ومع هذا فهي ليست متساوية في القوَّة، فأعلاها قوَّة هي أعمال القلوب، وقد بيَّن النبي ﷺ ذلك بقوله: ألا وإنَّ في الجَسَدِ مُضْغَةً، إذا صَلَحَتْ، صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وإذا فَسَدَتْ، فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، ألا وهي القَلْبُ . فالقلب وأعماله هو المهين على سائر الأعمال سواء أعمال الجوارح أو اللسان، وهذا لا يعني أنَّ ترك أعمال الجوارح واللسان جائز، هذا لا يجوز أبدا، فكل الثلاثة يكملون بعضهم، ولكنَّ مرادنا بيان أنَّ أعمال القلب أعلاها. وعمل القلب هو التوحيد، والتوحيد أصل تندرج تحته كل أعمال القلب، كالولاء والبراء، والبغض والمحبة، وغيرها من أعمال القلب، وأعلى فرع من فروع التوحيد هو المحبَّة، فعلى قدر حب المسلم لربِّه ولنبيِّه ولصحب نبيه يكون قربه لله تعالى، وعلى قدر بغضه للكفر والكفار يكون قربه من الله تعالى، والعكس بالعكس. وهذا الحب ليس متعلق بالله وحده، بل يشمل نبيه ثمَّ سائر أنبيائه، ثمَّ صحب نبيه وصحب سائر أنبيائه، ثمَّ تابعيهم وتابعي سائر أنبيائهم، ثمَّ أتباعهم وأتباع سائر أنبيائهم، ولكن حبُّ الله تعالى هو الأعلى من بين ما سبق، لأنه الأصل وحب هؤلاء ما كان إلا بحب الله تعالى، وهذه المحبَّة هي بدورها كالدر المنظوم، إن سللت درة تساقطت بقية الدرر، فلا يدعي أحدا أنه يحب الله تعالى وهو يبغض أحد أنبيائه أو أحد ملائكته، فقد قال تعالى: {مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ * مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ}[البقرة: 97 – 98]، لاحظ معي أنه سبحانه قال في الآية الأولى {مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ}ثمَّ بيَّن لك أنَّ عداوة جبريل الملك الرسول هي عداوة لله تعالى، وزاد وبيَّن أنَّ الضرر المنجر إليك ببغضك لجبريل ليس خاصا بجبريل وحسب، بل بيَّن في الآية الثانية أنه شامل لكل أهل الله تعالى، وعطف جبريل وميكال عطف الخاص على العام لبيان فضلهما فقال: {مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} ثمَّ بيَّن حكم من يبغض أهل الله تعالى وقال: {فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ}، هذه الآيات المباركات، هي درر أصول وفروع عقيدة المسلم، التي لم ينتبه إليها كثير من العامة، بحيث يبغض البعض منهم اللحية أو الأقمصة أو الأبيض من اللباس أو التقصير في الثياب، فكل ما ذكرته يعود لتك الآيات المباركات، فما اللحية والقميص والبياض والتقصير وغيره إلا سنن من سنن المصطفى ﷺ، فمن كان يبغض هذا فقد أبغض شيأ من سنن المصطفى ﷺ ومن أبغض شيأ من سنن المصطفى ﷺ فقد أبغض المصطفى ﷺ، ومن أبغض المصطفى أبغض الله تعالى، ومن أبغض الله تعالى، يوشك الله أن يأخذه. وعكس هذا يكون له نقيضه، فمن أحب سنن المصطفى فقد أحب المصطفى، ومن أحب المصطفى فقد أحب الله، ومن أحب الله تعالى، يوشك الله أن يدخله جنته، واسمع لهذا الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه حيث قال: أنَّ رَجُلًا سَأَلَ النبيَّ ﷺ عَنِ السَّاعَةِ، فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: ومَاذَا أعْدَدْتَ لَهَا. قَالَ: لا شيءَ، إلَّا أنِّي أُحِبُّ اللَّهَ ورَسوله ﷺ، فَقَالَ: أنْتَ مع مَن أحْبَبْتَ. قَالَ أنَسٌ: فَما فَرِحْنَا بشيءٍ، فَرَحَنَا بقَوْلِ النبيِّ ﷺ: أنْتَ مع مَن أحْبَبْتَ، قَالَ أنَسٌ: فأنَا أُحِبُّ النبيَّ ﷺ وأَبَا بَكْرٍ، وعُمَرَ، وأَرْجُو أنْ أكُونَ معهُمْ بحُبِّي إيَّاهُمْ، وإنْ لَمْ أعْمَلْ بمِثْلِ أعْمَالِهِمْ . والآن لاحظ معي؛ إن كان هذا الأمر في شيء من السنن، فما بالك من أمر الله ورسوله ﷺ بحبهم، بل وحثَّ على توقيرهم واتباعهم ونصرتهم، بل وأمر بالاقتداء بهم، وهم أصحاب رسول الله ﷺ وأتباعهم وأتباع أتباعهم، الذين قال الله تعالى فيهم: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}[التوبة: 100]. وقال: {مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا}[الفتح: 29]. وهاهو عبد الله ابن مسعود يبيِّن فضل هؤلاء وهو منهم حيث قال: مَن كانَ مُستنًّا؛ فليستَنَّ بمَن قَد ماتَ فإنَّ الحيَّ لا تُؤمَنُ علَيهِ الفِتنةُ أولئِكَ أصحابُ محمَّدٍ ﷺ كانوا أفضلَ هذِهِ الأمَّةِ أبرَّها قلوبًا وأعمقَها عِلمًا وأقلَّها تَكَلُّفًا اختارَهُمُ اللَّهُ لِصُحبةِ نبيِّهِ ولإقامةِ دينِهِ فاعرِفوا لَهُم فضلَهُم واتَّبعوا علَى آثارِهِم وتمسَّكوا بما استطعتُمْ مِن أخلاقِهِم وسِيَرِهِم ، فإنَّهم كانوا علَى الهُدى المستقيمِ . فهؤلاء حبُّهم عقيدة المسلم، وبغضهم علامة المنافة، فمن أحبهم فهو معهم وإن لم يعمل بأعمالهم، ومن أبغضهم فلقد أبغض رسول الله ﷺ، ومن أبغض رسول الله ﷺ فقد أبغض الله تعالى. ومن أحبهم فقد أحب رسول الله ﷺ، ومن أحب رسول الله ﷺ فقد أحب الله تعالى. ونحن نريد أن نجدد إيماننا، ونحيي قلوبنا، في هذا الشهر المبارك، ونعطي لكل ذي حقٍّ حقَّه، وننزل الناس منازلها، ونعطي لكل ذي قدر قدره، كي تكون عبادتنا خالصة تامَّة ما استطعنا، وذلك بسرد أحاديث مشروحة عن فضل خير العصور الثلاثة، وهم عصر الصحابة، وعصر التابعين، وعصر أتباع التابعين، بصفة كل يوم حديث أو حديثين مع الشرح، فلا يظننَّ أحد أنَّ الخير كان خاصًّا بالصحابة وحسب، بل وأتباعهم وأتباع أتباعهم، وسنرى ذلك في هذه السلسلة المباركة، وقد قدَّمت أحاديث تبيِّن فضل التابعين تُذكر في جملة فضل الصحابة، ثمَّ أحاديث خاصَّة بجملة الصحابة، ثمَّ نختم بأحاديث في خواص الصحابة، وقد ركزَّت كثيرا فيها على فضل التابعين، لأنَّ الحال يقتضي ذلك، هذا ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه السلسلة مباركة وذات فائدة وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. وكتب: الدكتور عصام الدين إبراهيم النقيلي. ❝ ⏤الدُّكتُور: عِصَامُ الدِّينِ إِبْرَاهِيمَ النُّقَيْلِي❞ ﴿مقدمة سلسلة أحاديث رمضان﴾
لله حمدي وإليه أسند * وما ينوب فعليه أعتمد
ثمَّ على نبيِّه محمــــــــدِ * خير صلاة وسلام سرمدِ
وبعد: فقد يظن البعض أن علم الحديث علم خاص بسرد الأحاديث وسماعها وحسب، والصحيح؛ أنَّ علم الحديث هو علم شامل، فيشمل كل العلوم الأخرى، فهو يشمل علم العقيدة، وعلم التفسير، وعلم الفقه، وعلم القواعد الفقهية، وعلم أصول الفقه، والقواعد أصول الفقه، وعلم البلاغة، واللغة وغيرها..
وكل هذا لأنَّ علم الحديث هو الأصل لكل العلوم، سواء أكانت أصلية أم فرعية (آلات العلوم الأصلية) والأصلية هي الفقه والتفسير والحديث، وحتى العلوم الأصلية فإنَّ علم الحديث هو المهيمن عليها، فكل من الفقه والتفسير مع أنهما أصليَّان إلَّا إنهما مُستخرجان من علم الحديث، فالتفسير إن لم يكن من تفسير رسول الله ﷺ أو ما علمَّه لأصحابه فلا خير فيه، إلا إن لم يكن في الآية حديث، فبقول الصحابة فيها، وقول الصحابة ليس بدعة بل هو مما تعلموه من رسول الله ﷺ؛ فإن لم يكن في قول الصحابة شيء فبقول التابعين وأتباعهم، وأقوال هؤلاء ليس ببدعة بل هو مما تعلموه من الصحابة والصحابة بدورهم تعلموه من النبي ﷺ، فإن لم يوجد شيء ممَّل سبق نستعمل قواعد التفسير، وقواعد التفسير وأصوله هما بذاتهما تمَّ استنباطهما من حديث رسول الله، فأصل أصول التفسير أن تفسر القرآن بالقرآن، وهذا تعلمناه من الحديث، من ذلك تفسير النبي ﷺ لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾[الأنعام: 82]، فشق ذلِكَ علَى المسلِمينَ فقَالوا: يا رسولَ اللَّهِ وأيُّنا لا يظلِمُ نفسَهُ؟ قالَ: ليسَ ذلِكَ، إنَّما هوَ الشِّركُ ألَم تسمَعوا ما قالَ لقمانُ لابنِهِ: ﴿يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾[لقمان: 13] .
وأمَّا الفقه فكلُّه مستخرج من علم الحديث، وهذا معلوم مشهور مأثور، فإن كانت أصول العلوم كذلك ففروعه من باب أولى، سيقول القائل إنَّ القواعد الفقهية وأصول الفقه هي استنباطية جائت من عقول العلماء، نقول: أنَّ العلماء استنبطوها من حديث رسول الله ﷺ، فمثلا قاعدة: الأمور بمقاصدها، التي عبَّر عنها ابن سند المالكي في منظومته منظومة القواعد الفقهية قال: إنَّ الأمور هنَّ بالمقاصد * .........
فهذا مستنبط من قول النبي ﷺ: إنَّما الأعمال بالنيَّات.. .
وهكذا إلى سائر العلوم الشرعية فكلها مستنبطة من علم الحديث، ومن جملة هذه العلوم علوم العقيدة، فأصل أصول علم العقيدة هو حديث جبريل ﷺ، وفيه كل أبواب أصول العقيدة ، فقد جمع النبي ﷺ في حديث واحد كل مباني العقيدة.
والعقيدة عند أهل السنة لا تستحكم من قلب المسلم إلا بثلاثة أعمال:
1 – أعمال القلب.
2 – وأعمال اللسان.
3 – وأعمال الجوارح.
ومرادها هو أن تعتقد بأن ˝لا إله إلا الله˝ بقلبك، وتنطق بها بلسانك، وتعمل بها جوارحك.
وهذه المباني الثلاثة لا تتمُّ إلا ببعضها فهي كالعقد الدريُّ المنظوم، إن سللت درة منه تساقطت البقية، ومع هذا فهي ليست متساوية في القوَّة، فأعلاها قوَّة هي أعمال القلوب، وقد بيَّن النبي ﷺ ذلك بقوله: ألا وإنَّ في الجَسَدِ مُضْغَةً، إذا صَلَحَتْ، صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وإذا فَسَدَتْ، فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، ألا وهي القَلْبُ .
فالقلب وأعماله هو المهين على سائر الأعمال سواء أعمال الجوارح أو اللسان، وهذا لا يعني أنَّ ترك أعمال الجوارح واللسان جائز، هذا لا يجوز أبدا، فكل الثلاثة يكملون بعضهم، ولكنَّ مرادنا بيان أنَّ أعمال القلب أعلاها.
وعمل القلب هو التوحيد، والتوحيد أصل تندرج تحته كل أعمال القلب، كالولاء والبراء، والبغض والمحبة، وغيرها من أعمال القلب، وأعلى فرع من فروع التوحيد هو المحبَّة، فعلى قدر حب المسلم لربِّه ولنبيِّه ولصحب نبيه يكون قربه لله تعالى، وعلى قدر بغضه للكفر والكفار يكون قربه من الله تعالى، والعكس بالعكس.
وهذا الحب ليس متعلق بالله وحده، بل يشمل نبيه ثمَّ سائر أنبيائه، ثمَّ صحب نبيه وصحب سائر أنبيائه، ثمَّ تابعيهم وتابعي سائر أنبيائهم، ثمَّ أتباعهم وأتباع سائر أنبيائهم، ولكن حبُّ الله تعالى هو الأعلى من بين ما سبق، لأنه الأصل وحب هؤلاء ما كان إلا بحب الله تعالى، وهذه المحبَّة هي بدورها كالدر المنظوم، إن سللت درة تساقطت بقية الدرر، فلا يدعي أحدا أنه يحب الله تعالى وهو يبغض أحد أنبيائه أو أحد ملائكته، فقد قال تعالى: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ * مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ﴾[البقرة: 97 – 98]، لاحظ معي أنه سبحانه قال في الآية الأولى ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ﴾ثمَّ بيَّن لك أنَّ عداوة جبريل الملك الرسول هي عداوة لله تعالى، وزاد وبيَّن أنَّ الضرر المنجر إليك ببغضك لجبريل ليس خاصا بجبريل وحسب، بل بيَّن في الآية الثانية أنه شامل لكل أهل الله تعالى، وعطف جبريل وميكال عطف الخاص على العام لبيان فضلهما فقال: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ ثمَّ بيَّن حكم من يبغض أهل الله تعالى وقال: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ﴾، هذه الآيات المباركات، هي درر أصول وفروع عقيدة المسلم، التي لم ينتبه إليها كثير من العامة، بحيث يبغض البعض منهم اللحية أو الأقمصة أو الأبيض من اللباس أو التقصير في الثياب، فكل ما ذكرته يعود لتك الآيات المباركات، فما اللحية والقميص والبياض والتقصير وغيره إلا سنن من سنن المصطفى ﷺ، فمن كان يبغض هذا فقد أبغض شيأ من سنن المصطفى ﷺ ومن أبغض شيأ من سنن المصطفى ﷺ فقد أبغض المصطفى ﷺ، ومن أبغض المصطفى أبغض الله تعالى، ومن أبغض الله تعالى، يوشك الله أن يأخذه.
وعكس هذا يكون له نقيضه، فمن أحب سنن المصطفى فقد أحب المصطفى، ومن أحب المصطفى فقد أحب الله، ومن أحب الله تعالى، يوشك الله أن يدخله جنته، واسمع لهذا الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه حيث قال: أنَّ رَجُلًا سَأَلَ النبيَّ ﷺ عَنِ السَّاعَةِ، فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: ومَاذَا أعْدَدْتَ لَهَا. قَالَ: لا شيءَ، إلَّا أنِّي أُحِبُّ اللَّهَ ورَسوله ﷺ، فَقَالَ: أنْتَ مع مَن أحْبَبْتَ. قَالَ أنَسٌ: فَما فَرِحْنَا بشيءٍ، فَرَحَنَا بقَوْلِ النبيِّ ﷺ: أنْتَ مع مَن أحْبَبْتَ، قَالَ أنَسٌ: فأنَا أُحِبُّ النبيَّ ﷺ وأَبَا بَكْرٍ، وعُمَرَ، وأَرْجُو أنْ أكُونَ معهُمْ بحُبِّي إيَّاهُمْ، وإنْ لَمْ أعْمَلْ بمِثْلِ أعْمَالِهِمْ .
والآن لاحظ معي؛ إن كان هذا الأمر في شيء من السنن، فما بالك من أمر الله ورسوله ﷺ بحبهم، بل وحثَّ على توقيرهم واتباعهم ونصرتهم، بل وأمر بالاقتداء بهم، وهم أصحاب رسول الله ﷺ وأتباعهم وأتباع أتباعهم، الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾[التوبة: 100].
وقال: ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾[الفتح: 29].
وهاهو عبد الله ابن مسعود يبيِّن فضل هؤلاء وهو منهم حيث قال: مَن كانَ مُستنًّا؛ فليستَنَّ بمَن قَد ماتَ فإنَّ الحيَّ لا تُؤمَنُ علَيهِ الفِتنةُ أولئِكَ أصحابُ محمَّدٍ ﷺ كانوا أفضلَ هذِهِ الأمَّةِ أبرَّها قلوبًا وأعمقَها عِلمًا وأقلَّها تَكَلُّفًا اختارَهُمُ اللَّهُ لِصُحبةِ نبيِّهِ ولإقامةِ دينِهِ فاعرِفوا لَهُم فضلَهُم واتَّبعوا علَى آثارِهِم وتمسَّكوا بما استطعتُمْ مِن أخلاقِهِم وسِيَرِهِم ، فإنَّهم كانوا علَى الهُدى المستقيمِ .
فهؤلاء حبُّهم عقيدة المسلم، وبغضهم علامة المنافة، فمن أحبهم فهو معهم وإن لم يعمل بأعمالهم، ومن أبغضهم فلقد أبغض رسول الله ﷺ، ومن أبغض رسول الله ﷺ فقد أبغض الله تعالى.
ومن أحبهم فقد أحب رسول الله ﷺ، ومن أحب رسول الله ﷺ فقد أحب الله تعالى.
ونحن نريد أن نجدد إيماننا، ونحيي قلوبنا، في هذا الشهر المبارك، ونعطي لكل ذي حقٍّ حقَّه، وننزل الناس منازلها، ونعطي لكل ذي قدر قدره، كي تكون عبادتنا خالصة تامَّة ما استطعنا، وذلك بسرد أحاديث مشروحة عن فضل خير العصور الثلاثة، وهم عصر الصحابة، وعصر التابعين، وعصر أتباع التابعين، بصفة كل يوم حديث أو حديثين مع الشرح، فلا يظننَّ أحد أنَّ الخير كان خاصًّا بالصحابة وحسب، بل وأتباعهم وأتباع أتباعهم، وسنرى ذلك في هذه السلسلة المباركة، وقد قدَّمت أحاديث تبيِّن فضل التابعين تُذكر في جملة فضل الصحابة، ثمَّ أحاديث خاصَّة بجملة الصحابة، ثمَّ نختم بأحاديث في خواص الصحابة، وقد ركزَّت كثيرا فيها على فضل التابعين، لأنَّ الحال يقتضي ذلك، هذا ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه السلسلة مباركة وذات فائدة وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم.
وكتب:
الدكتور عصام الدين إبراهيم النقيلي. ❝
⏤ الدُّكتُور: عِصَامُ الدِّينِ إِبْرَاهِيمَ النُّقَيْلِي -
❞ أما هو فقد فرق بين \"التاريخ\" و \"العلم\"، إذ رأى أن في التاريخ مقاصد، وأهواء.. وأن كتابته - بل ومساراته نفسها - قد تعرضت لضغوط منها ما هو ذاتي -بحكم الارتهان إل فكرة أو عقيدة- ومنها ما هو خارجي - بحكم عوامل الواقع والقوى المؤثرة فيه.. ❝ ⏤ماجد صالح السامرائي❞ أما هو فقد فرق بين ˝التاريخ˝ و ˝العلم˝، إذ رأى أن في التاريخ مقاصد، وأهواء. وأن كتابته - بل ومساراته نفسها - قد تعرضت لضغوط منها ما هو ذاتي -بحكم الارتهان إل فكرة أو عقيدة- ومنها ما هو خارجي - بحكم عوامل الواقع والقوى المؤثرة فيه. ❝
⏤ ماجد صالح السامرائي -
❞ الأربعون في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المعروفة بـ الأربعون النووية، متن اشتمل على اثنين وأربعين حديثاّ جمعها يحيى بن شرف النووي المتوفى 676 هـ. تعريف الأربعون النووية هي مؤلف يحتوي على أربعين حديثاً نبويا شريفا، جمعها: الإمام النووي الذي التزم في جمعها أن تكون صحيحة، وعلل النووي سبب جمعه للأربعين فقال: «من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة، رضي الله عن قاصديها. وقد رايت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي اربعون حديثاً مشتملةً على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفه العلماء بأنه مدار الإسلام عليه، أو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك.» ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، وحذف أسانيدها ليسهل حفظها، ثم أتبعها بباب في ضبط خفيّ ألفاظها. فرغ المؤلف من تأليفها ليلة الخميس 29 جمادى الأول سنة 668 هـ. وقال النووي في مقدمة كتابه عن هذا الحديث ومدى اعتماده عليه في جمع الأربعين النووية: "وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله -صلى الله عليه وسلم- في الأحاديث الصحيحة: "ليبلغ الشاهد منكم الغائب"، وقوله: "نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فأداها كما سمعها". وقد علق الأستاذ ماهر الهندي على قول النووي، بأن الأعتماد على الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال هو قول الجمهور وليس متفقًا عليه. سبب التسمية الأربعون حديثا الأربعينات التي ظهرت استنادا على حديث ضعيف يقول «مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا مِنْ أَمْرِ دِينِهَا بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي زُمْرَةِ الْفُقَهَاءِ وَالْعُلَمَاءِ». شروح الأربعين هذا ثبت للعلماء الذين شرحوا الأربعين استنادا على كتاب «الدليل إلى المتون العلمية» لابن قاسم، مرتبة حسب تاريخ وفاة الشارح:. ❝ ⏤أبو زكريا يحي بن شرف النووي❞ الأربعون في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المعروفة بـ الأربعون النووية، متن اشتمل على اثنين وأربعين حديثاّ جمعها يحيى بن شرف النووي المتوفى 676 هـ.
تعريف
الأربعون النووية هي مؤلف يحتوي على أربعين حديثاً نبويا شريفا، جمعها: الإمام النووي الذي التزم في جمعها أن تكون صحيحة، وعلل النووي سبب جمعه للأربعين فقال:
«من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة، رضي الله عن قاصديها. وقد رايت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي اربعون حديثاً مشتملةً على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفه العلماء بأنه مدار الإسلام عليه، أو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك.»
ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، وحذف أسانيدها ليسهل حفظها، ثم أتبعها بباب في ضبط خفيّ ألفاظها. فرغ المؤلف من تأليفها ليلة الخميس 29 جمادى الأول سنة 668 هـ.
وقال النووي في مقدمة كتابه عن هذا الحديث ومدى اعتماده عليه في جمع الأربعين النووية: ˝وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله -صلى الله عليه وسلم- في الأحاديث الصحيحة: ˝ليبلغ الشاهد منكم الغائب˝، وقوله: ˝نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فأداها كما سمعها˝. وقد علق الأستاذ ماهر الهندي على قول النووي، بأن الأعتماد على الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال هو قول الجمهور وليس متفقًا عليه.
سبب التسمية
الأربعون حديثا الأربعينات التي ظهرت استنادا على حديث ضعيف يقول «مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا مِنْ أَمْرِ دِينِهَا بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي زُمْرَةِ الْفُقَهَاءِ وَالْعُلَمَاءِ».
شروح الأربعين
هذا ثبت للعلماء الذين شرحوا الأربعين استنادا على كتاب «الدليل إلى المتون العلمية» لابن قاسم، مرتبة حسب تاريخ وفاة الشارح:. ❝
⏤ أبو زكريا يحي بن شرف النووي -
❞ ظاهرة التلفظ بالطلاق – المُـفجعة – قد أضرت بالمجتمع حديثًا وذلك لاستنادها إلى أمور هزلية تدعو للتلفظ بألفاظ الطلاق وكأنها لعبة في أيدي هؤلاء الرجال الذين لا يقدِّرون عاقبة ما تتفوه به ألسنتهم، كونهم رجالًا مؤاخذين بما ينطقون! ومن هنا حاول الفقهاء والكثير من المصلحين إيجاد طريقة للحد من هذه الظاهرة التي تتسم بالصبيانية وعدم الرشد. كثيرًا ما تسبب «التلفظ بالطلاق» في هدم الأُسر وتفتيت الوحدة الاجتماعية. ومع أن الطلاق في الأصل مسؤولية فردية شرعية إلا أن تحقيقه – شكليًّا – في الدولة بين الزوجين ينبغي أن يُراعى فيه عرف الدولة وحال المجتمع. هل هناك ما يمنع الطلاق على هذه الصورة شرعيًّا وفقهيًا؟ لقد قرر الشرع أن الطلاق مسئولية فردية، وهو عمل شرعي تترتب عليه حقوق. فإذا نُظِّم هذا العمل بقانون منضبط يُراعي الحقوق والمقاصد العامة للاستقرار، كان ذلك أحرى أن يكون اتباعًا للشرع حفاظًا على الوحدة والاستقرار. فلا يوجد عائق شرعي لتنظيم الطلاق على هذا الشكل في المجتمع؛ بل إن الضرورة الاجتماعية والمقاصد الكلية للدين يحثان على تنظيم وتقنين مثل هذه الأمور. إننا لا نتزندق حينما نؤيد الأستاذ الإمام محمد عبده فيما ذهب إليه، ولا نضرب بديننا ومذاهبنا عرض الحائط، ولا نخفض من قيمة الآراء الفقهية السالفة... ولكننا بإجمال نجتهد وفق المصالح العامة للناس والأُسرة؛ فهذا من مقاصد ديننا وهدف إسلامنا السمح. فالأولاد لا ذنب لهم في أن تضيع حقوقهم في المجتمع الذي أصبح لا يتعامل إلا بالمواثيق الورقية؛ وقد كانت المواثيق قبلُ عــرفية شفوية بالكلمة لأن الناس قديمًا تغلب عليهم الوفاء وصدق العهد والمعاهدة.. أما اليوم فقد انقلب الحال لغير الحال حتى أصبح المخالف زنديقًا مبتدعًا مُجرمًا في نظر الغلاة!. ❝ ⏤محمد أحمد عبيد❞ ظاهرة التلفظ بالطلاق – المُـفجعة – قد أضرت بالمجتمع حديثًا وذلك لاستنادها إلى أمور هزلية تدعو للتلفظ بألفاظ الطلاق وكأنها لعبة في أيدي هؤلاء الرجال الذين لا يقدِّرون عاقبة ما تتفوه به ألسنتهم، كونهم رجالًا مؤاخذين بما ينطقون!
ومن هنا حاول الفقهاء والكثير من المصلحين إيجاد طريقة للحد من هذه الظاهرة التي تتسم بالصبيانية وعدم الرشد.
كثيرًا ما تسبب «التلفظ بالطلاق» في هدم الأُسر وتفتيت الوحدة الاجتماعية. ومع أن الطلاق في الأصل مسؤولية فردية شرعية إلا أن تحقيقه – شكليًّا – في الدولة بين الزوجين ينبغي أن يُراعى فيه عرف الدولة وحال المجتمع.
هل هناك ما يمنع الطلاق على هذه الصورة شرعيًّا وفقهيًا؟
لقد قرر الشرع أن الطلاق مسئولية فردية، وهو عمل شرعي تترتب عليه حقوق. فإذا نُظِّم هذا العمل بقانون منضبط يُراعي الحقوق والمقاصد العامة للاستقرار، كان ذلك أحرى أن يكون اتباعًا للشرع حفاظًا على الوحدة والاستقرار. فلا يوجد عائق شرعي لتنظيم الطلاق على هذا الشكل في المجتمع؛ بل إن الضرورة الاجتماعية والمقاصد الكلية للدين يحثان على تنظيم وتقنين مثل هذه الأمور.
إننا لا نتزندق حينما نؤيد الأستاذ الإمام محمد عبده فيما ذهب إليه، ولا نضرب بديننا ومذاهبنا عرض الحائط، ولا نخفض من قيمة الآراء الفقهية السالفة.. ولكننا بإجمال نجتهد وفق المصالح العامة للناس والأُسرة؛ فهذا من مقاصد ديننا وهدف إسلامنا السمح.
فالأولاد لا ذنب لهم في أن تضيع حقوقهم في المجتمع الذي أصبح لا يتعامل إلا بالمواثيق الورقية؛ وقد كانت المواثيق قبلُ عــرفية شفوية بالكلمة لأن الناس قديمًا تغلب عليهم الوفاء وصدق العهد والمعاهدة. أما اليوم فقد انقلب الحال لغير الحال حتى أصبح المخالف زنديقًا مبتدعًا مُجرمًا في نظر الغلاة!. ❝
⏤ محمد أحمد عبيد