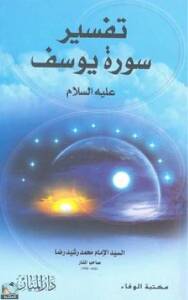❞ المشركون ❝ 💬 اقتباسات من الكتب 📖
- المشركون 💬 اقتباسات من الكتب 📖
█ حصريا تحميل كتاب مجاناً PDF اونلاين 2025
إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
اقتباسات في ❞المشركون❝
-
❞ من الفتوحات الربانية في الحُديبية .. وفي الحديبية🔸️أنزل الله ـ عزّ وجلَّ ـ فِدية الأذى لمن حلق رأسه بالصيام ، أو الصدقة ، أو النُسُك ، في شأن كعب بن عجرة🔸️وفيها دعا رسول الله ﷺ للمُحَلِّقِينَ بالمَغْفِرَة ثلاثاً ، ولِلمُقَصِّرِينَ مَرَّةً🔸️وفيها نحرُوا البَدَنَةَ عن سَبْعَةٍ ، والبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ🔸️وفيها أهدى رسول الله ﷺ في جملا هَدْيِهِ جملاً كان لأبي جهل كان في أنفه بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ ليغيظ به المشركين🔸️وفيها أُنزِلَتْ سورة الفتح🔸️ودخلت خُزاعة في عَقْدِ رسول الله ﷺ وعهده ، ودخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم ، وكان في الشرط أن من شاء أن يدخل في عقده ﷺ دخل ، ومن شاء أن يدخل في عقد قريش دخل🔸️ولما رجع إلى المدينة جاءه نساء مؤمنات ، منهن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ، فجاء أهلُهَا يسألونها رسول الله ﷺ بالشرط الذي كان بينهم ، فلم يَرْجِعُها ﷺ إليهم ، ونهاه الله عزَّ وجلَّ عن ذلك ، فقيل : هذا نسخ للشرط في النساء ، وقيل : تخصيص للسنة بالقرآن وهو عزيز جداً ، وقيل: لم يقع الشرط إلا على الرجال خاصة ، وأراد المشركون أن يُعَمِّمُوهُ في الصنفين ، فأبى الله ذلك. ❝ ⏤محمد ابن قيم الجوزية❞ من الفتوحات الربانية في الحُديبية .
وفي الحديبية🔸️أنزل الله ـ عزّ وجلَّ ـ فِدية
الأذى لمن حلق رأسه بالصيام ، أو الصدقة ، أو النُسُك ، في شأن كعب بن عجرة🔸️وفيها دعا رسول الله ﷺ للمُحَلِّقِينَ بالمَغْفِرَة ثلاثاً ، ولِلمُقَصِّرِينَ مَرَّةً🔸️وفيها نحرُوا البَدَنَةَ عن سَبْعَةٍ ، والبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ🔸️وفيها أهدى رسول الله ﷺ في جملا هَدْيِهِ جملاً كان لأبي جهل كان في أنفه بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ ليغيظ به المشركين🔸️وفيها أُنزِلَتْ سورة الفتح🔸️ودخلت خُزاعة في عَقْدِ رسول الله ﷺ وعهده ، ودخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم ، وكان في الشرط أن من شاء أن يدخل في عقده ﷺ دخل ، ومن شاء أن يدخل في عقد قريش دخل🔸️ولما رجع إلى المدينة جاءه نساء مؤمنات ، منهن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ، فجاء أهلُهَا يسألونها رسول الله ﷺ بالشرط الذي كان بينهم ، فلم يَرْجِعُها ﷺ إليهم ، ونهاه الله عزَّ وجلَّ عن ذلك ، فقيل : هذا نسخ للشرط في النساء ، وقيل : تخصيص للسنة بالقرآن وهو عزيز جداً ، وقيل: لم يقع الشرط إلا على الرجال خاصة ، وأراد المشركون أن يُعَمِّمُوهُ في الصنفين ، فأبى الله ذلك. ❝
⏤ محمد ابن قيم الجوزية -
❞ هديه ﷺ في حَجّهِ وعُمَرِهِ اعتمر ﷺ بعد الهجرة أَرْبَعَ عُمَرٍ ، كُلُّهُنَّ فِي ذِي القعدة 🔸️الأولى عُمرة الحديبية ، وهي أولاهن سنةَ ست ، فصده المشركون عن البيت ، فنحرَ البُدْنَ حيثُ صد بالحديبية ، وحَلَق هو وأصحابه رؤوسهم ، وحلوا من إحرامهم ورجع من عامه إلى المدينة ، 🔸️ الثانية عُمْرَةُ القَضِيَّةِ في العام المقبل ، دخل مكة فأقام بها ثلاثاً ، ثمَّ خَرجَ بعد إكمال عُمرته ، 🔸️الثالثة عمرته التي قرنها مع حجته ، 🔸️الرابعة عُمرتُه من الجِعْرَانَةِ ، لما خرج إلى حُنين ، ثم رجع إلى مكة فاعتمر من الجغرانَةِ داخلاً إليها ، ولم يكن ﷺ في عَمَرِهِ عُمرَّةً واحدة خارجا من مكة ، كما يفعل كثير من الناس اليوم ، وإنما كانت عُمَرُهُ كُلُّها داخلاً إلى مكة ، وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة لم يُنقل عنه أنه اعتمر خارجاً من مكة في تلك المدة أصلاً ، فالعمرة التي فعلها رسول الله ﷺ وشرعها ، هي عمرة الداخل إلى مكة ، لا عمرة من كان بها فيخرج إلى الحل ليعتمر ، ولم يفعل هذا على عهده أحد قط إلا عائشة وحدها بين سائر من كان معه ، لأنها كانت قد أهلت بالعُمرة فحاضت ، فأمرها ، فأدخلت الحج على العمرة ، وصارت قارنة ، وأخبرها أنَّ طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجتها وعمرتها ، فوجدت في نفسها أن يرجع صواحباتها بحج وعمرة مستقلين فإنهنَّ كنَّ متمتعات ولم يحضن ولم يقرن ، وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها ، فأمر أخاها أن يُعمرها من التنعيم تطييباً لقلبها ، ولم يعتمر هو من التنعيم في تلك الحجة ولا أحد ممن كان معه ، وكانت عُمَرَهُ ﷺ كلها في أشهر الحج ، مخالفة لهدي المشركين ، فإنهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج ، ويقولون هي من أفجر الفجور ، وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضلُ منه في رجب بلا شك ، وأما المفاضلة بينه وبين الاعتمار في رمضان ، فموضع نظر ، فقد صح عنه ﷺ أنه أمر أم معقل لما فاتها الحج معه ، أن تعتمر في رمضان ، وأخبرها أَنَّ عُمْرَةً في رَمَضَان تَعْدِلُ حَجَّة ، وأيضاً فقد اجتمع في عمرة رمضان أفضل الزمان ، وأفضل البقاع ، ولكن الله لم يكن ليختار لنبيه في عُمَرِهِ إلَّا أولى الأوقات وأحقها بها ، فكانت العمرة في أشهر الحج نظير وقوع الحج في أشهره ، وهذه الأشهر قد خصها الله تعالى بهذه العبادة ، وجعلها وقتاً لها ، والعمرة حج أصغر ، فأولى الأزمنة بها أشهر الحج ، وذو القعدة أوسطها ، ولم يُحفظ عنه ﷺ أنه إعتمر في السنة إلا مرة واحدة ، ولم يعتمر في السنة مرتين. ❝ ⏤محمد ابن قيم الجوزية❞ هديه ﷺ في حَجّهِ وعُمَرِهِ
اعتمر ﷺ بعد الهجرة أَرْبَعَ عُمَرٍ ، كُلُّهُنَّ فِي ذِي القعدة 🔸️الأولى عُمرة الحديبية ، وهي أولاهن سنةَ ست ، فصده المشركون عن البيت ، فنحرَ البُدْنَ حيثُ صد بالحديبية ، وحَلَق هو وأصحابه رؤوسهم ، وحلوا من إحرامهم ورجع من عامه إلى المدينة ، 🔸️ الثانية عُمْرَةُ القَضِيَّةِ في العام المقبل ، دخل مكة فأقام بها ثلاثاً ، ثمَّ خَرجَ بعد إكمال عُمرته ، 🔸️الثالثة عمرته التي قرنها مع حجته ، 🔸️الرابعة عُمرتُه من الجِعْرَانَةِ ، لما خرج إلى حُنين ، ثم رجع إلى مكة فاعتمر من الجغرانَةِ داخلاً إليها ، ولم يكن ﷺ في عَمَرِهِ عُمرَّةً واحدة خارجا من مكة ، كما يفعل كثير من الناس اليوم ، وإنما كانت عُمَرُهُ كُلُّها داخلاً إلى مكة ، وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة لم يُنقل عنه أنه اعتمر خارجاً من مكة في تلك المدة أصلاً ، فالعمرة التي فعلها رسول الله ﷺ وشرعها ، هي عمرة الداخل إلى مكة ، لا عمرة من كان بها فيخرج إلى الحل ليعتمر ، ولم يفعل هذا على عهده أحد قط إلا عائشة وحدها بين سائر من كان معه ، لأنها كانت قد أهلت بالعُمرة فحاضت ، فأمرها ، فأدخلت الحج على العمرة ، وصارت قارنة ، وأخبرها أنَّ طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجتها وعمرتها ، فوجدت في نفسها أن يرجع صواحباتها بحج وعمرة مستقلين فإنهنَّ كنَّ متمتعات ولم يحضن ولم يقرن ، وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها ، فأمر أخاها أن يُعمرها من التنعيم تطييباً لقلبها ، ولم يعتمر هو من التنعيم في تلك الحجة ولا أحد ممن كان معه ، وكانت عُمَرَهُ ﷺ كلها في أشهر الحج ، مخالفة لهدي المشركين ، فإنهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج ، ويقولون هي من أفجر الفجور ، وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضلُ منه في رجب بلا شك ، وأما المفاضلة بينه وبين الاعتمار في رمضان ، فموضع نظر ، فقد صح عنه ﷺ أنه أمر أم معقل لما فاتها الحج معه ، أن تعتمر في رمضان ، وأخبرها أَنَّ عُمْرَةً في رَمَضَان تَعْدِلُ حَجَّة ، وأيضاً فقد اجتمع في عمرة رمضان أفضل الزمان ، وأفضل البقاع ، ولكن الله لم يكن ليختار لنبيه في عُمَرِهِ إلَّا أولى الأوقات وأحقها بها ، فكانت العمرة في أشهر الحج نظير وقوع الحج في أشهره ، وهذه الأشهر قد خصها الله تعالى بهذه العبادة ، وجعلها وقتاً لها ، والعمرة حج أصغر ، فأولى الأزمنة بها أشهر الحج ، وذو القعدة أوسطها ، ولم يُحفظ عنه ﷺ أنه إعتمر في السنة إلا مرة واحدة ، ولم يعتمر في السنة مرتين. ❝
⏤ محمد ابن قيم الجوزية -
❞ غزوةِ المُرَيْسِيع ، (غزوة بني المصطلق) ، وكانت في شعبان سنَةَ خَمْسٍ ، وسببها : أنه لما بلغه ﷺ أن الحارث بن أبي ضرار سيد بن المُصْطَلِق سار في قومه ومن قَدَرَ عليه من العرب ، يُريدون حرب رسول الله ﷺ ، فبعث بريْدَةَ بن الحصيب الأسلمي يَعْلَمُ له ذلك فأتاهم ، ولقي الحارث بن أبي ضرار وكلمه ، ورجَعَ إلى رسول الله ﷺ ، فأخبره خبرهم ، فندب رسولُ اللهِ ﷺ الناس فأسرعوا في الخروج ، وخرج معهم جماعة من المنافقين ، لم يخرجوا في غزاة قبلها ، واستعمل على المدينة زيد بن حارثة ، وقيل أبا ذر ، وقيل نُمَيْلَةَ بن عبد الله الليثي ، وخرج يوم الإثنين لليلتين خَلَتا شعبان ، وبلغ الحارث بن أبي ضرار ومَنْ معه مسير رسول الله ﷺ وقَتْلُه عَينَه الذي كان وجَّهه ليأتِيَه بخبره وخبر المسلمين ، فخافُوا خوفاً شديداً ، وتفرق عنهم مَنْ كان معهم من العرب وانتهى رسول الله ﷺ إلى المُرَبْسِيعِ ، وهو مكان الماء ، فضُرب عليه قبته ، ومعه عائشة وأم سلمة ، فتهيؤوا للقتال ، وصف رسول الله ﷺ أصحابه ، وراية المهاجرين مع أبي بكر الصديق ، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة ، فترامَوْ بِالنَّبْلِ ساعةً ، ثم أمر رسولُ اللهِ ﷺ أصحابه ، فحملوا حملة رجل واحد ، فكانت النصرة ، وانهزم المشركون ، وقُتِلَ مَنْ قُتِلَ منهم ، وسَبَى رسول الله النساء والذراري ، والنَّعَمَ والشَّاءَ ، ولم يُقْتَلُ مِنْ المسلمين إلا رجل واحد ، هكذا قال عبد المؤمن بن خلف في سيرته وغيره ، وهو وهم ، فإنه لم يكن بينهم قتال ، وإنما أغار عليهم على الماء ، فَسَبَى ذَراريهم ، وأموالهم ، كما في الصحيح : أغار رسول الله ﷺ على بني المُضْطَلِقِ، وَهُمْ غَارُونَ وذكر الحديث ... ، وكان مِن جُملة السبي جُوَيْرِيَةُ بنت الحارث سَيِّدِ القوم ، وقعت في سَهُم ثابت بن قيس ، فكاتبها ، فأدَّى عنها رسُولُ الله ﷺ ، وتزوجها ، فأعتق المسلمون بسبب هذا التزويج مئة أهل بيت من بني المُصْطَلَقِ قد أسلموا ، وقالُوا : أصهارَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وفيها فقدت عائشة العقد وحصلت قصة الإفك المعروفة. ❝ ⏤محمد ابن قيم الجوزية❞ غزوةِ المُرَيْسِيع ، (غزوة بني المصطلق) ، وكانت في شعبان سنَةَ خَمْسٍ ، وسببها : أنه لما بلغه ﷺ أن الحارث بن أبي ضرار سيد بن المُصْطَلِق سار في قومه ومن قَدَرَ عليه من العرب ، يُريدون حرب رسول الله ﷺ ، فبعث بريْدَةَ بن الحصيب الأسلمي يَعْلَمُ له ذلك فأتاهم ، ولقي الحارث بن أبي ضرار وكلمه ، ورجَعَ إلى رسول الله ﷺ ، فأخبره خبرهم ، فندب رسولُ اللهِ ﷺ الناس فأسرعوا في الخروج ، وخرج معهم جماعة من المنافقين ، لم يخرجوا في غزاة قبلها ، واستعمل على المدينة زيد بن حارثة ، وقيل أبا ذر ، وقيل نُمَيْلَةَ بن عبد الله الليثي ، وخرج يوم الإثنين لليلتين خَلَتا شعبان ، وبلغ الحارث بن أبي ضرار ومَنْ معه مسير رسول الله ﷺ وقَتْلُه عَينَه الذي كان وجَّهه ليأتِيَه بخبره وخبر المسلمين ، فخافُوا خوفاً شديداً ، وتفرق عنهم مَنْ كان معهم من العرب وانتهى رسول الله ﷺ إلى المُرَبْسِيعِ ، وهو مكان الماء ، فضُرب عليه قبته ، ومعه عائشة وأم سلمة ، فتهيؤوا للقتال ، وصف رسول الله ﷺ أصحابه ، وراية المهاجرين مع أبي بكر الصديق ، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة ، فترامَوْ بِالنَّبْلِ ساعةً ، ثم أمر رسولُ اللهِ ﷺ أصحابه ، فحملوا حملة رجل واحد ، فكانت النصرة ، وانهزم المشركون ، وقُتِلَ مَنْ قُتِلَ منهم ، وسَبَى رسول الله النساء والذراري ، والنَّعَمَ والشَّاءَ ، ولم يُقْتَلُ مِنْ المسلمين إلا رجل واحد ، هكذا قال عبد المؤمن بن خلف في سيرته وغيره ، وهو وهم ، فإنه لم يكن بينهم قتال ، وإنما أغار عليهم على الماء ، فَسَبَى ذَراريهم ، وأموالهم ، كما في الصحيح : أغار رسول الله ﷺ على بني المُضْطَلِقِ، وَهُمْ غَارُونَ وذكر الحديث .. ، وكان مِن جُملة السبي جُوَيْرِيَةُ بنت الحارث سَيِّدِ القوم ، وقعت في سَهُم ثابت بن قيس ، فكاتبها ، فأدَّى عنها رسُولُ الله ﷺ ، وتزوجها ، فأعتق المسلمون بسبب هذا التزويج مئة أهل بيت من بني المُصْطَلَقِ قد أسلموا ، وقالُوا : أصهارَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وفيها فقدت عائشة العقد وحصلت قصة الإفك المعروفة. ❝
⏤ محمد ابن قيم الجوزية -
❞ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (21) قوله تعالى : وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون قوله تعالى : وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه قيل : الاشتراء هنا بمعنى الاستبدال ; إذ لم يكن ذلك عقدا ، مثل : أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى . وقيل : إنهم ظنوه في ظاهر الحال اشتراء ، فجرى هذا اللفظ على ظاهر الظن . قال الضحاك : هذا الذي اشتراه ملك مصر ، ولقبه العزيز . السهيلي : واسمه قطفير . وقال ابن إسحاق : إطفير بن رويحب اشتراه لامرأته راعيل ; ذكره الماوردي . وقيل : كان اسمها زليخاء . وكان الله ألقى محبة يوسف على قلب العزيز ، فأوصى به أهله ; ذكره القشيري . وقد ذكر القولين في اسمها الثعلبي وغيره . وقال ابن عباس : إنما اشتراه قطفير وزير ملك مصر ، وهو الريان بن الوليد . وقيل : الوليد بن الريان ، وهو رجل من العمالقة . وقيل : هو فرعون موسى ; لقول موسى : ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات وأنه عاش أربعمائة سنة . وقيل : فرعون موسى من أولاد فرعون يوسف ، على ما يأتي في [ غافر ] بيانه . وكان هذا العزيز الذي اشترى يوسف على خزائن الملك ; واشترى يوسف من مالك بن دعر بعشرين دينارا ، وزاده حلة ونعلين . وقيل : اشتراه من أهل الرفقة . وقيل : تزايدوا في ثمنه فبلغ أضعاف وزنه مسكا وعنبرا وحريرا وورقا وذهبا ولآلئ وجواهر لا يعلم قيمتها إلا الله ; فابتاعه قطفير من مالك بهذا الثمن ; قاله وهب بن منبه . وقال وهب أيضا وغيره : ولما اشترى مالك بن دعر يوسف من إخوته كتب بينهم وبينه كتابا : هذا ما اشترى مالك بن دعر من بني يعقوب ، وهم فلان وفلان مملوكا لهم بعشرين درهما ، وقد شرطوا له أنه آبق ، وأنه لا ينقلب به إلا مقيدا مسلسلا ، وأعطاهم على ذلك عهد الله . قال : فودعهم يوسف عند ذلك ، وجعل يقول : حفظكم الله وإن ضيعتموني ، نصركم الله وإن خذلتموني ، رحمكم الله وإن لم ترحموني ; قالوا : فألقت الأغنام ما في بطونها دما عبيطا لشدة هذا التوديع ، وحملوه على قتب بغير غطاء ولا وطاء ، مقيدا مكبلا مسلسلا ، فمر على مقبرة آل كنعان فرأى قبر أمه - وقد كان وكل به أسود يحرسه فغفل الأسود - فألقى يوسف نفسه على قبر أمه فجعل يتمرغ ويعتنق القبر ويضطرب ويقول : يا أماه ! ارفعي رأسك تري ولدك مكبلا مقيدا مسلسلا مغلولا ; فرقوا بيني وبين والدي ، فاسألي الله أن يجمع بيننا في مستقر رحمته إنه أرحم الراحمين ، فتفقده الأسود على البعير فلم يره ، فقفا أثره ، فإذا هو بياض على قبر ، فتأمله فإذا هو إياه ، فركضه برجله في التراب ومرغه وضربه ضربا وجيعا ; فقال له : لا تفعل ! والله ما هربت ولا أبقت وإنما مررت بقبر أمي فأحببت أن أودعها ، ولن أرجع إلى ما تكرهون ; فقال الأسود : والله إنك لعبد سوء ، تدعو أباك مرة وأمك أخرى ! فهلا كان هذا عند مواليك ; فرفع يديه إلى السماء وقال : اللهم إن كانت لي عندك خطيئة أخلقت بها وجهي فأسألك بحق آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن تغفر لي وترحمني ; فضجت الملائكة في السماء ، ونزل جبريل فقال له : يا يوسف غض صوتك فلقد أبكيت ملائكة السماء أفتريد أن أقلب الأرض فأجعل عاليها سافلها ؟ قال : تثبت يا جبريل ، فإن الله حليم لا يعجل ; فضرب الأرض بجناحه فأظلمت ، وارتفع الغبار ، وكسفت الشمس ، وبقيت القافلة لا يعرف بعضها بعضا ; فقال رئيس القافلة : من أحدث منكم حدثا ؟ - فإني أسافر منذ كيت وكيت ما أصابني قط مثل هذا - فقال الأسود : أنا لطمت ذلك الغلام العبراني فرفع يده إلى السماء وتكلم بكلام لا أعرفه ، ولا أشك أنه دعا علينا ; فقال له : ما أردت إلا هلاكنا ايتنا به ، فأتاه به ، فقال له : يا غلام لقد لطمك فجاءنا ما رأيت ; فإن كنت تقتص فاقتص ممن شئت ، وإن كنت تعفو فهو الظن بك ; قال : قد عفوت رجاء أن يعفو الله عني ; فانجلت الغبرة ، وظهرت الشمس ، وأضاء مشارق الأرض ومغاربها ، وجعل التاجر يزوره بالغداة والعشي ويكرمه ، حتى وصل إلى مصر فاغتسل في نيلها وأذهب الله عنه كآبة السفر ، ورد عليه جماله ، ودخل به البلد نهارا فسطع نوره على الجدران ، وأوقفوه للبيع فاشتراه قطفير وزير الملك ; قاله ابن عباس على ما تقدم . وقيل : إن هذا الملك لم يمت حتى آمن واتبع يوسف على دينه ، ثم مات الملك ويوسف يومئذ على خزائن الأرض ; فملك بعده قابوس وكان كافرا ، فدعاه يوسف إلى الإسلام فأبى . أكرمي مثواه أي منزله ومقامه بطيب المطعم واللباس الحسن ; وهو مأخوذ من ثوى بالمكان أي أقام به ; وقد تقدم في [ آل عمران ] وغيره . عسى أن ينفعنا أي يكفينا بعض المهمات إذا بلغ . أو نتخذه ولدا قال ابن عباس : كان حصورا لا يولد له ، وكذا قال ابن إسحاق : كان قطفير لا يأتي النساء ولا يولد له . فإن قيل : كيف قال أو نتخذه ولدا وهو ملكه ، والولدية مع العبدية تتناقض ؟ قيل له : يعتقه ثم يتخذه ولدا بالتبني ; وكان التبني في الأمم معلوما عندهم ، وكذلك كان في أول الإسلام ، على ما يأتي بيانه في [ الأحزاب ] إن شاء الله تعالى . وقال عبد الله بن مسعود : أحسن الناس فراسة ثلاثة ; العزيز حين تفرس في يوسف فقال : عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ، وبنت شعيب حين قالت لأبيها في موسى استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ، وأبو بكر حين استخلف عمر . قال ابن العربي : عجبا للمفسرين في اتفاقهم على جلب هذا الخبر ، والفراسة هي علم غريب على ما يأتي بيانه في سورة [ الحجر ] وليس كذلك فيما نقلوه ; لأن الصديق إنما ولى عمر بالتجربة في الأعمال ، والمواظبة على الصحبة وطولها ، والاطلاع على ما شاهد منه من العلم والمنة ، وليس ذلك من طريق الفراسة ; وأما بنت شعيب فكانت معها العلامة البينة على ما يأتي بيانه في [ القصص ] . وأما أمر العزيز فيمكن أن يجعل فراسة ; لأنه لم يكن معه علامة ظاهرة . والله أعلم . قوله تعالى : وكذلك مكنا ليوسف في الأرض الكاف في موضع نصب ; أي وكما أنقذناه من إخوته ومن الجب فكذلك مكنا له ; أي عطفنا عليه قلب الملك الذي اشتراه حتى تمكن من الأمر والنهي في البلد الذي الملك مستول عليه . ولنعلمه من تأويل الأحاديث أي فعلنا ذلك تصديقا لقول يعقوب : ويعلمك من تأويل الأحاديث . وقيل : المعنى مكناه لنوحي إليه بكلام منا ، ونعلمه تأويله . وتفسيره ، وتأويل الرؤيا ، وتم الكلام . والله غالب على أمره الهاء راجعة إلى الله تعالى ; أي لا يغلب الله شيء ، بل هو الغالب على أمر نفسه فيما يريده أن يقول له : كن فيكون . وقيل : ترجع إلى يوسف ; أي الله غالب على أمر يوسف يدبره ويحوطه ولا يكله إلى غيره ، حتى لا يصل إليه كيد كائد . ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي لا يطلعون على غيبه . وقيل : المراد بالأكثر الجميع ; لأن أحدا لا يعلم الغيب . وقيل : هو مجرى على ظاهره ; إذ قد يطلع من يريد على بعض غيبه . وقيل : المعنى ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله غالب على أمره ، وهم المشركون ومن لا يؤمن بالقدر . وقالت الحكماء في هذه الآية : والله غالب على أمره حيث أمره يعقوب ألا يقص رؤياه على إخوته فغلب أمر الله حتى قص ، ثم أراد إخوته قتله فغلب أمر الله حتى صار ملكا وسجدوا بين يديه ، ثم أراد الإخوة أن يخلو لهم وجه أبيهم فغلب أمر الله حتى ضاق عليهم قلب أبيهم ، وافتكره بعد سبعين سنة أو ثمانين سنة ، فقال : يا أسفا على يوسف ثم تدبروا أن يكونوا من بعده قوما صالحين ، أي تائبين فغلب أمر الله حتى نسوا الذنب وأصروا عليه حتى أقروا بين يدي يوسف في آخر الأمر بعد سبعين سنة ، وقالوا لأبيهم : إنا كنا خاطئين ثم أرادوا أن يخدعوا أباهم بالبكاء والقميص فغلب أمر الله فلم ينخدع ، وقال : بل سولت لكم أنفسكم أمرا ثم احتالوا في أن تزول محبته من قلب أبيهم فغلب أمر الله فازدادت المحبة والشوق في قلبه ، ثم دبرت امرأة العزيز أنها إن ابتدرته بالكلام غلبته ، فغلب أمر الله حتى قال العزيز : استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين ، ثم دبر يوسف أن يتخلص من السجن بذكر الساقي فغلب أمر الله فنسي الساقي ، ولبث يوسف في السجن بضع سنين .. ❝ ⏤محمد رشيد رضا❞ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (21)
قوله تعالى : وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
قوله تعالى : وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه قيل : الاشتراء هنا بمعنى الاستبدال ; إذ لم يكن ذلك عقدا ، مثل : أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى . وقيل : إنهم ظنوه في ظاهر الحال اشتراء ، فجرى هذا اللفظ على ظاهر الظن . قال الضحاك : هذا الذي اشتراه ملك مصر ، ولقبه العزيز . السهيلي : واسمه قطفير . وقال ابن إسحاق : إطفير بن رويحب اشتراه لامرأته راعيل ; ذكره الماوردي . وقيل : كان اسمها زليخاء . وكان الله ألقى محبة يوسف على قلب العزيز ، فأوصى به أهله ; ذكره القشيري . وقد ذكر القولين في اسمها الثعلبي وغيره . وقال ابن عباس : إنما اشتراه قطفير وزير ملك مصر ، وهو الريان بن الوليد . وقيل : الوليد بن الريان ، وهو رجل من العمالقة . وقيل : هو فرعون موسى ; لقول موسى : ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات وأنه عاش أربعمائة سنة . وقيل : فرعون موسى من أولاد فرعون يوسف ، على ما يأتي في [ غافر ] بيانه . وكان هذا العزيز الذي اشترى يوسف على خزائن الملك ; واشترى يوسف من مالك بن دعر بعشرين دينارا ، وزاده حلة ونعلين . وقيل : اشتراه من أهل الرفقة . وقيل : تزايدوا في ثمنه فبلغ أضعاف وزنه مسكا وعنبرا وحريرا وورقا وذهبا ولآلئ وجواهر لا يعلم قيمتها إلا الله ; فابتاعه قطفير من مالك بهذا الثمن ; قاله وهب بن منبه . وقال وهب أيضا وغيره : ولما اشترى مالك بن دعر يوسف من إخوته كتب بينهم وبينه كتابا : هذا ما اشترى مالك بن دعر من بني يعقوب ، وهم فلان وفلان مملوكا لهم بعشرين درهما ، وقد شرطوا له أنه آبق ، وأنه لا ينقلب به إلا مقيدا مسلسلا ، وأعطاهم على ذلك عهد الله . قال : فودعهم يوسف عند ذلك ، وجعل يقول : حفظكم الله وإن ضيعتموني ، نصركم الله وإن خذلتموني ، رحمكم الله وإن لم ترحموني ; قالوا : فألقت الأغنام ما في بطونها دما عبيطا لشدة هذا التوديع ، وحملوه على قتب بغير غطاء ولا وطاء ، مقيدا مكبلا مسلسلا ، فمر على مقبرة آل كنعان فرأى قبر أمه - وقد كان وكل به أسود يحرسه فغفل الأسود - فألقى يوسف نفسه على قبر أمه فجعل يتمرغ ويعتنق القبر ويضطرب ويقول : يا أماه ! ارفعي رأسك تري ولدك مكبلا مقيدا مسلسلا مغلولا ; فرقوا بيني وبين والدي ، فاسألي الله أن يجمع بيننا في مستقر رحمته إنه أرحم الراحمين ، فتفقده الأسود على البعير فلم يره ، فقفا أثره ، فإذا هو بياض على قبر ، فتأمله فإذا هو إياه ، فركضه برجله في التراب ومرغه وضربه ضربا وجيعا ; فقال له : لا تفعل ! والله ما هربت ولا أبقت وإنما مررت بقبر أمي فأحببت أن أودعها ، ولن أرجع إلى ما تكرهون ; فقال الأسود : والله إنك لعبد سوء ، تدعو أباك مرة وأمك أخرى ! فهلا كان هذا عند مواليك ; فرفع يديه إلى السماء وقال : اللهم إن كانت لي عندك خطيئة أخلقت بها وجهي فأسألك بحق آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن تغفر لي وترحمني ; فضجت الملائكة في السماء ، ونزل جبريل فقال له : يا يوسف غض صوتك فلقد أبكيت ملائكة السماء أفتريد أن أقلب الأرض فأجعل عاليها سافلها ؟ قال : تثبت يا جبريل ، فإن الله حليم لا يعجل ; فضرب الأرض بجناحه فأظلمت ، وارتفع الغبار ، وكسفت الشمس ، وبقيت القافلة لا يعرف بعضها بعضا ; فقال رئيس القافلة : من أحدث منكم حدثا ؟ - فإني أسافر منذ كيت وكيت ما أصابني قط مثل هذا - فقال الأسود : أنا لطمت ذلك الغلام العبراني فرفع يده إلى السماء وتكلم بكلام لا أعرفه ، ولا أشك أنه دعا علينا ; فقال له : ما أردت إلا هلاكنا ايتنا به ، فأتاه به ، فقال له : يا غلام لقد لطمك فجاءنا ما رأيت ; فإن كنت تقتص فاقتص ممن شئت ، وإن كنت تعفو فهو الظن بك ; قال : قد عفوت رجاء أن يعفو الله عني ; فانجلت الغبرة ، وظهرت الشمس ، وأضاء مشارق الأرض ومغاربها ، وجعل التاجر يزوره بالغداة والعشي ويكرمه ، حتى وصل إلى مصر فاغتسل في نيلها وأذهب الله عنه كآبة السفر ، ورد عليه جماله ، ودخل به البلد نهارا فسطع نوره على الجدران ، وأوقفوه للبيع فاشتراه قطفير وزير الملك ; قاله ابن عباس على ما تقدم .
وقيل : إن هذا الملك لم يمت حتى آمن واتبع يوسف على دينه ، ثم مات الملك ويوسف يومئذ على خزائن الأرض ; فملك بعده قابوس وكان كافرا ، فدعاه يوسف إلى الإسلام فأبى .
أكرمي مثواه أي منزله ومقامه بطيب المطعم واللباس الحسن ; وهو مأخوذ من ثوى بالمكان أي أقام به ; وقد تقدم في [ آل عمران ] وغيره .
عسى أن ينفعنا أي يكفينا بعض المهمات إذا بلغ .
أو نتخذه ولدا قال ابن عباس : كان حصورا لا يولد له ، وكذا قال ابن إسحاق : كان قطفير لا يأتي النساء ولا يولد له . فإن قيل : كيف قال أو نتخذه ولدا وهو ملكه ، والولدية مع العبدية تتناقض ؟ قيل له : يعتقه ثم يتخذه ولدا بالتبني ; وكان التبني في الأمم معلوما عندهم ، وكذلك كان في أول الإسلام ، على ما يأتي بيانه في [ الأحزاب ] إن شاء الله تعالى . وقال عبد الله بن مسعود : أحسن الناس فراسة ثلاثة ; العزيز حين تفرس في يوسف فقال : عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ، وبنت شعيب حين قالت لأبيها في موسى استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ، وأبو بكر حين استخلف عمر . قال ابن العربي : عجبا للمفسرين في اتفاقهم على جلب هذا الخبر ، والفراسة هي علم غريب على ما يأتي بيانه في سورة [ الحجر ] وليس كذلك فيما نقلوه ; لأن الصديق إنما ولى عمر بالتجربة في الأعمال ، والمواظبة على الصحبة وطولها ، والاطلاع على ما شاهد منه من العلم والمنة ، وليس ذلك من طريق الفراسة ; وأما بنت شعيب فكانت معها العلامة البينة على ما يأتي بيانه في [ القصص ] . وأما أمر العزيز فيمكن أن يجعل فراسة ; لأنه لم يكن معه علامة ظاهرة . والله أعلم .
قوله تعالى : وكذلك مكنا ليوسف في الأرض الكاف في موضع نصب ; أي وكما أنقذناه من إخوته ومن الجب فكذلك مكنا له ; أي عطفنا عليه قلب الملك الذي اشتراه حتى تمكن من الأمر والنهي في البلد الذي الملك مستول عليه .
ولنعلمه من تأويل الأحاديث أي فعلنا ذلك تصديقا لقول يعقوب : ويعلمك من تأويل الأحاديث . وقيل : المعنى مكناه لنوحي إليه بكلام منا ، ونعلمه تأويله . وتفسيره ، وتأويل الرؤيا ، وتم الكلام .
والله غالب على أمره الهاء راجعة إلى الله تعالى ; أي لا يغلب الله شيء ، بل هو الغالب على أمر نفسه فيما يريده أن يقول له : كن فيكون . وقيل : ترجع إلى يوسف ; أي الله غالب على أمر يوسف يدبره ويحوطه ولا يكله إلى غيره ، حتى لا يصل إليه كيد كائد .
ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي لا يطلعون على غيبه . وقيل : المراد بالأكثر الجميع ; لأن أحدا لا يعلم الغيب . وقيل : هو مجرى على ظاهره ; إذ قد يطلع من يريد على بعض غيبه . وقيل : المعنى ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله غالب على أمره ، وهم المشركون ومن لا يؤمن بالقدر .
وقالت الحكماء في هذه الآية : والله غالب على أمره حيث أمره يعقوب ألا يقص رؤياه على إخوته فغلب أمر الله حتى قص ، ثم أراد إخوته قتله فغلب أمر الله حتى صار ملكا وسجدوا بين يديه ، ثم أراد الإخوة أن يخلو لهم وجه أبيهم فغلب أمر الله حتى ضاق عليهم قلب أبيهم ، وافتكره بعد سبعين سنة أو ثمانين سنة ، فقال : يا أسفا على يوسف ثم تدبروا أن يكونوا من بعده قوما صالحين ، أي تائبين فغلب أمر الله حتى نسوا الذنب وأصروا عليه حتى أقروا بين يدي يوسف في آخر الأمر بعد سبعين سنة ، وقالوا لأبيهم : إنا كنا خاطئين ثم أرادوا أن يخدعوا أباهم بالبكاء والقميص فغلب أمر الله فلم ينخدع ، وقال : بل سولت لكم أنفسكم أمرا ثم احتالوا في أن تزول محبته من قلب أبيهم فغلب أمر الله فازدادت المحبة والشوق في قلبه ، ثم دبرت امرأة العزيز أنها إن ابتدرته بالكلام غلبته ، فغلب أمر الله حتى قال العزيز : استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين ، ثم دبر يوسف أن يتخلص من السجن بذكر الساقي فغلب أمر الله فنسي الساقي ، ولبث يوسف في السجن بضع سنين. ❝
⏤ محمد رشيد رضا -
❞ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7) صراط الذين أنعمت عليهم صراط بدل من الأول بدل الشيء من الشيء ; كقولك : جاءني زيد أبوك . ومعناه : أدم هدايتنا ، فإن الإنسان قد يهدى إلى الطريق ثم يقطع به . وقيل : هو صراط آخر ، ومعناه العلم بالله جل وعز والفهم عنه ; قاله جعفر بن محمد . ولغة القرآن الذين في الرفع والنصب والجر ، وهذيل تقول : ( اللذون ) في الرفع ، ومن العرب من يقول : ( اللذو ) ، ومنهم من يقول ( الذي ) وسيأتي . وفي ( عليهم ) عشر لغات ; قرئ بعامتها : " عليهم " بضم الهاء وإسكان الميم . " وعليهم " بكسر الهاء وإسكان الميم . و " عليهمي " بكسر الهاء والميم وإلحاق ياء بعد الكسرة . و " عليهمو " بكسر الهاء وضم الميم وزيادة واو بعد الضمة . و " عليهمو " بضم الهاء والميم كلتيهما وإدخال واو بعد الميم و " عليهم " بضم الهاء والميم من غير زيادة واو . وهذه الأوجه الستة مأثورة عن الأئمة من القراء . وأوجه أربعة منقولة عن العرب غير محكية عن القراء : " عليهمي " بضم الهاء وكسر الميم وإدخال ياء بعد الميم ; حكاها الحسن البصري عن العرب . و " عليهم " بضم الهاء وكسر الميم من غير زيادة ياء . و " عليهم " بكسر الهاء وضم الميم من غير إلحاق واو . و " عليهم " بكسر الهاء والميم ولا ياء بعد الميم . وكلها صواب ; قاله ابن الأنباري . قرأ عمر بن الخطاب وابن الزبير رضي الله عنهما " صراط من أنعمت عليهم " . واختلف الناس في المنعم عليهم ; فقال الجمهور من المفسرين : إنه أراد صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . وانتزعوا ذلك من قوله تعالى : ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا . فالآية تقتضي أن هؤلاء على صراط مستقيم ، وهو المطلوب في آية الحمد ; وجميع ما قيل إلى هذا يرجع ، فلا معنى لتعديد الأقوال والله المستعان . وفي هذه الآية رد على القدرية والمعتزلة والإمامية ، لأنهم يعتقدون أن إرادة الإنسان كافية في صدور أفعاله منه ، طاعة كانت أو معصية ; لأن الإنسان عندهم خالق لأفعاله ، فهو غير محتاج في صدورها عنه إلى ربه ; وقد أكذبهم الله تعالى في هذه الآية إذ سألوه الهداية إلى الصراط المستقيم ; فلو كان الأمر إليهم والاختيار بيدهم دون ربهم لما سألوه الهداية ، ولا كرروا السؤال في كل صلاة ; وكذلك تضرعهم إليه في دفع المكروه ، وهو ما يناقض الهداية حيث قالوا : صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . فكما سألوه أن يهديهم سألوه ألا يضلهم ، وكذلك يدعون فيقولون : ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الآية . غير المغضوب عليهم ولا الضالين اختلف في المغضوب عليهم و الضالين من هم ؟ فالجمهور أن المغضوب عليهم اليهود ، والضالين النصارى ; وجاء ذلك مفسرا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم وقصة إسلامه ، أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ، والترمذي في جامعه . وشهد لهذا التفسير أيضا قوله سبحانه في اليهود : وباءوا بغضب من الله . وقال : وغضب الله عليهم وقال في النصارى : قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل . وقيل : المغضوب عليهم المشركون . و الضالين المنافقون . وقيل : المغضوب عليهم هو من أسقط فرض هذه السورة في الصلاة ; و الضالين عن بركة قراءتها . حكاه السلمي في حقائقه والماوردي في تفسيره ; وليس بشيء . قال الماوردي : وهذا وجه مردود ، لأن ما تعارضت فيه الأخبار وتقابلت فيه الآثار وانتشر فيه الخلاف ، لم يجز أن يطلق عليه هذا الحكم . وقيل : المغضوب عليهم باتباع البدع ; و الضالين عن سنن الهدى . قلت : وهذا حسن ; وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأعلى وأحسن . و ( عليهم ) في موضع رفع ، لأن المعنى غضب عليهم . والغضب في اللغة الشدة . ورجل غضوب أي شديد الخلق . والغضوب : الحية الخبيثة لشدتها . والغضبة : الدرقة من جلد البعير يطوى بعضها على بعض ; سميت بذلك لشدتها . ومعنى الغضب في صفة الله تعالى إرادة العقوبة ، فهو صفة ذات ، وإرادة الله تعالى من صفات ذاته ; أو نفس العقوبة ، ومنه الحديث : إن الصدقة لتطفئ غضب الرب فهو صفة فعل . ولا الضالين الضلال في كلام العرب هو الذهاب عن سنن القصد وطريق الحق ; ومنه : ضل اللبن في الماء أي غاب . ومنه : أئذا ضللنا في الأرض أي غبنا بالموت وصرنا ترابا ; قال : ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين ساروا والضلضلة : حجر أملس يردده الماء في الوادي . وكذلك الغضبة : صخرة في الجبل مخالفة لونه ، قال : أو غضبة في هضبة ما أمنعا قرأ عمر بن الخطاب وأبي بن كعب " غير المغضوب عليهم وغير الضالين " وروي عنهما في الراء النصب والخفض في الحرفين ; فالخفض على البدل من ( الذين ) أو من الهاء والميم في ( عليهم ) ; أو صفة للذين والذين معرفة ولا توصف المعارف بالنكرات ولا النكرات بالمعارف ، إلا أن الذين ليس بمقصود قصدهم فهو عام ; فالكلام بمنزلة قولك : إني لأمر بمثلك فأكرمه ; أو لأن ( غير ) تعرفت لكونها بين شيئين لا وسط بينهما ، كما تقول : الحي غير الميت ، والساكن غير المتحرك ، والقائم غير القاعد ، قولان : الأول للفارسي ، والثاني للزمخشري . والنصب في الراء على وجهين : على الحال من الذين ، أو من الهاء والميم في عليهم ، كأنك قلت : أنعمت عليهم لا مغضوبا عليهم . أو على الاستثناء ، كأنك قلت : إلا المغضوب عليهم . ويجوز النصب بأعني ; وحكي عن الخليل . ( لا ) في قوله ولا الضالين اختلف فيها ، فقيل هي زائدة ; قاله الطبري . ومنه قوله تعالى : ما منعك ألا تسجد . وقيل : هي تأكيد دخلت لئلا يتوهم أن الضالين معطوف على الذين ، حكاه مكي والمهدوي . وقال الكوفيون : " لا " بمعنى غير ، وهي قراءة عمر وأبي ; وقد تقدم . الأصل في الضالين : الضاللين حذفت حركة اللام الأولى ثم أدغمت اللام في اللام فاجتمع ساكنان مدة الألف واللام المدغمة . وقرأ أيوب السختياني : ولا الضألين بهمزة غير ممدودة ; كأنه فر من التقاء الساكنين وهي لغة . حكى أبو زيد قال : سمعت عمرو بن عبيد يقرأ : " فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جأن " فظننته قد لحن حتى سمعت من العرب : دأبة وشأبة . قال أبو الفتح : وعلى هذه اللغة قول كثير : إذا ما العوالي بالعبيط احمأرت نجز تفسير سورة الحمد ; ولله الحمد والمنة .. ❝ ⏤عبدالعزيز بن داخل المطيري❞ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)
صراط الذين أنعمت عليهم
صراط بدل من الأول بدل الشيء من الشيء ; كقولك : جاءني زيد أبوك . ومعناه : أدم هدايتنا ، فإن الإنسان قد يهدى إلى الطريق ثم يقطع به . وقيل : هو صراط آخر ، ومعناه العلم بالله جل وعز والفهم عنه ; قاله جعفر بن محمد . ولغة القرآن الذين في الرفع والنصب والجر ، وهذيل تقول : ( اللذون ) في الرفع ، ومن العرب من يقول : ( اللذو ) ، ومنهم من يقول ( الذي ) وسيأتي .
وفي ( عليهم ) عشر لغات ; قرئ بعامتها : ˝ عليهم ˝ بضم الهاء وإسكان الميم . ˝ وعليهم ˝ بكسر الهاء وإسكان الميم . و ˝ عليهمي ˝ بكسر الهاء والميم وإلحاق ياء بعد الكسرة . و ˝ عليهمو ˝ بكسر الهاء وضم الميم وزيادة واو بعد الضمة . و ˝ عليهمو ˝ بضم الهاء والميم كلتيهما وإدخال واو بعد الميم و ˝ عليهم ˝ بضم الهاء والميم من غير زيادة واو . وهذه الأوجه الستة مأثورة عن الأئمة من القراء . وأوجه أربعة منقولة عن العرب غير محكية عن القراء : ˝ عليهمي ˝ بضم الهاء وكسر الميم وإدخال ياء بعد الميم ; حكاها الحسن البصري عن العرب . و ˝ عليهم ˝ بضم الهاء وكسر الميم من غير زيادة ياء . و ˝ عليهم ˝ بكسر الهاء وضم الميم من غير إلحاق واو . و ˝ عليهم ˝ بكسر الهاء والميم ولا ياء بعد الميم . وكلها صواب ; قاله ابن الأنباري .
قرأ عمر بن الخطاب وابن الزبير رضي الله عنهما ˝ صراط من أنعمت عليهم ˝ . واختلف الناس في المنعم عليهم ; فقال الجمهور من المفسرين : إنه أراد صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . وانتزعوا ذلك من قوله تعالى : ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا . فالآية تقتضي أن هؤلاء على صراط مستقيم ، وهو المطلوب في آية الحمد ; وجميع ما قيل إلى هذا يرجع ، فلا معنى لتعديد الأقوال والله المستعان .
وفي هذه الآية رد على القدرية والمعتزلة والإمامية ، لأنهم يعتقدون أن إرادة الإنسان كافية في صدور أفعاله منه ، طاعة كانت أو معصية ; لأن الإنسان عندهم خالق لأفعاله ، فهو غير محتاج في صدورها عنه إلى ربه ; وقد أكذبهم الله تعالى في هذه الآية إذ سألوه الهداية إلى الصراط المستقيم ; فلو كان الأمر إليهم والاختيار بيدهم دون ربهم لما سألوه الهداية ، ولا كرروا السؤال في كل صلاة ; وكذلك تضرعهم إليه في دفع المكروه ، وهو ما يناقض الهداية حيث قالوا : صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . فكما سألوه أن يهديهم سألوه ألا يضلهم ، وكذلك يدعون فيقولون : ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الآية .
غير المغضوب عليهم ولا الضالين
اختلف في المغضوب عليهم و الضالين من هم ؟ فالجمهور أن المغضوب عليهم اليهود ، والضالين النصارى ; وجاء ذلك مفسرا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم وقصة إسلامه ، أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ، والترمذي في جامعه . وشهد لهذا التفسير أيضا قوله سبحانه في اليهود : وباءوا بغضب من الله . وقال : وغضب الله عليهم وقال في النصارى : قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل . وقيل : المغضوب عليهم المشركون . و الضالين المنافقون .
وقيل : المغضوب عليهم هو من أسقط فرض هذه السورة في الصلاة ; و الضالين عن بركة قراءتها . حكاه السلمي في حقائقه والماوردي في تفسيره ; وليس بشيء . قال الماوردي : وهذا وجه مردود ، لأن ما تعارضت فيه الأخبار وتقابلت فيه الآثار وانتشر فيه الخلاف ، لم يجز أن يطلق عليه هذا الحكم . وقيل : المغضوب عليهم باتباع البدع ; و الضالين عن سنن الهدى .
قلت : وهذا حسن ; وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأعلى وأحسن . و ( عليهم ) في موضع رفع ، لأن المعنى غضب عليهم . والغضب في اللغة الشدة . ورجل غضوب أي شديد الخلق . والغضوب : الحية الخبيثة لشدتها . والغضبة : الدرقة من جلد البعير يطوى بعضها على بعض ; سميت بذلك لشدتها . ومعنى الغضب في صفة الله تعالى إرادة العقوبة ، فهو صفة ذات ، وإرادة الله تعالى من صفات ذاته ; أو نفس العقوبة ، ومنه الحديث : إن الصدقة لتطفئ غضب الرب فهو صفة فعل .
ولا الضالين الضلال في كلام العرب هو الذهاب عن سنن القصد وطريق الحق ; ومنه : ضل اللبن في الماء أي غاب . ومنه : أئذا ضللنا في الأرض أي غبنا بالموت وصرنا ترابا ; قال :
ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين ساروا
والضلضلة : حجر أملس يردده الماء في الوادي . وكذلك الغضبة : صخرة في الجبل مخالفة لونه ، قال : أو غضبة في هضبة ما أمنعا
قرأ عمر بن الخطاب وأبي بن كعب ˝ غير المغضوب عليهم وغير الضالين ˝ وروي عنهما في الراء النصب والخفض في الحرفين ; فالخفض على البدل من ( الذين ) أو من الهاء والميم في ( عليهم ) ; أو صفة للذين والذين معرفة ولا توصف المعارف بالنكرات ولا النكرات بالمعارف ، إلا أن الذين ليس بمقصود قصدهم فهو عام ; فالكلام بمنزلة قولك : إني لأمر بمثلك فأكرمه ; أو لأن ( غير ) تعرفت لكونها بين شيئين لا وسط بينهما ، كما تقول : الحي غير الميت ، والساكن غير المتحرك ، والقائم غير القاعد ، قولان : الأول للفارسي ، والثاني للزمخشري . والنصب في الراء على وجهين : على الحال من الذين ، أو من الهاء والميم في عليهم ، كأنك قلت : أنعمت عليهم لا مغضوبا عليهم . أو على الاستثناء ، كأنك قلت : إلا المغضوب عليهم . ويجوز النصب بأعني ; وحكي عن الخليل .
( لا ) في قوله ولا الضالين اختلف فيها ، فقيل هي زائدة ; قاله الطبري . ومنه قوله تعالى : ما منعك ألا تسجد . وقيل : هي تأكيد دخلت لئلا يتوهم أن الضالين معطوف على الذين ، حكاه مكي والمهدوي . وقال الكوفيون : ˝ لا ˝ بمعنى غير ، وهي قراءة عمر وأبي ; وقد تقدم .
الأصل في الضالين : الضاللين حذفت حركة اللام الأولى ثم أدغمت اللام في اللام فاجتمع ساكنان مدة الألف واللام المدغمة . وقرأ أيوب السختياني : ولا الضألين بهمزة غير ممدودة ; كأنه فر من التقاء الساكنين وهي لغة . حكى أبو زيد قال : سمعت عمرو بن عبيد يقرأ : ˝ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جأن ˝ فظننته قد لحن حتى سمعت من العرب : دأبة وشأبة . قال أبو الفتح : وعلى هذه اللغة قول كثير :
إذا ما العوالي بالعبيط احمأرت
نجز تفسير سورة الحمد ; ولله الحمد والمنة. ❝
⏤ عبدالعزيز بن داخل المطيري