❞ روز اليوسف ❝ 💬 اقتباسات من الكتب 📖
- روز اليوسف 💬 اقتباسات من الكتب 📖
█ حصريا تحميل كتاب مجاناً PDF اونلاين 2024
إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
اقتباسات في ❞روز اليوسف❝
-
-
❞ في يونيو 1982 سافرت في رحلة طويلة إلى الولايات المتحدة. لم تكن الرحلة بحثًا عن الذَّرَّة لكنها كانت بحثًا عن البشر والحياة في دولة عظمى تُعاملنا على طريقة «لعبة الأمم» وتَعدّ رجال مخابراتها وجنرالاتها وجواسيسها أفضل خبراء في «الزواج المثالي» بينها وبين العالم الثالث. لكن لأن الموضوع الذي لا يحسمه الصحفي يصبح مثل شوكة في بطنه ومثل خنجر في ضلوعه ومثل زائدة دودية ملتهبة، فقد وجدت نفسي أشمشم بأنفي عمّا أريد في معهد دراسات الشرق الأوسط، ومعهد الدراسات السياسية والاستراتيجية في واشنطن –العاصمة- وقدمتْ لي مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الإسلام سستر كوفي، نصائح وأبحاثًا، من الإنصاف أن أذكر أنها كانت مفيدة وربما أكثر من ذلك. وبعيدًا عن كل تعصب وطني، وقومي، أقول إن الباحثين هم الوجه العاقل في أمريكا، لكن الكارثة أنه لا أحد يسمع صوتهم إلا بعد فوات الأوان، إن لهم حرية التفكير، وللمسؤولين عن السياسة الخارجية حرية الاشمئناط وحرية ارتكاب الحماقات. وقد تضاعف اقتناعي بذلك في لوس أنجلوس، بعد أن زرت مركز أبحاث الأمن والسلاح التابع لجامعة كاليفورنيا، وحصلت من رئيسه رومان كلوكوفيسكي، على مجموعة الأبحاث التي نشرها المركز عن الخيار النووي الإسرائيلي، وحقيقة التورط الأمريكي في برنامج القنبلة الذَّرية الإسرائيلية، وطبيعة التعاون النووي بين إسرائيل وجنوب إفريقيا. وقبل أن أعود إلى القاهرة، كان في نيويورك من الأصدقاء، من وعد بموافاتي بالكتب الجديدة التي ستصدر بعد سفري، لكن يبدو أن بُعد المسافة حرَّر البعض مما التزم، على أن ما أرسله البعض الآخر غطّى وفاض. باريس، لندن، شرم الشيخ، فيينا، واشنطن، لوس أنجلوس... مشوار طويل استغرق سنوات، ولست أحاول استعراضه من باب ابتزاز المشاعر أو من باب التأثير على القارئ كي يغفر أيَّ تقصير قد يلمسه في الكتاب. أبدًا... فهذا أبعد ما يكون عن تفكيري وعن تفكير أي كاتب يتصور نفسه عاقلًا، فالمهم الكتاب نفسه لا ما وراءه. لكن أقصد من ذلك –إلى جانب المعايشة بين الكاتب والقارئ- أكثر من حقيقة: 1- أن مصادر معلوماتنا عن القضايا التي تهمنا لا تتوافر –للأسف- إلا خارج الحدود دائمًا، ومن ثَمَّ فإننا آخر من يعلم. 2- أن جهد الحصول على المعلومات من الخارج يتضاءل –مهما كان- أمام جهد تنقيتها من شوائب مغرضة، مقصود أن تصل إلينا –على هذا النحو- لتعلق بأذهاننا ولا تتركها. 3- أن الذين يعرفون الحقيقة في بلادنا، يسيطر عليهم هاجس السرَّية مع أن المطلوب منهم تصحيح أو تأكيد أو نفي ما يُنشر عنَّا ويباع في المكتبات، وأكشاك التبغ والصحف، وعلى أرصفة العواصم الغربية. 4- أن خوفًا ما من عقاب غير معروف يشعر به أي شخص، ولو كان عاديًّا، تذهب إليه لتسأله في أي شيء، ولو كان بسيطًا، عن حياة إنسان آخر. وقد واجهني هذا الخَرَس الممزوج بالقلق وأنا أسأل زملاء وتلاميذ الدكتور المشد –في قسم الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية- عنه وعن عمله وعن حياته، فقد أحسوا بأنهم على حافة بحر بلا قرار تسبح فيه أسماك القرش، والذين تجرؤوا منهم وقَبِلوا الكلام تحدثوا –في أفضل الأحوال- بنصف لسان وفتحوا عبارات لم يكملوها مع أنهم أساتذة وعلماء ويعرفون أنه لا حقيقة من دون لسان قوي سليم النطق. ومن ثَمَّ لم أصدق أن تقبل زوجة الدكتور المشد استقبالي والحديث معي بصراحة قالت من خلالها كل ما عندها. إنها سيدة شجاعة بطبعها كما أنها –بعد مصرع زوجها- لم تعد تخشى إلا الله وضميرها، وقد تعجبتْ من حماسي للكتابة عن رجل قُتل في مدينة صاخبة لم يتذكره الناس في بلاده، وقالت وهي تجاهد في حبس دموعها «الليل له آخر». كان ذلك في الإسكندرية، آخر مدينة سافرت إليها بحثًا عن التفاصيل في الشتاء الماضي، وقد وجدت نفسي أمام بحرها الأبعد بكثير من مرمى البصر والأمواج تتلاطم على سطحه، وفي رأسي: لماذا جريت طويلًا وراء هذه القضية؟ هل الدافع خبطة صحفية أصوغها بدماء الضحية؟ هل هو الغيظ الدفين من عدو يصرّ على إذلالنا، وكل ما نفعله هو أن نداري شحوبنا بالمكياج وأضواء الكاميرات، وعناوين الصحف الكاذبة؟ هل قضية اغتيال المشد هي المدخل لقضية أكبر وأخطر؛ قضية اغتيالنا جميعًا بقنبلة إسرائيل النووية؟ تكسّرت أمواج البحر ولم تنكسر أمواج الحيرة في رأسي. في الإسكندرية أيضًا وعلى بُعد أمتار من شاطئ «العجمي» مددت أكثر من جسر للحوار مع رجل جريء يوصف بالأب الروحي لعلماء الذَّرَّة في عالمنا العربي وكان على علاقة علمية وعائلية بالدكتور يحيى المشد، هو الدكتور عصمت زين الدين. كانت الشمس قد استدارت وتحولت إلى قرص أحمر يمسّ زُرقة البحر وتستعد للنوم في أحضانه، وعلى الرمال بقايا ثرثرة ومرح ومشاعر ساخنة تركها أصحابها ولم يسع للتخلص منها عمال الشاطئ. لكن هذا المشهد الناعم سرعان ما أصبح خلف ظهري وأنا أضع كل اهتمامي في خدمة الدكتور زين الدين وهو يمزج ما بين الغضب والأرقام وما بين السياسة والذَّرَّة، ولم يقطع تدفقه سوى حرصه على تأدية صلاة المغرب. وقد ذهبت إليه لأنني أعرف أنه كان أستاذ الدكتور المشد، ومؤسس قسم الهندسة النووية، وأنه كان من القلائل الذين كلّفهم الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر بوضع برنامج طَموح للسلاح النووي مع أنه كان معارضًا للحكم منذ سنة 1968 ولا يزال. وبعد أن تشبعت وقبل أن أنصرف ألقيتُ نظرة خاطفة على البحر فأحسست بالانقباض، فقد تحول من الفيروز إلى ثياب الرهبان وراحت أمواجه تتكسر على الشاطئ الناعم في لحن جنائزي حزين مخيف، فكان أن سارعت بالبحث عمّا تبقى من التفاصيل. وقد كنت أجمع هذه التفاصيل كأنها فراشات نادرة حرفًا حرفًا، كلمةً كلمةً، جملةً جملةً، وحاولت قدر استطاعتي دعمها بالصور أحيانًا وبالوثائق أحيانًا أخرى ونسبتها إلى مصادرها دائمًا، وليس من الصعب –بعد ما فات- تحديد نوعية هذه المصادر. ولا شك في أن هذه المصادر أتاحت لي كميات هائلة من المعلومات، كان من السهل فرزها وتبويبها في ثلاثة اتجاهات، يستقل كل منها بذاته، لكنه يتلامس ويتقاطع ويتداخل مع غيره في النهاية. اتجاه أول: يقودنا إلى حياة بطل الكتاب الدكتور يحيى المشد؛ طفولته، دراساته، أبحاثه، أسرته، أهميته، أيامه وساعاته الأخيرة ونهايته، كيف ولماذا قُتل؟ مَن قتله؟ والأدلة الجنائية والسياسية على ذلك! اتجاه ثانٍ: يلقي بنا في طريق القنبلة الذَّرية الإسرائيلية، مَن تحمس لها ودافع عنها؟ مَن صمَّمَها وكان وراءها؟ كيف صُنعت بعيدًا عن عيون العالم؟ ولماذا؟ وكم عدد الموجود منها الآن في «قبو» أو «بدروم» المؤسسة العسكرية الإسرائيلية؟ اتجاه ثالث: يفرض علينا الخوض في مستنقعات المحظور والسير في طريق وعر، طريق البرامج النووية العربية كيف كانت؟ كيف ستصبح؟ هل هي ضرورية؟ لماذا لا تتقدم؟ وما المؤامرات التي فجّرتها؟ ومَن الضحايا الذين استُشهدوا في سبيلها؟ لقد كان حادث اغتيال المشد مثل حجر أُلقي في بحر ساكن راكد ما إن اخترق المياه حتى راحت الدوائر تتسع وتتسع وتتسع. ومع أن فرز المعلومات الخاصة بكل اتجاه كان يسيرًا لا مشكلات فيه فإن تشابكها كان زمرًا لا مفر منه عند صياغة الكتاب. فلا يمكن فصل حادث المشد عن حادث المفاعل العراقي. ولا يمكن فصل حادث المفاعل العراقي عن حوادث الرسائل الملغومة التي أرسلتها المخابرات الإسرائيلية للعلماء الألمان في مصر في الستينيات. ولا يمكن فصل تلك الحوادث عن إصرار إسرائيل على أن تكون القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط. إنها خيوط غزل مختلفة الألوان لكنها تدخل في نسيج واحد. لذلك... سيلحظ القارئ أن فصول الكتاب تعكس هذا النسيج من خلال أسلوب، يُعرف في عالم السينما بالقطع المتوازي، وهو أشبه بقضبان السكة الحديدية، لا تلتقي إلا لتفترق ولا تفترق إلا لتلتقي مع أنها تبدو متوازية متباعدة أحيانًا. وقد ترددت كثيرًا في استخدام هذا الأسلوب الذي يؤخِّر تواصل الحدث قليلًا ويفتح بابًا قبل أن يسدَّ آخر. وسرُّ ترددي، كان الخوف من عدم تقبله ربما لأنه غير معتاد في الكتب السياسية ومن النادر اللجوء إليه في الروايات الأدبية. لكنني حسمت ترددي، وفضلت استعماله مستندًا على ظهر صلب هو فطنة القارئ وتقبله للجديد دائمًا. وبعد أن انتهيت من الكتابة على هذا النحو سعيت إلى اختبار التجربة بنشر الكتاب على حلقات في مجلة «روزاليوسف» القاهرية وصحيفة «الأنباء» الكويتية خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، وأحمد الله على أن ظني لم يخب. أيضًا، تراوح رد الفعل بين الحماس لإنصاف عالِمٍ لم يمشِ سوى أسرته في جنازته، والتأييد لكل من يمسح التراب عن الذاكرة القومية ولا يكفّ عن ترديد أن إسرائيل لا تزال عدوًّا وأنها لن تقبلنا على سطح الحياة في الشرق الأوسط إلا راكعين أذلّاء ضعفاء ومتخلفين. لقد انقلبت الآية تمامًا. كانت إسرائيل تحلم بالوجود، ثم أصبحت تتمنى أن تحظى بالاعتراف، ثم ها هي ذي تحدِّد من يكون ومن لا يكون. وما أسعدني أكثر أن الأجيال الصغيرة الشابة هي التي كانت الأسرع والأشد فهمًا لذلك. وقد فرحوا بأن تنجب مصر نجومًا في العلم أيضًا، لا في الفن فقط، وفرحت مثلهم لأن الناس تعاملت مع ما كتبت، وما نشرتُ عن د.المشد، معاملة نجوم السينما والكرة واستعراضات التليفزيون، وقد تعمدتُ ذلك، فالصور التي حصلت عليها من أسرته وأصدقائه، أفرطت في نشرها: صوره في مراحل العمل المختلفة من الطفولة إلى الجامعة، ومن أيام البعثة في موسكو، إلى أيام العمل في المفاعلات النووية، ومن زمن الشباب إلى زمن الأسرة، وبعض الصور كان جادًّا في مؤتمرات الذَّرَّة الدولية في هيئة الطاقة النووية بأنشاص، وفي زيارات عمل للندن وأوسلو، والبعض الآخر كان نادرًا، في النيل يمارس رياضة التجديف، وفي غابات موسكو يلعب الكرة، وفي المطاعم يأكل مع زوجته. ولو كان الهدف إنصاف عالم عبقري أعطى لوطنه الأصغر ولوطنه الأكبر أكثر مما أخذ، فقد نجح الكتاب. فقبل نشر أجزاء منه في الصحافة كان الدكتور المشد غير معروف إلا لجيرانه وتلاميذه وزملائه والمهتمين بالذَّرَّة، وبعض المثقفين من مختلف التخصصات، وكان ذكر اسمه يقترن دائمًا –من باب التعريف الإجباري- بعبارة «عالم الذَّرَّة المصري الذي قُتل في باريس»، فموته –على هذا النحو- كان عنصر شهرته الوحيد. وأحمد الله أن اسمه الآن يُذكر دون إضافة أو تعريف، يكفي الآن أن نقول د.يحيى المشد أو د.المشد. ولو كان الهدف التحذير من ضياع علماء مصر والتخلص منهم بواسطة أجهزة المخابرات السرية -المعادية، فأحسب أن هذا الهدف قد تحقق هو الآخر. فقبل أن تُنهي «روزاليوسف» الأجزاء التي اتفقت عليها، وقع حادث عالم الإلكترونيات سعيد السيد بدير (ابن الفنان والسيناريست السيد بدير من أولى زوجاته) في حي كامب شيزار بالإسكندرية نحو الساعة السابعة من مساء الخميس 13 يوليو 1989 وكان ذلك اليوم أول أيام عيد الأضحى. قيل إنه انتحر، ونفت زوجته وأصرّت على أنه قُتل، وكان أن سعت اجتهادات صحفية متنوعة للتدليل على أن «الموساد» تخلص منه. وكان أن كثر الحديث عن اغتيال العلماء بدايةً من سميرة موسى ونهايةً بسعيد بدير، وفي تلك الرحلة كان اسم المشد حاضرًا بارزًا. كذلك، فإن ما نُشر كان أشبه بشِبَاك الصيد، فقد طرق بابي مَن أضاف الكثير من المعلومات والوثائق. كما أن الذين سبق وتكلموا أحسوا بمزيد من الثقة فكان أن أباحوا بما أخفوه من قبل. ولأن الشكر واجب فأنا مدين به لعدد كبير من البشر لولاهم ما كان هذا الكتاب، ومنهم أخص السيدة زنوبة علي الخشخاني زوجة الدكتور يحيى المشد، والدكتور عصمت زين الدين، والصحفي الأمريكي ستيفن جرين، والدكتور عبد المنعم سعيد الخبير بمركز الدراسات الاستراتيجية بمؤسسة «الأهرام»، والصحفية الفلسطينية أسماد الأفغاني، والأستاذ المترجم صبحي مشرقي، والدكتور رومان كلوكوفيسكي، والبروفيسور سيجفريد آرنيه كلود، رئيس وكالة الطاقة الذَّرية الأسبق.. ❝ ⏤عادل حمودة❞ في يونيو 1982 سافرت في رحلة طويلة إلى الولايات المتحدة.
لم تكن الرحلة بحثًا عن الذَّرَّة لكنها كانت بحثًا عن البشر والحياة في دولة عظمى تُعاملنا على طريقة «لعبة الأمم» وتَعدّ رجال مخابراتها وجنرالاتها وجواسيسها أفضل خبراء في «الزواج المثالي» بينها وبين العالم الثالث.
لكن لأن الموضوع الذي لا يحسمه الصحفي يصبح مثل شوكة في بطنه ومثل خنجر في ضلوعه ومثل زائدة دودية ملتهبة، فقد وجدت نفسي أشمشم بأنفي عمّا أريد في معهد دراسات الشرق الأوسط، ومعهد الدراسات السياسية والاستراتيجية في واشنطن –العاصمة- وقدمتْ لي مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الإسلام سستر كوفي، نصائح وأبحاثًا، من الإنصاف أن أذكر أنها كانت مفيدة وربما أكثر من ذلك.
وبعيدًا عن كل تعصب وطني، وقومي، أقول إن الباحثين هم الوجه العاقل في أمريكا، لكن الكارثة أنه لا أحد يسمع صوتهم إلا بعد فوات الأوان، إن لهم حرية التفكير، وللمسؤولين عن السياسة الخارجية حرية الاشمئناط وحرية ارتكاب الحماقات.
وقد تضاعف اقتناعي بذلك في لوس أنجلوس، بعد أن زرت مركز أبحاث الأمن والسلاح التابع لجامعة كاليفورنيا، وحصلت من رئيسه رومان كلوكوفيسكي، على مجموعة الأبحاث التي نشرها المركز عن الخيار النووي الإسرائيلي، وحقيقة التورط الأمريكي في برنامج القنبلة الذَّرية الإسرائيلية، وطبيعة التعاون النووي بين إسرائيل وجنوب إفريقيا.
وقبل أن أعود إلى القاهرة، كان في نيويورك من الأصدقاء، من وعد بموافاتي بالكتب الجديدة التي ستصدر بعد سفري، لكن يبدو أن بُعد المسافة حرَّر البعض مما التزم، على أن ما أرسله البعض الآخر غطّى وفاض.
باريس، لندن، شرم الشيخ، فيينا، واشنطن، لوس أنجلوس.. مشوار طويل استغرق سنوات، ولست أحاول استعراضه من باب ابتزاز المشاعر أو من باب التأثير على القارئ كي يغفر أيَّ تقصير قد يلمسه في الكتاب.
أبدًا..
فهذا أبعد ما يكون عن تفكيري وعن تفكير أي كاتب يتصور نفسه عاقلًا، فالمهم الكتاب نفسه لا ما وراءه.
لكن أقصد من ذلك –إلى جانب المعايشة بين الكاتب والقارئ- أكثر من حقيقة:
1- أن مصادر معلوماتنا عن القضايا التي تهمنا لا تتوافر –للأسف- إلا خارج الحدود دائمًا، ومن ثَمَّ فإننا آخر من يعلم.
2- أن جهد الحصول على المعلومات من الخارج يتضاءل –مهما كان- أمام جهد تنقيتها من شوائب مغرضة، مقصود أن تصل إلينا –على هذا النحو- لتعلق بأذهاننا ولا تتركها.
3- أن الذين يعرفون الحقيقة في بلادنا، يسيطر عليهم هاجس السرَّية مع أن المطلوب منهم تصحيح أو تأكيد أو نفي ما يُنشر عنَّا ويباع في المكتبات، وأكشاك التبغ والصحف، وعلى أرصفة العواصم الغربية.
4- أن خوفًا ما من عقاب غير معروف يشعر به أي شخص، ولو كان عاديًّا، تذهب إليه لتسأله في أي شيء، ولو كان بسيطًا، عن حياة إنسان آخر.
وقد واجهني هذا الخَرَس الممزوج بالقلق وأنا أسأل زملاء وتلاميذ الدكتور المشد –في قسم الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية- عنه وعن عمله وعن حياته، فقد أحسوا بأنهم على حافة بحر بلا قرار تسبح فيه أسماك القرش، والذين تجرؤوا منهم وقَبِلوا الكلام تحدثوا –في أفضل الأحوال- بنصف لسان وفتحوا عبارات لم يكملوها مع أنهم أساتذة وعلماء ويعرفون أنه لا حقيقة من دون لسان قوي سليم النطق.
ومن ثَمَّ لم أصدق أن تقبل زوجة الدكتور المشد استقبالي والحديث معي بصراحة قالت من خلالها كل ما عندها.
إنها سيدة شجاعة بطبعها كما أنها –بعد مصرع زوجها- لم تعد تخشى إلا الله وضميرها، وقد تعجبتْ من حماسي للكتابة عن رجل قُتل في مدينة صاخبة لم يتذكره الناس في بلاده، وقالت وهي تجاهد في حبس دموعها «الليل له آخر».
كان ذلك في الإسكندرية، آخر مدينة سافرت إليها بحثًا عن التفاصيل في الشتاء الماضي، وقد وجدت نفسي أمام بحرها الأبعد بكثير من مرمى البصر والأمواج تتلاطم على سطحه، وفي رأسي: لماذا جريت طويلًا وراء هذه القضية؟ هل الدافع خبطة صحفية أصوغها بدماء الضحية؟ هل هو الغيظ الدفين من عدو يصرّ على إذلالنا، وكل ما نفعله هو أن نداري شحوبنا بالمكياج وأضواء الكاميرات، وعناوين الصحف الكاذبة؟ هل قضية اغتيال المشد هي المدخل لقضية أكبر وأخطر؛ قضية اغتيالنا جميعًا بقنبلة إسرائيل النووية؟
تكسّرت أمواج البحر ولم تنكسر أمواج الحيرة في رأسي.
في الإسكندرية أيضًا وعلى بُعد أمتار من شاطئ «العجمي» مددت أكثر من جسر للحوار مع رجل جريء يوصف بالأب الروحي لعلماء الذَّرَّة في عالمنا العربي وكان على علاقة علمية وعائلية بالدكتور يحيى المشد، هو الدكتور عصمت زين الدين.
كانت الشمس قد استدارت وتحولت إلى قرص أحمر يمسّ زُرقة البحر وتستعد للنوم في أحضانه، وعلى الرمال بقايا ثرثرة ومرح ومشاعر ساخنة تركها أصحابها ولم يسع للتخلص منها عمال الشاطئ.
لكن هذا المشهد الناعم سرعان ما أصبح خلف ظهري وأنا أضع كل اهتمامي في خدمة الدكتور زين الدين وهو يمزج ما بين الغضب والأرقام وما بين السياسة والذَّرَّة، ولم يقطع تدفقه سوى حرصه على تأدية صلاة المغرب.
وقد ذهبت إليه لأنني أعرف أنه كان أستاذ الدكتور المشد، ومؤسس قسم الهندسة النووية، وأنه كان من القلائل الذين كلّفهم الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر بوضع برنامج طَموح للسلاح النووي مع أنه كان معارضًا للحكم منذ سنة 1968 ولا يزال.
وبعد أن تشبعت وقبل أن أنصرف ألقيتُ نظرة خاطفة على البحر فأحسست بالانقباض، فقد تحول من الفيروز إلى ثياب الرهبان وراحت أمواجه تتكسر على الشاطئ الناعم في لحن جنائزي حزين مخيف، فكان أن سارعت بالبحث عمّا تبقى من التفاصيل.
وقد كنت أجمع هذه التفاصيل كأنها فراشات نادرة حرفًا حرفًا، كلمةً كلمةً، جملةً جملةً، وحاولت قدر استطاعتي دعمها بالصور أحيانًا وبالوثائق أحيانًا أخرى ونسبتها إلى مصادرها دائمًا، وليس من الصعب –بعد ما فات- تحديد نوعية هذه المصادر.
ولا شك في أن هذه المصادر أتاحت لي كميات هائلة من المعلومات، كان من السهل فرزها وتبويبها في ثلاثة اتجاهات، يستقل كل منها بذاته، لكنه يتلامس ويتقاطع ويتداخل مع غيره في النهاية.
اتجاه أول: يقودنا إلى حياة بطل الكتاب الدكتور يحيى المشد؛ طفولته، دراساته، أبحاثه، أسرته، أهميته، أيامه وساعاته الأخيرة ونهايته، كيف ولماذا قُتل؟ مَن قتله؟ والأدلة الجنائية والسياسية على ذلك!
اتجاه ثانٍ: يلقي بنا في طريق القنبلة الذَّرية الإسرائيلية، مَن تحمس لها ودافع عنها؟ مَن صمَّمَها وكان وراءها؟ كيف صُنعت بعيدًا عن عيون العالم؟ ولماذا؟ وكم عدد الموجود منها الآن في «قبو» أو «بدروم» المؤسسة العسكرية الإسرائيلية؟
اتجاه ثالث: يفرض علينا الخوض في مستنقعات المحظور والسير في طريق وعر، طريق البرامج النووية العربية كيف كانت؟ كيف ستصبح؟ هل هي ضرورية؟ لماذا لا تتقدم؟ وما المؤامرات التي فجّرتها؟ ومَن الضحايا الذين استُشهدوا في سبيلها؟
لقد كان حادث اغتيال المشد مثل حجر أُلقي في بحر ساكن راكد ما إن اخترق المياه حتى راحت الدوائر تتسع وتتسع وتتسع.
ومع أن فرز المعلومات الخاصة بكل اتجاه كان يسيرًا لا مشكلات فيه فإن تشابكها كان زمرًا لا مفر منه عند صياغة الكتاب.
فلا يمكن فصل حادث المشد عن حادث المفاعل العراقي.
ولا يمكن فصل حادث المفاعل العراقي عن حوادث الرسائل الملغومة التي أرسلتها المخابرات الإسرائيلية للعلماء الألمان في مصر في الستينيات.
ولا يمكن فصل تلك الحوادث عن إصرار إسرائيل على أن تكون القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط.
إنها خيوط غزل مختلفة الألوان لكنها تدخل في نسيج واحد.
لذلك..
سيلحظ القارئ أن فصول الكتاب تعكس هذا النسيج من خلال أسلوب، يُعرف في عالم السينما بالقطع المتوازي، وهو أشبه بقضبان السكة الحديدية، لا تلتقي إلا لتفترق ولا تفترق إلا لتلتقي مع أنها تبدو متوازية متباعدة أحيانًا.
وقد ترددت كثيرًا في استخدام هذا الأسلوب الذي يؤخِّر تواصل الحدث قليلًا ويفتح بابًا قبل أن يسدَّ آخر.
وسرُّ ترددي، كان الخوف من عدم تقبله ربما لأنه غير معتاد في الكتب السياسية ومن النادر اللجوء إليه في الروايات الأدبية.
لكنني حسمت ترددي، وفضلت استعماله مستندًا على ظهر صلب هو فطنة القارئ وتقبله للجديد دائمًا.
وبعد أن انتهيت من الكتابة على هذا النحو سعيت إلى اختبار التجربة بنشر الكتاب على حلقات في مجلة «روزاليوسف» القاهرية وصحيفة «الأنباء» الكويتية خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، وأحمد الله على أن ظني لم يخب.
أيضًا، تراوح رد الفعل بين الحماس لإنصاف عالِمٍ لم يمشِ سوى أسرته في جنازته، والتأييد لكل من يمسح التراب عن الذاكرة القومية ولا يكفّ عن ترديد أن إسرائيل لا تزال عدوًّا وأنها لن تقبلنا على سطح الحياة في الشرق الأوسط إلا راكعين أذلّاء ضعفاء ومتخلفين.
لقد انقلبت الآية تمامًا.
كانت إسرائيل تحلم بالوجود، ثم أصبحت تتمنى أن تحظى بالاعتراف، ثم ها هي ذي تحدِّد من يكون ومن لا يكون.
وما أسعدني أكثر أن الأجيال الصغيرة الشابة هي التي كانت الأسرع والأشد فهمًا لذلك.
وقد فرحوا بأن تنجب مصر نجومًا في العلم أيضًا، لا في الفن فقط، وفرحت مثلهم لأن الناس تعاملت مع ما كتبت، وما نشرتُ عن د.المشد، معاملة نجوم السينما والكرة واستعراضات التليفزيون، وقد تعمدتُ ذلك، فالصور التي حصلت عليها من أسرته وأصدقائه، أفرطت في نشرها: صوره في مراحل العمل المختلفة من الطفولة إلى الجامعة، ومن أيام البعثة في موسكو، إلى أيام العمل في المفاعلات النووية، ومن زمن الشباب إلى زمن الأسرة، وبعض الصور كان جادًّا في مؤتمرات الذَّرَّة الدولية في هيئة الطاقة النووية بأنشاص، وفي زيارات عمل للندن وأوسلو، والبعض الآخر كان نادرًا، في النيل يمارس رياضة التجديف، وفي غابات موسكو يلعب الكرة، وفي المطاعم يأكل مع زوجته.
ولو كان الهدف إنصاف عالم عبقري أعطى لوطنه الأصغر ولوطنه الأكبر أكثر مما أخذ، فقد نجح الكتاب.
فقبل نشر أجزاء منه في الصحافة كان الدكتور المشد غير معروف إلا لجيرانه وتلاميذه وزملائه والمهتمين بالذَّرَّة، وبعض المثقفين من مختلف التخصصات، وكان ذكر اسمه يقترن دائمًا –من باب التعريف الإجباري- بعبارة «عالم الذَّرَّة المصري الذي قُتل في باريس»، فموته –على هذا النحو- كان عنصر شهرته الوحيد.
وأحمد الله أن اسمه الآن يُذكر دون إضافة أو تعريف، يكفي الآن أن نقول د.يحيى المشد أو د.المشد.
ولو كان الهدف التحذير من ضياع علماء مصر والتخلص منهم بواسطة أجهزة المخابرات السرية -المعادية، فأحسب أن هذا الهدف قد تحقق هو الآخر.
فقبل أن تُنهي «روزاليوسف» الأجزاء التي اتفقت عليها، وقع حادث عالم الإلكترونيات سعيد السيد بدير (ابن الفنان والسيناريست السيد بدير من أولى زوجاته) في حي كامب شيزار بالإسكندرية نحو الساعة السابعة من مساء الخميس 13 يوليو 1989 وكان ذلك اليوم أول أيام عيد الأضحى.
قيل إنه انتحر، ونفت زوجته وأصرّت على أنه قُتل، وكان أن سعت اجتهادات صحفية متنوعة للتدليل على أن «الموساد» تخلص منه.
وكان أن كثر الحديث عن اغتيال العلماء بدايةً من سميرة موسى ونهايةً بسعيد بدير، وفي تلك الرحلة كان اسم المشد حاضرًا بارزًا.
كذلك، فإن ما نُشر كان أشبه بشِبَاك الصيد، فقد طرق بابي مَن أضاف الكثير من المعلومات والوثائق.
كما أن الذين سبق وتكلموا أحسوا بمزيد من الثقة فكان أن أباحوا بما أخفوه من قبل.
ولأن الشكر واجب فأنا مدين به لعدد كبير من البشر لولاهم ما كان هذا الكتاب، ومنهم أخص السيدة زنوبة علي الخشخاني زوجة الدكتور يحيى المشد، والدكتور عصمت زين الدين، والصحفي الأمريكي ستيفن جرين، والدكتور عبد المنعم سعيد الخبير بمركز الدراسات الاستراتيجية بمؤسسة «الأهرام»، والصحفية الفلسطينية أسماد الأفغاني، والأستاذ المترجم صبحي مشرقي، والدكتور رومان كلوكوفيسكي، والبروفيسور سيجفريد آرنيه كلود، رئيس وكالة الطاقة الذَّرية الأسبق. ❝
⏤ عادل حمودة



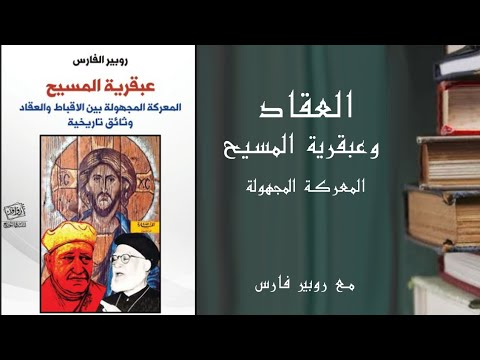 العقاد وعبقرية المسيح - والمعارك المجهولة - ارنست وليم
العقاد وعبقرية المسيح - والمعارك المجهولة - ارنست وليم

