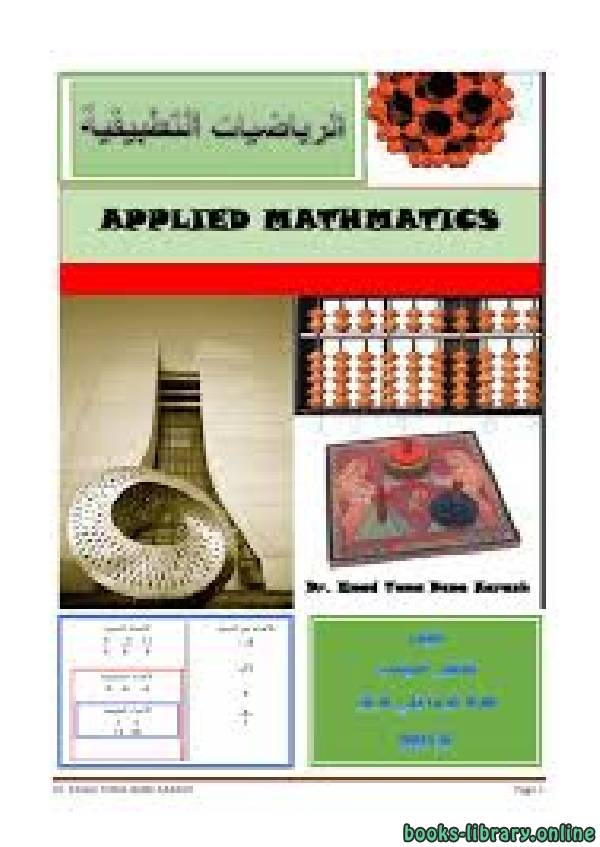❞ تفاضل ❝ 💬 اقتباسات من الكتب 📖
- تفاضل 💬 اقتباسات من الكتب 📖
█ حصريا تحميل كتاب مجاناً PDF اونلاين 2025
إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
اقتباسات في ❞تفاضل❝
-
-
❞ أكثر الذين عبدوا الله و زعموا أنهم يعبدونه واحداً جعلوا له شركاء .. أكثرهم فعلوا هذا من حيث يدرون أو من حيث لا يدرون .. أخناتون الذي بلغ القمة في التوحيد ، عاد فجعل من نفسه إبناً للإله فقال في نشيده مخاطباً ربه ، إنك في قلبي. و ليس هناك من يعرفك غير ابنك الذي وُلد من صُلبك ، ملكُ مِصْر السفلىٰ و العليا ، الذي يحيا في الحق ، سيد الأرضين أخناتون . لقد وقع برغم بصيرته الشفافه في هذا الإفك القديم و ظن نفسه إبنا لله من صلبه ، و في فارس تصوره الذين عبدوا إلهين اثنين .. (هرمز و اهرمن ) : أحدهما إلهاً للخير و الآخر للشر " و في الهند ثالوثاً "براهما و فشنوا و شيفا" و من تحت الثالوث عددوا كثرة من صغار الأرباب وصلت إلى ثلاثمائة و ثلاثين مليوناً من الآلهة ، بعدد ما ظنوا من حيوانات و دواب و مخلوقات تحل فيها أرواح تلك الآلهة .. و في اليونان عبدوا زيوس كبير الأرباب ثم جعلوا لهذا الكبير عصابة بعدد ما تصوروا من قوى الطبيعة . و عبد اليهود الرب " يهوا " إلهاً واحداً ثم جعلوا من النبي عزيرا ابناً له مخالفين بذلك ما علمهم موسى من وحدانية الخالق .. و جاء عيسى بالتوحيد فاختلف من بعده الأتباع و جعلوا من المسيح ابناً و جعلوا الحقيقة الإلهية الواحدة ثالوثاً .. ثم جاء الإسلام بختام الكلمة في التوحيد فالله أحدٌ صمد لا صاحبة و لا ولد ، ليس له ند و لا ضد و لا مثيل و لا شبيه ، لا يتحيز في مكان و لا يتزمن في زمان ، و لا يتحدد في كم ، و لا يتمثل في مقدار ، و لا يتقيد في إطار ، و لا تحيط به صورة و لا يتجسد في جسد ، ليس من هذا العالم ، بل هو فوقه و متعالٍ عليه ؛ فهو في الإطلاق و هذا العالم في القيد ، و هو في كلمة بسيطة بليغة .. أحدٌ .. أحد .. ليس كمثله شئ . واعتقد المسلمون بهذا التوحيد بواقع الشهادة التي يُقرّونها خمس مرات كل يوم و في كل أذان ، أنه لا إله إلا الله .. و أن الله أكبر من كل شيء مطلقاً .. و لكن الكثرة الغالبة منهم عادت فوقعت في ألوان جديدة من الشرك الخفي ، و بات أكثر توحيد المسلمين باللسان بأن الله أكبر .. على حين أن سلوك هذه الكثرة و مشاعرها يقول إن الدنيا أكبر ، و تحصيل المال أكبر ، و حيازة القصور و الضياع أكبر ، و الفوز برضا المرأه أكبر و التقرب للسلطة أكبر ، و هوى النفس أكبر . الكثرة تقول لا نعبد إلا الله و لا نخاف إلا الله ، و لكن سلوكها يقول إنها تخاف الموت و الفقر و المرض و الميكروب و الفيروس و الشيخوخة أكثر ، و كأنما هذه الأشياء لها سلطة الضرر بذواتها .. الكثرة تطلب الشفاء من يدي الطبيب و تلتمس الدواء و يقع الواحد منهم في يأس لأنه لم يجد الحقن المستوردة كذا أو المضاد الحيوي كذا و ينسى أن الله من وراء الأسباب ، و أنه هو الذي أودع صفات الشفاء في هذا المضاد أو هذه الحقنة و أنه هو الذي قدر البرء على يد هذا الجراح .. و أنه هو الذي خلق الفيروس و الميكروب و البكتريا ، و أنه الذي نشرها و أرسلها و أنه هو الذي أقام حواجز المناعة في أجسامنا ، و أنه إن شاء هدم هذه المناعة ، و إن شاء أعانها و أنه خالق الحر و البرد و الصقيع ، و أنه الذي وضع خاصية التغذية فالغذاء ، و الإرواء في الماء ، و خاصية القتل في السم ، و خاصية النفع في الترياق .. ' لا شئ له سلطة النفع بذاته ..و لا شئ له سلطة الضرر بذاته' و إنما هو الله الضار النافع و ما عدا ذلك أسباب أقامها الله لتعمل بمشيئته ، و التوحيد الصحيح أن نخافه هو ، لأنه لا شئ يستطيع أن يضرنا بدون مشيئته ، و أن نطمع فيه وحده لأنه لا شئ يستطيع أن ينفعنا بدون إذنه ، إنه وحده الذي يعمل طوال الوقت - بالرغم من كثرة الأيدي التي تبدو في الصورة - ألم يقل للمقاتلين في بدر : قال تعالى : (( فلم تقتلوهم و لكن الله قتلهم و ما رميت إذ رميت و لكن الله رمى )) مع أن الظاهر أنهم هم الذين قتلوا المشركين .. و أن النبي عليه الصلاة و السلام هو الذي رمى . هذا هو الظاهر .. و لكن الحقيقة أنها أدوار اختار الله أبطالها منذ الأزل .. اختار للشر نفوساً و عرف أنها لا تصلح إلا للشر بحكم ما أخفته في سرها .. و لهذا اختار إبليس للغواية .. لأنه علم فيه الكِبر .. و اختار محمداً عليه الصلاة و السلام للهداية لما عَلِمَ فيه من مودة و رحمة .. و هكذا وزع الأدوار بحكم استحقاقات علمها أزلاً .. ثم أعان كل واحد على ما يصلح له .. أعان المضل على الضلال و أعان الهادى على الهدى .. قال تعالى : (( كلاً نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربك و ما كان عطاء ربك محظوراً )) قال تعالى : (( فأما من أعطى و أتقى ، و صدق بالحسنى ، فسنيسرهُ لليسرى ، و أما من بخل و استغنى ، و كذّب بالحسنى ، فسنيسرهُ للعسرى )) من طلب المعونة على جريمة أعانه عليها و عليه وزر احتياره ، و من طلب المعونة على خير أعانه عليه و له ثواب اخياره . و إنما دور كل منا هو توجيه طاقته . و لكن الله - سبحانه و تعالى - هو صاحب الطاقة الكلية و لا يمكن إنفاذ فعل بدونه فهو الوكيل القائم على إنقاذ جميع الأفعال ، و هو اليد الفاعلة و إنما دور القاتل أنه أضمر القتل و اختاره و فكر فيه و عزم عليه و هذا هو إسهامه الذي سيُحاسب عليه .. أما إنفاذ جميع الأفعال فالله منفرد بها و لهذا قال لمحاربي بدر : (( فلم تقتلوهم و لكن الله قتلهم )) و هذا هو المعنى الحقيقي للتوحيد أن الله هو الفاعل الوحيد .. و أنه إذا كانت لنا أعمال فهي سرائرنا و نياتنا و ما نعزم عليه و ما نوجه إليه طاقتنا و ما نبادر إليه ، لهذا قال الله عن نفسه إنه يضل من يشاء و يهدي من يشاء . قال تعالى (( و من يضلل الله فما له من هاد )) (( و من يضلل الله فلن تجد له سبيلاً )) و لكنه شاء سبحانه وتعالى أن يطمئنا فقال : (( و يضل الله الظالمين )) (( كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب )) (( كذلك يضل الله الكٰفرين )) ' فجعل الفعل الإلهي قائما على استحقاق . و هذا يجعل من الدنيا كلها تحصيل حاصل لاستحقاقات أزلية استحقتها نفوس الخلائق بحكم منازلها التي تفاضلت بها أزلاً .. و إنما أراد الله أن نخرج ما نكتم في قلوبنا فخلق هذه الدنيا ليشهد كل منا على نفسه : قال تعالى :(( و الله مخرجٌ ما تكتمون ))' قال تعالى : { إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ} [التوبة : 64] و هذا يعني أن هذه الدنيا هي الفصل الثاني من رواية ، و إنه كان هناك فصل سابق عشناه و لا نذكر عنه شيئاً . و إننا بحكم ما قدمناه في هذا الفصل السالف استحققنا ما نجد الآن من خير و شر .. و أن ما يجد كلٍ منا في حياته هو أشبه بكشف النقاب عما يكتم و عما يخفي في ذات نفسه . و الله يعلم حقيقتنا منذ القدم ، و يعلم عنا كل شئ ، و لكنه أراد أن نعلم عن أنفسنا بعض ما يعلم عنا فخلق لنا الدنيا لنرى أنفسنا في أعمالنا . و ليس هناك قولاً بتناسخ فأنا لا أؤمن بالتناسخ الذي يتكلم عنه الهنود ، و لا في تقمص الأرواح الذي يعتقد فيه الدروز.. و لا أظن أن الفصل الأول من هذه الرواية كان على هذه الأرض و لا أنه كان تقمصاً سابقاً لحياة بشرية .. ' إنما هو أمر من أمور الغيب لا يعلمه إلا الله و هو ماضٍ محجوب لن يُهتك عنه الستر إلا يوم يبعث الله من في القبور و يحصل ما في الصدور . يومئذٍ تنكشف الأسرار و يعرف المجرمون أنفسهم على حقيقتها فيقولون معترفين : {قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ} [غافر : 11] و لا خروج .. فهل يستطيع الإنسان أن يخرج من نفسه أو يتبرأ إنسان من يديه " هيهات " .. و يسأل سائل .. لمن الملك اليوم ؟ و تجيب السماوات و الأرض و الملائكة و كل الخلق .. لله الواحد القهار ، و هو أمر ليس بجديد .. فالملك كان لله دائما في ذلك اليوم و في كل يوم ..'' و لكن ظاهر الدنيا يخدع كل من يراه " .. كان يبدو أن لبعض الناس مُلكاً ، و كان يبدو أن الطبيب يشفي و أن السلطان يرزق ، و أن السم يُميت و أن الرصاصة تقتل ، و أن هذا ينفع و أن ذاك يضر ، و أن هناك جبارين غير الله يحكمون . و نسينا ما وصف الله به نفسه بأنه : قال تعالى : {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [الحديد : 3] فإذا كان الطبيب يشفي ، و السلطان يرزق ، و السم يُميت ، و الرصاصة تقتل ، فإن الله هو الظاهر في كل هذه المظاهر و هو الفعل الخالص فيها .. و ما يجري على جميع الأيدي هو الوجه المنظور للمشيئة في تلك اللحظة .. سبحانه كل يوم هو في شأن .. و تلك شؤونه .. و إذا كنا رأينا جبارين من غير الله يحكمون فما حكموا في الحقيقة إلا به .. و إنما تجلى الاسم الجبار على نفوسهم لأن تلك النفوس لم تكن لتقبل بحكم استعدادها الأزلي إلا هذا النوع من التجلي .. لم تكن تصلح لأن يتجلى عليها الودود و لا الرحيم و لا الرءوف .. لم تكن تقبل التجليات الجمالية للأسماء الحليم و الكريم و المنان و اللطيف .. فنحن ما زلنا مع الله لم يظهر فينا غيره .. هو الظاهر في كل شئ بأفعاله و أسمائه .. و لكن من وراء ستار الأسباب ومن خلف نقاب الكثرة . و برغم هذه الكثرة فإنه لا إله إلا الله.. لا فعال سواه ، و لا شافٍ و لا رازق و لا نافع و لا ضار و لا مميت و لا جبار و لا مهيمن غيره .. إنها ذاته الواحدة الفاعلة أبداً و أزلاً .. ألا تبدو الطاقة الكهربائية في كل مصباح بشكل مختلف حسب نوع الفتيل المعدني داخله ..!؟ ألا تبدو الكهرباء في مصابيح النيون بألوان و تألقات متفاوتة حسب نوع الغازات في تلك الأنابيب المفرغة.. ؟! ' ما أشبهها جميعاً بنفوسنا التي تختلف استعداداتها فتختلف أفعالها مع أن الفاعل فيها واحد .. مجرد مثال .' "و الدنيا كلها مثال رامز للقدره قدرة الواحد الأحد الذي ليس كمثله شئ و إذا رأيت هذا الواحد من وراء الكثرة و إذا أنت لم تعبأ بهذه الكثرة و شعرت بنفسك تتعامل طول الوقت وجهاً لوجه مع الله فلم تر شافياً لك غيره برغم تعاطيك الدواء و استسلامك للجراح ، و إذا رأيته هو الذي يطعمك و يسقيك و شعرت بنفسك تأكل من يديه و تشرب من يديه برغم كثرة المشارب و المطاعم التي تتردد عليها ، و إذا نسيت نفسك و لم تر غيره فأنت المسلم الموحد على وجه التحقيق " وإنما يأتي فساد الأعمال من تصور الواحد منا أنه يأتيها وحده .. كما تصور قارون أنه صاحب العلم و صاحب المال و صاحب الفضل و قال مختالاً و هو يتحدث عن ماله و جاهه قال تعالى : {قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ} [القصص : 78] فلم ير غير نفسه و لم يشهد غير علمه الذاتي و نسي أنه لا يملك علماً ذاتياً و لا قدرة ذاتية ، و إنما قدرته وعلمه و ذكاؤه كانت هبات سيده و هذا هو الشرك الخفي .. حينما يصبح إله الواحد نفسه و هواه و ملكاته .. قال تعالى : {أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاىٰهُ} [الجاثية : 23] ولهذا يتبرأ العارفون عن أعمالهم الصالحة و يسندوها إلى الله و إلى توفيقه .' و أكثر من هذا يتبرأ الواحد من إرادته الخيرة و من نياته الطيبة و يرى أنها من أفضال سيده .. ثم يتبرأ من نفسه التي بين جنبيه و ينسى ذاته .. و يشهد أنه لا يملك من نفسه إلا العدم و أن كل ماله من الله ..و لا يعود يختار و إنما الله يختار له في كل لحظة .. ثم لا يعود يشهد إلا الله في كل شئ .. فذلك هو التوحيد الكامل .. وهذه هي لا إله إلا الله حينما تصبح حياة .. و نرى في دعاء أبي الحسن الشاذلي في هذه الحالة من الوجد : رب خذني إليك مني و ارزقني الفناء عني ، و لا تجعلني مفتوناً بنفسي ، محجوباً بحسي ، ونقرأ في المواقف والمخاطبات للنفري ما يقوله الله للعبد العارف " ألق الاختيار ألق المسألة البتة " . فثواب مثل ذلك التوحيد الكامل الذي يلقي فيه العبد باختياره و يأخذ باختيار الله في كل شيء هو المغفرة الكاملة و عدم المحاسبة، يقول الله في حديثه القدسي إلى المذنب : لو جئتني بملء قراب الأرض خطايا و لقيتني لا تشرك بي شيئاً لوجدت عندي ملء قراب الأرض مغفرة . فتلك ثمرة التوحيد ، و هذا ثواب كلمة لا إله إلا الله ، إذا جعلها الواحد منا حياته و نبضه و سلوكه و تنفسه و ذوب قلبه، وهذا ما أراده القرآن الكريم بإسلام الوجه لله سبحانه و تعالى ، و هذا ما أراده رسولنا العظيم محمد عليه الصلاة و السلام، حينما سأله أحدهم أن يوجز الدين الذي تلقاه عن ربه في كلمتين .. فقال كلمته الجامعه : ' قل آمنت بالله ثم استقم ' .. و هذه هي الملة الحنيفية ملة أبينا إبراهيم الذي لم يعرف لنفسه إلهاً و لا خالقاً و لا رازقاً و لا شافياً و لا منقذاً إلا الله.. و الذي أُلقي به في النار فظهر له جبريل يسأله حاجته .. فقال له النبي العارف الموحد ، أما لك فلا .. إنه في ساعة الخوف و الهول و الفزع لا يسأل أحداً إلا ربه .. لأنه لا يرى أحداً يملك له شيئاً و لو كان كبير الملائكه الروح القدس نفسه .. فلا فاعل في الكون إلا الله.. و لا يملك أحد أن ينفع أو يضر إلا بإذنه .. و تلك مرتبة عرفانية لا يصل إليها إلا نبي .. و هذا معنى التوحيد .. مقال : كلمة التوحيد .. ماذا تعني من كتاب : الإسلام ما هو ؟ للدكتور / مصطفي محمود (رحمه الله). ❝ ⏤مصطفى محمود❞ أكثر الذين عبدوا الله و زعموا أنهم يعبدونه واحداً جعلوا له شركاء . أكثرهم فعلوا هذا من حيث يدرون أو من حيث لا يدرون . أخناتون الذي بلغ القمة في التوحيد ، عاد فجعل من نفسه إبناً للإله فقال في نشيده مخاطباً ربه ، إنك في قلبي. و ليس هناك من يعرفك غير ابنك الذي وُلد من صُلبك ، ملكُ مِصْر السفلىٰ و العليا ، الذي يحيا في الحق ، سيد الأرضين أخناتون .
لقد وقع برغم بصيرته الشفافه في هذا الإفك القديم و ظن نفسه إبنا لله من صلبه ، و في فارس تصوره الذين عبدوا إلهين اثنين . (هرمز و اهرمن ) : أحدهما إلهاً للخير و الآخر للشر ˝ و في الهند ثالوثاً ˝براهما و فشنوا و شيفا˝ و من تحت الثالوث عددوا كثرة من صغار الأرباب وصلت إلى ثلاثمائة و ثلاثين مليوناً من الآلهة ، بعدد ما ظنوا من حيوانات و دواب و مخلوقات تحل فيها أرواح تلك الآلهة .
و في اليونان عبدوا زيوس كبير الأرباب ثم جعلوا لهذا الكبير عصابة بعدد ما تصوروا من قوى الطبيعة .
و عبد اليهود الرب ˝ يهوا ˝ إلهاً واحداً ثم جعلوا من النبي عزيرا ابناً له مخالفين بذلك ما علمهم موسى من وحدانية الخالق .
و جاء عيسى بالتوحيد فاختلف من بعده الأتباع و جعلوا من المسيح ابناً و جعلوا الحقيقة الإلهية الواحدة ثالوثاً .
ثم جاء الإسلام بختام الكلمة في التوحيد فالله أحدٌ صمد لا صاحبة و لا ولد ، ليس له ند و لا ضد و لا مثيل و لا شبيه ، لا يتحيز في مكان و لا يتزمن في زمان ، و لا يتحدد في كم ، و لا يتمثل في مقدار ، و لا يتقيد في إطار ، و لا تحيط به صورة و لا يتجسد في جسد ، ليس من هذا العالم ، بل هو فوقه و متعالٍ عليه ؛ فهو في الإطلاق و هذا العالم في القيد ، و هو في كلمة بسيطة بليغة . أحدٌ . أحد . ليس كمثله شئ .
واعتقد المسلمون بهذا التوحيد بواقع الشهادة التي يُقرّونها خمس مرات كل يوم و في كل أذان ، أنه لا إله إلا الله . و أن الله أكبر من كل شيء مطلقاً . و لكن الكثرة الغالبة منهم عادت فوقعت في ألوان جديدة من الشرك الخفي ، و بات أكثر توحيد المسلمين باللسان بأن الله أكبر . على حين أن سلوك هذه الكثرة و مشاعرها يقول إن الدنيا أكبر ، و تحصيل المال أكبر ، و حيازة القصور و الضياع أكبر ، و الفوز برضا المرأه أكبر و التقرب للسلطة أكبر ، و هوى النفس أكبر .
الكثرة تقول لا نعبد إلا الله و لا نخاف إلا الله ، و لكن سلوكها يقول إنها تخاف الموت و الفقر و المرض و الميكروب و الفيروس و الشيخوخة أكثر ، و كأنما هذه الأشياء لها سلطة الضرر بذواتها .
الكثرة تطلب الشفاء من يدي الطبيب و تلتمس الدواء و يقع الواحد منهم في يأس لأنه لم يجد الحقن المستوردة كذا أو المضاد الحيوي كذا و ينسى أن الله من وراء الأسباب ، و أنه هو الذي أودع صفات الشفاء في هذا المضاد أو هذه الحقنة و أنه هو الذي قدر البرء على يد هذا الجراح .
و أنه هو الذي خلق الفيروس و الميكروب و البكتريا ، و أنه الذي نشرها و أرسلها و أنه هو الذي أقام حواجز المناعة في أجسامنا ، و أنه إن شاء هدم هذه المناعة ، و إن شاء أعانها و أنه خالق الحر و البرد و الصقيع ، و أنه الذي وضع خاصية التغذية فالغذاء ، و الإرواء في الماء ، و خاصية القتل في السم ، و خاصية النفع في الترياق .
' لا شئ له سلطة النفع بذاته .و لا شئ له سلطة الضرر بذاته'
و إنما هو الله الضار النافع و ما عدا ذلك أسباب أقامها الله لتعمل بمشيئته ، و التوحيد الصحيح أن نخافه هو ، لأنه لا شئ يستطيع أن يضرنا بدون مشيئته ، و أن نطمع فيه وحده لأنه لا شئ يستطيع أن ينفعنا بدون إذنه ، إنه وحده الذي يعمل طوال الوقت - بالرغم من كثرة الأيدي التي تبدو في الصورة - ألم يقل للمقاتلين في بدر :
قال تعالى :
(( فلم تقتلوهم و لكن الله قتلهم و ما رميت إذ رميت و لكن الله رمى ))
مع أن الظاهر أنهم هم الذين قتلوا المشركين . و أن النبي عليه الصلاة و السلام هو الذي رمى .
هذا هو الظاهر .
و لكن الحقيقة أنها أدوار اختار الله أبطالها منذ الأزل . اختار للشر نفوساً و عرف أنها لا تصلح إلا للشر بحكم ما أخفته في سرها . و لهذا اختار إبليس للغواية . لأنه علم فيه الكِبر . و اختار محمداً عليه الصلاة و السلام للهداية لما عَلِمَ فيه من مودة و رحمة . و هكذا وزع الأدوار بحكم استحقاقات علمها أزلاً . ثم أعان كل واحد على ما يصلح له . أعان المضل على الضلال و أعان الهادى على الهدى .
قال تعالى : (( كلاً نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربك و ما كان عطاء ربك محظوراً ))
قال تعالى : (( فأما من أعطى و أتقى ، و صدق بالحسنى ، فسنيسرهُ لليسرى ، و أما من بخل و استغنى ، و كذّب بالحسنى ، فسنيسرهُ للعسرى ))
من طلب المعونة على جريمة أعانه عليها و عليه وزر احتياره ، و من طلب المعونة على خير أعانه عليه و له ثواب اخياره . و إنما دور كل منا هو توجيه طاقته .
و لكن الله - سبحانه و تعالى - هو صاحب الطاقة الكلية و لا يمكن إنفاذ فعل بدونه فهو الوكيل القائم على إنقاذ جميع الأفعال ، و هو اليد الفاعلة و إنما دور القاتل أنه أضمر القتل و اختاره و فكر فيه و عزم عليه و هذا هو إسهامه الذي سيُحاسب عليه . أما إنفاذ جميع الأفعال فالله منفرد بها
و لهذا قال لمحاربي بدر :
(( فلم تقتلوهم و لكن الله قتلهم ))
و هذا هو المعنى الحقيقي للتوحيد أن الله هو الفاعل الوحيد . و أنه إذا كانت لنا أعمال فهي سرائرنا و نياتنا و ما نعزم عليه و ما نوجه إليه طاقتنا و ما نبادر إليه ، لهذا قال الله عن نفسه إنه يضل من يشاء و يهدي من يشاء .
قال تعالى (( و من يضلل الله فما له من هاد ))
(( و من يضلل الله فلن تجد له سبيلاً ))
و لكنه شاء سبحانه وتعالى أن يطمئنا فقال :
(( و يضل الله الظالمين ))
(( كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ))
(( كذلك يضل الله الكٰفرين ))
' فجعل الفعل الإلهي قائما على استحقاق . و هذا يجعل من الدنيا كلها تحصيل حاصل لاستحقاقات أزلية استحقتها نفوس الخلائق بحكم منازلها التي تفاضلت بها أزلاً .
و إنما أراد الله أن نخرج ما نكتم في قلوبنا فخلق هذه الدنيا ليشهد كل منا على نفسه :
قال تعالى :(( و الله مخرجٌ ما تكتمون ))'
قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ﴾ [التوبة : 64]
و هذا يعني أن هذه الدنيا هي الفصل الثاني من رواية ، و إنه كان هناك فصل سابق عشناه و لا نذكر عنه شيئاً . و إننا بحكم ما قدمناه في هذا الفصل السالف استحققنا ما نجد الآن من خير و شر . و أن ما يجد كلٍ منا في حياته هو أشبه بكشف النقاب عما يكتم و عما يخفي في ذات نفسه .
و الله يعلم حقيقتنا منذ القدم ، و يعلم عنا كل شئ ، و لكنه أراد أن نعلم عن أنفسنا بعض ما يعلم عنا فخلق لنا الدنيا لنرى أنفسنا في أعمالنا .
و ليس هناك قولاً بتناسخ فأنا لا أؤمن بالتناسخ الذي يتكلم عنه الهنود ، و لا في تقمص الأرواح الذي يعتقد فيه الدروز.
و لا أظن أن الفصل الأول من هذه الرواية كان على هذه الأرض و لا أنه كان تقمصاً سابقاً لحياة بشرية .
' إنما هو أمر من أمور الغيب لا يعلمه إلا الله و هو ماضٍ محجوب لن يُهتك عنه الستر إلا يوم يبعث الله من في القبور و يحصل ما في الصدور .
يومئذٍ تنكشف الأسرار و يعرف المجرمون أنفسهم على حقيقتها فيقولون معترفين :
﴿قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ﴾ [غافر : 11]
و لا خروج . فهل يستطيع الإنسان أن يخرج من نفسه أو يتبرأ إنسان من يديه ˝ هيهات ˝ .
و يسأل سائل . لمن الملك اليوم ؟
و تجيب السماوات و الأرض و الملائكة و كل الخلق . لله الواحد القهار ، و هو أمر ليس بجديد . فالملك كان لله دائما في ذلك اليوم و في كل يوم .'' و لكن ظاهر الدنيا يخدع كل من يراه ˝ . كان يبدو أن لبعض الناس مُلكاً ، و كان يبدو أن الطبيب يشفي و أن السلطان يرزق ، و أن السم يُميت و أن الرصاصة تقتل ، و أن هذا ينفع و أن ذاك يضر ، و أن هناك جبارين غير الله يحكمون .
و نسينا ما وصف الله به نفسه بأنه :
قال تعالى : ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الحديد : 3]
فإذا كان الطبيب يشفي ، و السلطان يرزق ، و السم يُميت ، و الرصاصة تقتل ، فإن الله هو الظاهر في كل هذه المظاهر و هو الفعل الخالص فيها . و ما يجري على جميع الأيدي هو الوجه المنظور للمشيئة في تلك اللحظة . سبحانه كل يوم هو في شأن . و تلك شؤونه .
و إذا كنا رأينا جبارين من غير الله يحكمون فما حكموا في الحقيقة إلا به . و إنما تجلى الاسم الجبار على نفوسهم لأن تلك النفوس لم تكن لتقبل بحكم استعدادها الأزلي إلا هذا النوع من التجلي . لم تكن تصلح لأن يتجلى عليها الودود و لا الرحيم و لا الرءوف . لم تكن تقبل التجليات الجمالية للأسماء الحليم و الكريم و المنان و اللطيف .
فنحن ما زلنا مع الله لم يظهر فينا غيره . هو الظاهر في كل شئ بأفعاله و أسمائه . و لكن من وراء ستار الأسباب ومن خلف نقاب الكثرة .
و برغم هذه الكثرة فإنه لا إله إلا الله. لا فعال سواه ، و لا شافٍ و لا رازق و لا نافع و لا ضار و لا مميت و لا جبار و لا مهيمن غيره . إنها ذاته الواحدة الفاعلة أبداً و أزلاً .
ألا تبدو الطاقة الكهربائية في كل مصباح بشكل مختلف حسب نوع الفتيل المعدني داخله .!؟
ألا تبدو الكهرباء في مصابيح النيون بألوان و تألقات متفاوتة حسب نوع الغازات في تلك الأنابيب المفرغة. ؟!
' ما أشبهها جميعاً بنفوسنا التي تختلف استعداداتها فتختلف أفعالها مع أن الفاعل فيها واحد . مجرد مثال .'
˝و الدنيا كلها مثال رامز للقدره قدرة الواحد الأحد الذي ليس كمثله شئ و إذا رأيت هذا الواحد من وراء الكثرة و إذا أنت لم تعبأ بهذه الكثرة و شعرت بنفسك تتعامل طول الوقت وجهاً لوجه مع الله فلم تر شافياً لك غيره برغم تعاطيك الدواء و استسلامك للجراح ، و إذا رأيته هو الذي يطعمك و يسقيك و شعرت بنفسك تأكل من يديه و تشرب من يديه برغم كثرة المشارب و المطاعم التي تتردد عليها ، و إذا نسيت نفسك و لم تر غيره فأنت المسلم الموحد على وجه التحقيق ˝
وإنما يأتي فساد الأعمال من تصور الواحد منا أنه يأتيها وحده . كما تصور قارون أنه صاحب العلم و صاحب المال و صاحب الفضل و قال مختالاً و هو يتحدث عن ماله و جاهه قال تعالى :
﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ [القصص : 78]
فلم ير غير نفسه و لم يشهد غير علمه الذاتي و نسي أنه لا يملك علماً ذاتياً و لا قدرة ذاتية ، و إنما قدرته وعلمه و ذكاؤه كانت هبات سيده و هذا هو الشرك الخفي .
حينما يصبح إله الواحد نفسه و هواه و ملكاته .
قال تعالى :
﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاىٰهُ﴾ [الجاثية : 23]
ولهذا يتبرأ العارفون عن أعمالهم الصالحة و يسندوها إلى الله و إلى توفيقه .'
و أكثر من هذا يتبرأ الواحد من إرادته الخيرة و من نياته الطيبة و يرى أنها من أفضال سيده . ثم يتبرأ من نفسه التي بين جنبيه و ينسى ذاته . و يشهد أنه لا يملك من نفسه إلا العدم و أن كل ماله من الله .و لا يعود يختار و إنما الله يختار له في كل لحظة . ثم لا يعود يشهد إلا الله في كل شئ . فذلك هو التوحيد الكامل .
وهذه هي لا إله إلا الله حينما تصبح حياة .
و نرى في دعاء أبي الحسن الشاذلي في هذه الحالة من الوجد : رب خذني إليك مني و ارزقني الفناء عني ، و لا تجعلني مفتوناً بنفسي ، محجوباً بحسي ، ونقرأ في المواقف والمخاطبات للنفري ما يقوله الله للعبد العارف ˝ ألق الاختيار ألق المسألة البتة ˝ .
فثواب مثل ذلك التوحيد الكامل الذي يلقي فيه العبد باختياره و يأخذ باختيار الله في كل شيء هو المغفرة الكاملة و عدم المحاسبة، يقول الله في حديثه القدسي إلى المذنب : لو جئتني بملء قراب الأرض خطايا و لقيتني لا تشرك بي شيئاً لوجدت عندي ملء قراب الأرض مغفرة .
فتلك ثمرة التوحيد ، و هذا ثواب كلمة لا إله إلا الله ، إذا جعلها الواحد منا حياته و نبضه و سلوكه و تنفسه و ذوب قلبه، وهذا ما أراده القرآن الكريم بإسلام الوجه لله سبحانه و تعالى ، و هذا ما أراده رسولنا العظيم محمد عليه الصلاة و السلام، حينما سأله أحدهم أن يوجز الدين الذي تلقاه عن ربه في كلمتين . فقال كلمته الجامعه : ' قل آمنت بالله ثم استقم ' .
و هذه هي الملة الحنيفية ملة أبينا إبراهيم الذي لم يعرف لنفسه إلهاً و لا خالقاً و لا رازقاً و لا شافياً و لا منقذاً إلا الله. و الذي أُلقي به في النار فظهر له جبريل يسأله حاجته . فقال له النبي العارف الموحد ، أما لك فلا .
إنه في ساعة الخوف و الهول و الفزع لا يسأل أحداً إلا ربه . لأنه لا يرى أحداً يملك له شيئاً و لو كان كبير الملائكه الروح القدس نفسه . فلا فاعل في الكون إلا الله.
و لا يملك أحد أن ينفع أو يضر إلا بإذنه .
و تلك مرتبة عرفانية لا يصل إليها إلا نبي .
و هذا معنى التوحيد .
مقال : كلمة التوحيد . ماذا تعني
من كتاب : الإسلام ما هو ؟
للدكتور / مصطفي محمود (رحمه الله). ❝
⏤ مصطفى محمود -
❞ أما الدنيا فليس فيها نعيم ولا جحيم إلا بحكم الظاهر فقط، بينما فى الحقيقة تتساوى الكؤوس التى يتجرعها الكل...والكل فى تعب. إنما الدنيا امتحان لإبراز المواقف...فما اختلفت النفوس إلا بمواقفها وما تفاضلت إلا بمواقفها. كتاب: أناشيد الإثم والبراءة.. ❝ ⏤مصطفى محمود❞ أما الدنيا فليس فيها نعيم ولا جحيم إلا بحكم الظاهر فقط، بينما فى الحقيقة تتساوى الكؤوس التى يتجرعها الكل..والكل فى تعب.
إنما الدنيا امتحان لإبراز المواقف..فما اختلفت النفوس إلا بمواقفها وما تفاضلت إلا بمواقفها.
كتاب: أناشيد الإثم والبراءة. ❝
⏤ مصطفى محمود -
❞ المثقفون لهم اعتراض تقليدي على مسألة البعث والعقاب .. فهم يقولون : كيف يعذبنا الله والله محبة ؟ وينسى الواحد منهم أنه قد يحب ابنه كل الحب ومع ذلك يعاقبه بالضرب والحرمان من المصروف والتأديب والتعنيف .. وكلما ازداد حبه لابنه كلما ازداد اهتمامه بتأديبه .. ولو أنه تهاون في تربيته لاتّهمه الناس في حبه لابنه ولقالوا عنه إنه أب مهمل لا يرعى أبناءه الرعاية الكافية .. فما بال الرب وهو المربي الأعظم .. وكلمة الرب مشتقة من التربية . والواقع أن عبارة (( الله محبة )) عبارة فضفاضة يسيء الكثيرون فهمها ويُحمِّلونها معنى مطلقًا .. ويتصورون أن الله محبة على الإطلاق .. وهذا غير صحيح . فهل الله يحب الظلم مثلاً ؟! مستحيل .. مستحيل أن يحب الله الظلم والظالمين .. وأن يستوي في نظره ظالم ومظلوم .. وهذا التصور للقوة الإلهية .. هو فوضى فكرية .. ويلزم فعلًا أن يكون لله العلو المطلق على كل الظالمين , وأن يكون جبارًا مطلقًا يملك الجبروت على كل الجبارين .. وأن يكون متكبرًا على المتكبرين مُذِلًّا للمُذِلين قويًا على جميع الأقوياء .. وأن يكون الحَكم العدل الذي يضع كل إنسان في رتبته ومقامه . وبمقتضى ما نرى حولنا من انضباط القوانين في المادة والفضاء والسماوات يكون استنتاجنا للعدل الإلهي استنتاجًا سليمًا يعطي الصفة لموصوفها .. وكل البيِّنات تحت أيدينا تقوم لتؤكد صفة العدل الإلهي والنظام والحكمة والتدبير . والذين ينكرون النظام والعدل هم الذين يحتاجون إلى إقامة البرهان وإلى تقديم الدليل على إنكارهم .. وليس الذين يؤمنون بالنظام . أما الذين ينكرون العذاب على إطلاقه وينكرون أن الإنسان مربوب تعلو عليه قوة أعلى منه وقوانين أعلى منه ندعوهم إلى نظرة في أحوال عالَمَهم الأرضي .. نظرة في الدنيا دون حاجة إلى افتراض آخره . ولا أحد لم يجرب ألم الضرس الذي يخرق الدماغ ويشق الرأس كالمنشار . والمغص الكلوي والصداع الشقي وألم الغضروف وسل العظام وهي ألوان من الجحيم يعرفها من أَلقى به سوء حظه إلى تجربتها . وزيارة لعنبر المحروقين في القصر العيني سوف تقنع المشاهد بأن هناك فارقًا كبيرًا بين رجل محروق مشوه يصرخ في الضمادات , وبين حال رجل يرشف فنجان شاي في استرخاء ولذة على شاطئ النيل وإلى جواره حسناء تلاطفه . إن العذاب حقيقة ملموسة . والإنسان مربوب بقوة أعلى منه وهو عديم الحيلة في قبضة تلك القوة . ويستوي الأمر أن يسمي المؤمن هذه القوة .. (( الله )) وأن يسميها الملحد (( الطبيعة )) أو (( القوانين الطبيعية )) أو (( قانون القوانين )) فما هذه إلا سفسطة لفظية .. المهم أنه لم يجد بدّاً من الإعتراف بأن هناك قوة تعلو على الإنسان وعلى الحوادث .. وأن هذه القوة تعذب وتنكل . وأصحاب المشاعر الرقيقة الذين يتأففون من تصور الله جبارًا معذِبًا .. علينا أن نذكِّرَهم بما كان يفعله الخليفة التركي حينما يصدر حكم الإعدام بالخازوق على أعدائه .. وما كان يفعله الجلاد المنوط به تنفيذ الحكم حينما كان يلقي بالضحية على بطنه ثم يدخل في الشرج خازوقاً ذا رأس حديدية مدببة يظل يُدَق ببطء حتى تتهتك جميع الأحشاء ويخرج الخازوق من الرقبة .. وكيف أنه كان من واجب الجلاد أن يحتفظ بضحيته حيّاً حتى يخرج الخازوق من رقبته ليشعر بجميع الآلام الضرورية . وأفظع من ذلك أن تفقأ عيون الأسرى بالأسياخ المحمية في النار . مثل هؤلاء الجبارين هل من المفروض أن يقدم لهم الله حفلة شاي لأن الله محبة ؟! بل إن جهنم هي منتهى المحبة ما دامت لا توجد وسيلة غيرها لتعريف هؤلاء بأن هناك إلهًا عادلًا . وهي رحمة من حيث كونها تعريفًا وتعليمًا لمن رفض أن يتعلم من جميع الكتب والرسل , وللذين كذَّبوا حتى أوَّليات العقل وبداهات الإنسانية . أيكون عدلًا أن يقتل هتلر عشرين مليونًا في حرب عالمية .. يسلخ فيها عماله الأسرى ويعدمون الألوف منهم في غرف الغاز ويحرقونهم في المحارق .. ثم عند الهزيمة ينتحر هتلر هاربًا وفارّاً من مواجهة نتيجة أعماله . إن العبث وحده وأن يكون العالَم عبثًا في عبث هو الذي يمكن أن ينجي هذا القاتل الشامل من ذنبه . ولا شيء حولنا في هذا العالَم المنضبط الجميل يدل على العبث .. وكل شيء من أكبر النجوم إلى أدق الذرّات ينطق بالنظام والضبط والإحكام . ولا يكون الله محبة .. ولا يكون عادلاً .. إلا إذا وضع هذا الرجل في هاوية أعماله . عن العاقل الفطن المتأمل لن يحتاج إلى فلسفة ليدرك حقيقة العذاب فإنه سوف يكتشف نذر هذا العذاب في نفسه داخل ضميره .. وفي عيون المذنبين ونظرات القتلة .. وفي دموع المظلومين وآلام المكلومين وفي ذل الأسرى وجبروت المنتصرين وفي حشرجة المحتضرين . وهو سوف يدرك العذاب والحساب حينما يحتويه الندم . والندم هو صوت الفطرة لحظة الخطأ . وهو القيامة الصغرى والجحيم الأصغر وهو نموذج من الدينونة . وهو إشارة الخطر التي تضيء في داخل النفس لتدل على أن هناك ميزانًا للأعمال .. وأن هناك حقّاً وباطلًا .. ومَن كان على الحق فهو على صراط وقلبه مطمئن .. ومن كان على باطل فهو في هاوية الندم وقلبه كليم . وعذاب الدنيا دائمًا نوع من التقويم .. وكذلك على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمم .. فهزيمة 67 في سيناء كانت درسًا , كما أن رسوب الطالب يكون درسًا – كما أن آلام المرض واعتلال الصحة هي لمن عاش , حياة الإسراف والترف والرخاوة والمتعة درس . والعذاب يجلو صدأ النفس و يصقل معدنها . ولا نعرف نبيّاً أو مصلحًا أو فنانًا أو عبقريّاً إلا وقد ذاق أشد العذاب مرضًا أو فقرًا أو إضطهادًا . والعذاب من هذه الزاوية محبة .. وهو الضريبة التي يلزم دفعها للإنتقال إلى درجة أعلى . وإذا خفيت عنا الحكمة في العذاب أحيانًا فلأننا لا ندرك كل شيء ولا نعرف كل شيء من القصة إلا تلك الرحلة المحدودة بين قوسين التي إسمها الدنيا .. أما ما قبل ذلك وما بعد ذلك فهو بالنسبة لنا غيب محجوب , ولذا يجب أن نصمت في احترام ولا نطلق الأحكام . أما كيفيات العذاب بعد البعث فلا يمكن القطع فيها تفصيلًا لأن الآخرة كلها غيب .. ويمكن أن يكون ما ورد في الكتب المقدسة بهذا الشأن رموزًا وإشارات .. كما نقول للصبي الذي لم يدرك البلوغ حينما يسألنا عن اللذة الجنسية إنها مثل السكر أو العسل لأننا لا نجد في قاموس خبراته شيئًا غير ذلك .. ولأن تلك اللذة بالنسبة له غيب لا يمكن وصفه بكلمات من محصوله اللغوي فهي خبرة لم يجربها إطلاقًا , وبالمثل الجنة والجحيم هي خبرات بالنسبة لنا .. غيب .. ولا يمكن وصفها بكلمات من قاموسنا الدنيوي .. وكل ما يمكن هو إيراد أوصاف على سبيل التقريب مثل النار أو الحدائق الغناء التي تجري من تحتها الأنهار .. أما ما سوف يحدث فهو شيء يفوق بكثير كل هذه الأوصاف التقريبية مما لم تره عين ولم يخطر على قلب بشر . ويمكن أن يقال دون خطأ إن جهنم هي المقام الأسفل بكل ما يستتبع ذلك المقام من عذاب حسي ومعنوي .. وأن الجنة هي المقام الأعلى بكل ما يستتبع ذلك المقام من نعيم حسي ومعنوي . والصوفية يقولون إن جهنم هي مقام البعد ( البعد عن الله ) والحَجب عن الله .. والجنة هي مقام القرب بكل ما يتبع ذلك القرب من سعادة لا يمكن وصفها . (( و مَنْ كانَ في هَذِهِ أعمَْى فَهوَ في الآخرة أعْمى وأضَلُّ سبيلاً )) . والعمى هنا هو عمى البصيرة . إنها إذن أشبه بما نرى من درجات ومقامات وتفاوت بين أعمى وبصير . ومهتد وضال . ولكن في الآخرة سوف يكون التفاوت عظيمًا . (( انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا )) .. (الإسراء – 21) لدرجة أن من سيكون في المقام الأسفل سيكون حاله حال من في النار وأسوأ .. إنه قانون التفاضل الذي يحكم الوجود كله دنيا وآخره ملكًا وملكوتًا غيبًا وشهودًا . لكل واحد رتبة واستحقاق ومقام ودرجة .. ولا يستوي اثنان . ولا يكون الإنتقال من درجة إلى درجة إلا مقابل جهد وعمل واختبار وابتلاء .. ومن كان في الدنيا في أحط الدرجات من عمى البصيرة فسيكون حاله في الآخرة في أحط الدرجات أيضاً . وهذا عين العدل .. أن يوضع كل إنسان في مكانه ودرجته واستحقاقه .. وهذا ما يحدث في الدنيا ظلمًا وهو ما سوف يحدث في الآخرة عدلًا . والعذاب بهذا المعنى عدل . والثواب عدل . وكلاهما من مقتضيات الضرورة . أن يكون الحديد الصلب غاية في الصلابة فيصنع منه الموتور . ويكون الكاوتشوك رخوًا فتصنع منه العجلات . ويكون القش رخيصًا فتصنع منه رأس المكنسة . ويكون القش رخيصًا فتصنع منه رأس المكنسة . وأن يكون القطن الفاخر لصناعة الوسائد .. والقطن الرديء لتسليك البالوعات . وهذه بداهات وأوليات تقول بها الفطرة والمنطق السوي ولا تحتاج إلى تدبيج مقالات في الفلسفة ولا إلى رص حيثيات ومسببات . ولهذا كانت الأديان كلها مقولة فطرية .. لا تحتمل الجدل ولا تحتمل التكذيب .. ولهذا كانت حقيقة مطلقة تقبلها العقول السوية التي لم تفسدها لفلفات الفلسفة والسفسطة .. والتي احتفظت ببكارتها ونقاوتها وبرئَت من داء العناد والمكابرة . ولهذا يقول الصوفي إن الله لا يحتاج إلى دليل بل إن الله هو الدليل الذي يستدل به على كل شيء . هو الثابت الذي نعرف به المتغيرات . وهو الجوهر الذي ندرك به اختلاف الظواهر . وهو البرهان الذي ندرك به حكمة العالم الزائل . أما العقل الذي يطلب برهاناً على وجود الله فهو عقل فقد التعقل . فالنور يكشف لنا الأشياء ويدلنا عليها . ولا يمكن أن تكون الأشياء هي دليلنا على النور وإلا نكون قد قلبنا الأوضاع .. كمن يسير في ضوء النهار ثم يقول .. أين دليلك على أن الدنيا نهار .. أثبت لي بالبرهان . ومن فقد سلامة الفطرة وبكارة القلب .. ولم يبق له إلا الجدل وتلافيف المنطق وعلوم الكلام .. فقد فقدَ كل شيء وسوف يطول به المطاف .. ولن يصل أبداً . ومثل الذي يحتج على العذاب الدنيوي ويتبرم ويتسخط ويلعن الحياة وقول إنها حياة لا تحتمل وإنه يرفضها وإن أحداً لم يأخذ رأيه قبل أن يولد وإنه خلق قهراً وحكم عليه بالعذاب جبراً وإن هذا ظلم فادح . مثل هذا الرفض الساخط مثل الفنان الذي يؤدي دوراً في مسرحية .. ويقتضي الدور أن يتلقى الضرب والركل كل يوم أما المتفرجين . لو أن هذا الممثل فقد الذاكرة ولم ير شريط حياته إلا أمام هذا الدور الذي يؤديه بين قوسين على خشبة المسرح كل يوم .. فإنه سوف يحتج .. رافضاً أن يتلقى العذاب .. ويقول إن أحداً لم يأخذ رأيه وإنه خلق قهراً وحكم عليه بالعذاب جبراً وقضي عليه بالإهانة أمام الناس بدون مبرر معقول وبدون اختيار منه منذ البداية . وسوف ينسى هذا الممثل أنه كان هناك اتفاق قبل بدء الرواية .. وكان هناك تكليف من المخرج ثم قبول للتكليف من جانب الممثل .. ثم عهد وميثاق على تنفيذ المطلوب .. كل هذا تم في حرية قبل أن يبدأ العرض .. وارتضى الممثل دوره اختياراً .. بل إنه أحب دوره وسعى إليه . ولكن الممثل قد نسي تماماً هذه الحقبة الزمنية قبل الوقوف على خشبة المسرح .. ومن هنا تحولت حياته بما فيها من تكاليف وآلام إلى علامة استفهام ولغز غير مفهوم . وهذا شأن الإنسان الذي تصور أن كل حياته هي وجوده بالجسد في هذه اللحظات الدنيوية وأنه هالك ومصيره التراب . وأنه ليس له وجود غير هذا الوجود الثلاثي الأبعاد على خشبة الحياة الدنيا . نسي هذا الإنسان أنه كان روحاً في الملكوت وأنه جاء على الدنيا بتكليف وأنه قبل هذا التكليف وارتضاه .. وأنه كانت بينه وبين خالقه ( المخرج الأعظم لدراما الوجود ) عهود ومواثيق .. وأنه بعد دراما الوجود الدنيوي يكون البعث والحساب كما أنه بعد المسرحية يكون النقد من النقاد والنجاح والفشل من الجمهور والسقوط في عين النظارة أو الارتفاع في نظرهم . إنه النسيان والغفلة . والنظرة الضيقة المحدودة التي تتصور أن الدنيا كل شيء .. هي التي تؤدي إلى ضلال الفكر .. و هي التي تؤدي إلى الحيرة أمام العذاب والشر والألم ... ومن هنا جاءت تسمية القرآن بأنه .. ذكر .. وتذكير .. وتذكرة .. ليتذكر أولو الألباب . والنبي هو مذكر . (( فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ , لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ )) ( الغاشية 21 – 22 ) الدنيا كلها ليست كل القصة . إنها فصل في الرواية .. كان لها بدء قبل الميلاد وسيكون لها استمرار بعد الموت . وفي داخل هذه الرؤية الشاملة يصبح للعذاب معنى ... يصبح عذاب الدنيا رحمة من الرحيم الذي ينبهنا به حتى لا نغفل .. إنه محاولة إيقاظ لتتوتر الحواس ويتساءل العقل .. وهو تذكير دائم بأن الدنيا لن تكون ولا يمكن أن تكون جنة .. وإنها مجرد مرحلة .. وأن الإخلاد إلى ذاتها يؤدي بصاحبه إلى غفلة مهلكة . إنه العقاب الذي ظاهره العذاب وباطنه الرحمة . وأما عذاب الآخرة فهو الصحو على الحقيقة وعلى العدل المطلق الذي لا تفوته ذرة الخير ولا ذرة الشر .. وهو اليقين بنظام المنظم الذي أبدع كل شيء صنعًا . (( وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ )) واليقين هنا هو الموت وما وراءه . ~ مقال : لماذا العذاب من كتاب : رحلتي من الشك إلى الإيمان للدكتور : مصطفى محمود (رحمه الله). ❝ ⏤مصطفى محمود❞ المثقفون لهم اعتراض تقليدي على مسألة البعث والعقاب .
فهم يقولون : كيف يعذبنا الله والله محبة ؟
وينسى الواحد منهم أنه قد يحب ابنه كل الحب ومع ذلك يعاقبه بالضرب والحرمان من المصروف والتأديب والتعنيف . وكلما ازداد حبه لابنه كلما ازداد اهتمامه بتأديبه .
ولو أنه تهاون في تربيته لاتّهمه الناس في حبه لابنه ولقالوا عنه إنه أب مهمل لا يرعى أبناءه الرعاية الكافية . فما بال الرب وهو المربي الأعظم . وكلمة الرب مشتقة من التربية .
والواقع أن عبارة (( الله محبة )) عبارة فضفاضة يسيء الكثيرون فهمها ويُحمِّلونها معنى مطلقًا . ويتصورون أن الله محبة على الإطلاق . وهذا غير صحيح .
فهل الله يحب الظلم مثلاً ؟!
مستحيل .
مستحيل أن يحب الله الظلم والظالمين . وأن يستوي في نظره ظالم ومظلوم . وهذا التصور للقوة الإلهية . هو فوضى فكرية .
ويلزم فعلًا أن يكون لله العلو المطلق على كل الظالمين , وأن يكون جبارًا مطلقًا يملك الجبروت على كل الجبارين . وأن يكون متكبرًا على المتكبرين مُذِلًّا للمُذِلين قويًا على جميع الأقوياء . وأن يكون الحَكم العدل الذي يضع كل إنسان في رتبته ومقامه .
وبمقتضى ما نرى حولنا من انضباط القوانين في المادة والفضاء والسماوات يكون استنتاجنا للعدل الإلهي استنتاجًا سليمًا يعطي الصفة لموصوفها .
وكل البيِّنات تحت أيدينا تقوم لتؤكد صفة العدل الإلهي والنظام والحكمة والتدبير .
والذين ينكرون النظام والعدل هم الذين يحتاجون إلى إقامة البرهان وإلى تقديم الدليل على إنكارهم . وليس الذين يؤمنون بالنظام .
أما الذين ينكرون العذاب على إطلاقه وينكرون أن الإنسان مربوب تعلو عليه قوة أعلى منه وقوانين أعلى منه ندعوهم إلى نظرة في أحوال عالَمَهم الأرضي . نظرة في الدنيا دون حاجة إلى افتراض آخره .
ولا أحد لم يجرب ألم الضرس الذي يخرق الدماغ ويشق الرأس كالمنشار . والمغص الكلوي والصداع الشقي وألم الغضروف وسل العظام وهي ألوان من الجحيم يعرفها من أَلقى به سوء حظه إلى تجربتها .
وزيارة لعنبر المحروقين في القصر العيني سوف تقنع المشاهد بأن هناك فارقًا كبيرًا بين رجل محروق مشوه يصرخ في الضمادات , وبين حال رجل يرشف فنجان شاي في استرخاء ولذة على شاطئ النيل وإلى جواره حسناء تلاطفه .
إن العذاب حقيقة ملموسة .
والإنسان مربوب بقوة أعلى منه وهو عديم الحيلة في قبضة تلك القوة . ويستوي الأمر أن يسمي المؤمن هذه القوة . (( الله )) وأن يسميها الملحد (( الطبيعة )) أو (( القوانين الطبيعية )) أو (( قانون القوانين )) فما هذه إلا سفسطة لفظية .
المهم أنه لم يجد بدّاً من الإعتراف بأن هناك قوة تعلو على الإنسان وعلى الحوادث . وأن هذه القوة تعذب وتنكل .
وأصحاب المشاعر الرقيقة الذين يتأففون من تصور الله جبارًا معذِبًا . علينا أن نذكِّرَهم بما كان يفعله الخليفة التركي حينما يصدر حكم الإعدام بالخازوق على أعدائه . وما كان يفعله الجلاد المنوط به تنفيذ الحكم حينما كان يلقي بالضحية على بطنه ثم يدخل في الشرج خازوقاً ذا رأس حديدية مدببة يظل يُدَق ببطء حتى تتهتك جميع الأحشاء ويخرج الخازوق من الرقبة . وكيف أنه كان من واجب الجلاد أن يحتفظ بضحيته حيّاً حتى يخرج الخازوق من رقبته ليشعر بجميع الآلام الضرورية .
وأفظع من ذلك أن تفقأ عيون الأسرى بالأسياخ المحمية في النار .
مثل هؤلاء الجبارين هل من المفروض أن يقدم لهم الله حفلة شاي لأن الله محبة ؟!
بل إن جهنم هي منتهى المحبة ما دامت لا توجد وسيلة غيرها لتعريف هؤلاء بأن هناك إلهًا عادلًا .
وهي رحمة من حيث كونها تعريفًا وتعليمًا لمن رفض أن يتعلم من جميع الكتب والرسل , وللذين كذَّبوا حتى أوَّليات العقل وبداهات الإنسانية .
أيكون عدلًا أن يقتل هتلر عشرين مليونًا في حرب عالمية . يسلخ فيها عماله الأسرى ويعدمون الألوف منهم في غرف الغاز ويحرقونهم في المحارق . ثم عند الهزيمة ينتحر هتلر هاربًا وفارّاً من مواجهة نتيجة أعماله .
إن العبث وحده وأن يكون العالَم عبثًا في عبث هو الذي يمكن أن ينجي هذا القاتل الشامل من ذنبه .
ولا شيء حولنا في هذا العالَم المنضبط الجميل يدل على العبث . وكل شيء من أكبر النجوم إلى أدق الذرّات ينطق بالنظام والضبط والإحكام . ولا يكون الله محبة . ولا يكون عادلاً . إلا إذا وضع هذا الرجل في هاوية أعماله .
عن العاقل الفطن المتأمل لن يحتاج إلى فلسفة ليدرك حقيقة العذاب فإنه سوف يكتشف نذر هذا العذاب في نفسه داخل ضميره . وفي عيون المذنبين ونظرات القتلة . وفي دموع المظلومين وآلام المكلومين وفي ذل الأسرى وجبروت المنتصرين وفي حشرجة المحتضرين .
وهو سوف يدرك العذاب والحساب حينما يحتويه الندم .
والندم هو صوت الفطرة لحظة الخطأ .
وهو القيامة الصغرى والجحيم الأصغر وهو نموذج من الدينونة .
وهو إشارة الخطر التي تضيء في داخل النفس لتدل على أن هناك ميزانًا للأعمال . وأن هناك حقّاً وباطلًا . ومَن كان على الحق فهو على صراط وقلبه مطمئن . ومن كان على باطل فهو في هاوية الندم وقلبه كليم .
وعذاب الدنيا دائمًا نوع من التقويم . وكذلك على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمم . فهزيمة 67 في سيناء كانت درسًا , كما أن رسوب الطالب يكون درسًا – كما أن آلام المرض واعتلال الصحة هي لمن عاش , حياة الإسراف والترف والرخاوة والمتعة درس .
والعذاب يجلو صدأ النفس و يصقل معدنها .
ولا نعرف نبيّاً أو مصلحًا أو فنانًا أو عبقريّاً إلا وقد ذاق أشد العذاب مرضًا أو فقرًا أو إضطهادًا .
والعذاب من هذه الزاوية محبة . وهو الضريبة التي يلزم دفعها للإنتقال إلى درجة أعلى .
وإذا خفيت عنا الحكمة في العذاب أحيانًا فلأننا لا ندرك كل شيء ولا نعرف كل شيء من القصة إلا تلك الرحلة المحدودة بين قوسين التي إسمها الدنيا .
أما ما قبل ذلك وما بعد ذلك فهو بالنسبة لنا غيب محجوب , ولذا يجب أن نصمت في احترام ولا نطلق الأحكام .
أما كيفيات العذاب بعد البعث فلا يمكن القطع فيها تفصيلًا لأن الآخرة كلها غيب . ويمكن أن يكون ما ورد في الكتب المقدسة بهذا الشأن رموزًا وإشارات . كما نقول للصبي الذي لم يدرك البلوغ حينما يسألنا عن اللذة الجنسية إنها مثل السكر أو العسل لأننا لا نجد في قاموس خبراته شيئًا غير ذلك . ولأن تلك اللذة بالنسبة له غيب لا يمكن وصفه بكلمات من محصوله اللغوي فهي خبرة لم يجربها إطلاقًا , وبالمثل الجنة والجحيم هي خبرات بالنسبة لنا . غيب . ولا يمكن وصفها بكلمات من قاموسنا الدنيوي . وكل ما يمكن هو إيراد أوصاف على سبيل التقريب مثل النار أو الحدائق الغناء التي تجري من تحتها الأنهار . أما ما سوف يحدث فهو شيء يفوق بكثير كل هذه الأوصاف التقريبية مما لم تره عين ولم يخطر على قلب بشر .
ويمكن أن يقال دون خطأ إن جهنم هي المقام الأسفل بكل ما يستتبع ذلك المقام من عذاب حسي ومعنوي . وأن الجنة هي المقام الأعلى بكل ما يستتبع ذلك المقام من نعيم حسي ومعنوي .
والصوفية يقولون إن جهنم هي مقام البعد ( البعد عن الله ) والحَجب عن الله . والجنة هي مقام القرب بكل ما يتبع ذلك القرب من سعادة لا يمكن وصفها .
(( و مَنْ كانَ في هَذِهِ أعمَْى فَهوَ في الآخرة أعْمى وأضَلُّ سبيلاً )) . والعمى هنا هو عمى البصيرة .
إنها إذن أشبه بما نرى من درجات ومقامات وتفاوت بين أعمى وبصير . ومهتد وضال . ولكن في الآخرة سوف يكون التفاوت عظيمًا .
(( انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا )) . (الإسراء – 21)
لدرجة أن من سيكون في المقام الأسفل سيكون حاله حال من في النار وأسوأ . إنه قانون التفاضل الذي يحكم الوجود كله دنيا وآخره ملكًا وملكوتًا غيبًا وشهودًا .
لكل واحد رتبة واستحقاق ومقام ودرجة . ولا يستوي اثنان .
ولا يكون الإنتقال من درجة إلى درجة إلا مقابل جهد وعمل واختبار وابتلاء . ومن كان في الدنيا في أحط الدرجات من عمى البصيرة فسيكون حاله في الآخرة في أحط الدرجات أيضاً .
وهذا عين العدل . أن يوضع كل إنسان في مكانه ودرجته واستحقاقه . وهذا ما يحدث في الدنيا ظلمًا وهو ما سوف يحدث في الآخرة عدلًا .
والعذاب بهذا المعنى عدل .
والثواب عدل .
وكلاهما من مقتضيات الضرورة .
أن يكون الحديد الصلب غاية في الصلابة فيصنع منه الموتور .
ويكون الكاوتشوك رخوًا فتصنع منه العجلات .
ويكون القش رخيصًا فتصنع منه رأس المكنسة .
ويكون القش رخيصًا فتصنع منه رأس المكنسة .
وأن يكون القطن الفاخر لصناعة الوسائد . والقطن الرديء لتسليك البالوعات .
وهذه بداهات وأوليات تقول بها الفطرة والمنطق السوي ولا تحتاج إلى تدبيج مقالات في الفلسفة ولا إلى رص حيثيات ومسببات .
ولهذا كانت الأديان كلها مقولة فطرية . لا تحتمل الجدل ولا تحتمل التكذيب . ولهذا كانت حقيقة مطلقة تقبلها العقول السوية التي لم تفسدها لفلفات الفلسفة والسفسطة . والتي احتفظت ببكارتها ونقاوتها وبرئَت من داء العناد والمكابرة .
ولهذا يقول الصوفي إن الله لا يحتاج إلى دليل بل إن الله هو الدليل الذي يستدل به على كل شيء .
هو الثابت الذي نعرف به المتغيرات .
وهو الجوهر الذي ندرك به اختلاف الظواهر .
وهو البرهان الذي ندرك به حكمة العالم الزائل .
أما العقل الذي يطلب برهاناً على وجود الله فهو عقل فقد التعقل .
فالنور يكشف لنا الأشياء ويدلنا عليها .
ولا يمكن أن تكون الأشياء هي دليلنا على النور وإلا نكون قد قلبنا الأوضاع . كمن يسير في ضوء النهار ثم يقول . أين دليلك على أن الدنيا نهار . أثبت لي بالبرهان .
ومن فقد سلامة الفطرة وبكارة القلب . ولم يبق له إلا الجدل وتلافيف المنطق وعلوم الكلام . فقد فقدَ كل شيء وسوف يطول به المطاف . ولن يصل أبداً .
ومثل الذي يحتج على العذاب الدنيوي ويتبرم ويتسخط ويلعن الحياة وقول إنها حياة لا تحتمل وإنه يرفضها وإن أحداً لم يأخذ رأيه قبل أن يولد وإنه خلق قهراً وحكم عليه بالعذاب جبراً وإن هذا ظلم فادح .
مثل هذا الرفض الساخط مثل الفنان الذي يؤدي دوراً في مسرحية . ويقتضي الدور أن يتلقى الضرب والركل كل يوم أما المتفرجين .
لو أن هذا الممثل فقد الذاكرة ولم ير شريط حياته إلا أمام هذا الدور الذي يؤديه بين قوسين على خشبة المسرح كل يوم . فإنه سوف يحتج . رافضاً أن يتلقى العذاب . ويقول إن أحداً لم يأخذ رأيه وإنه خلق قهراً وحكم عليه بالعذاب جبراً وقضي عليه بالإهانة أمام الناس بدون مبرر معقول وبدون اختيار منه منذ البداية .
وسوف ينسى هذا الممثل أنه كان هناك اتفاق قبل بدء الرواية . وكان هناك تكليف من المخرج ثم قبول للتكليف من جانب الممثل . ثم عهد وميثاق على تنفيذ المطلوب . كل هذا تم في حرية قبل أن يبدأ العرض . وارتضى الممثل دوره اختياراً . بل إنه أحب دوره وسعى إليه .
ولكن الممثل قد نسي تماماً هذه الحقبة الزمنية قبل الوقوف على خشبة المسرح . ومن هنا تحولت حياته بما فيها من تكاليف وآلام إلى علامة استفهام ولغز غير مفهوم .
وهذا شأن الإنسان الذي تصور أن كل حياته هي وجوده بالجسد في هذه اللحظات الدنيوية وأنه هالك ومصيره التراب . وأنه ليس له وجود غير هذا الوجود الثلاثي الأبعاد على خشبة الحياة الدنيا .
نسي هذا الإنسان أنه كان روحاً في الملكوت وأنه جاء على الدنيا بتكليف وأنه قبل هذا التكليف وارتضاه . وأنه كانت بينه وبين خالقه ( المخرج الأعظم لدراما الوجود ) عهود ومواثيق . وأنه بعد دراما الوجود الدنيوي يكون البعث والحساب كما أنه بعد المسرحية يكون النقد من النقاد والنجاح والفشل من الجمهور والسقوط في عين النظارة أو الارتفاع في نظرهم .
إنه النسيان والغفلة .
والنظرة الضيقة المحدودة التي تتصور أن الدنيا كل شيء . هي التي تؤدي إلى ضلال الفكر . و هي التي تؤدي إلى الحيرة أمام العذاب والشر والألم ..
ومن هنا جاءت تسمية القرآن بأنه . ذكر . وتذكير . وتذكرة . ليتذكر أولو الألباب .
والنبي هو مذكر .
(( فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ , لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ))
( الغاشية 21 – 22 )
الدنيا كلها ليست كل القصة .
إنها فصل في الرواية . كان لها بدء قبل الميلاد وسيكون لها استمرار بعد الموت .
وفي داخل هذه الرؤية الشاملة يصبح للعذاب معنى ..
يصبح عذاب الدنيا رحمة من الرحيم الذي ينبهنا به حتى لا نغفل .
إنه محاولة إيقاظ لتتوتر الحواس ويتساءل العقل . وهو تذكير دائم بأن الدنيا لن تكون ولا يمكن أن تكون جنة . وإنها مجرد مرحلة .
وأن الإخلاد إلى ذاتها يؤدي بصاحبه إلى غفلة مهلكة .
إنه العقاب الذي ظاهره العذاب وباطنه الرحمة .
وأما عذاب الآخرة فهو الصحو على الحقيقة وعلى العدل المطلق الذي لا تفوته ذرة الخير ولا ذرة الشر . وهو اليقين بنظام المنظم الذي أبدع كل شيء صنعًا .
(( وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ))
واليقين هنا هو الموت وما وراءه .
~
مقال : لماذا العذاب
من كتاب : رحلتي من الشك إلى الإيمان
للدكتور : مصطفى محمود (رحمه الله). ❝
⏤ مصطفى محمود