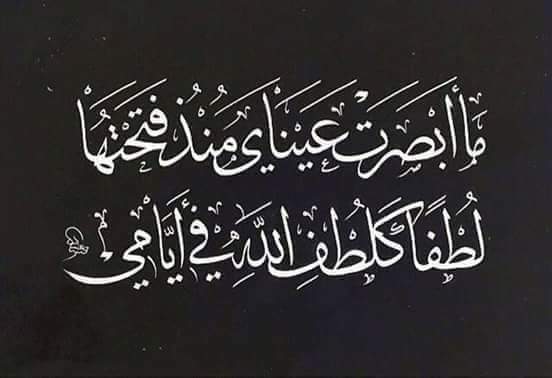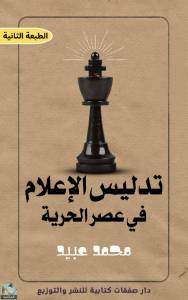❞ سفسطة ❝ 💬 اقتباسات من الكتب 📖
- سفسطة 💬 اقتباسات من الكتب 📖
█ حصريا تحميل كتاب مجاناً PDF اونلاين 2025
إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
اقتباسات في ❞سفسطة❝
-
❞ قام الكاتب علي الوردي بتناول عدد كبير من المواضيع داخل الإطار الاجتماعي في كتابه مهزلة العقل البشري الذي دوى صداه ومن هذه المواضيع، منطق المتعصبين وطبيعة المدينة وأيضاً عيب المدينة الفاضلة مع موضوع علي بن ابي طالب، بجانب موضوع التنازع أو التعاون. تناول الكاتب أيضاً أنواع التنازع وأسباب التنازع والقوقعة البشرية فضلاً عن ماهية السفسطة ومهزلة العقل البشري، بالإضافة إلى ماهية الديمقراطية في الاسلام وما هي أنماطها في ظل الدين الاسلامي، مع موضوع التاريخ والتدافع الاجتماعي وموضوع بعنوان علي وعمر.. ❝ ⏤علي الوردي❞ قام الكاتب علي الوردي بتناول عدد كبير من المواضيع داخل الإطار الاجتماعي في كتابه مهزلة العقل البشري الذي دوى صداه ومن هذه المواضيع، منطق المتعصبين وطبيعة المدينة وأيضاً عيب المدينة الفاضلة مع موضوع علي بن ابي طالب، بجانب موضوع التنازع أو التعاون.
تناول الكاتب أيضاً أنواع التنازع وأسباب التنازع والقوقعة البشرية فضلاً عن ماهية السفسطة ومهزلة العقل البشري، بالإضافة إلى ماهية الديمقراطية في الاسلام وما هي أنماطها في ظل الدين الاسلامي، مع موضوع التاريخ والتدافع الاجتماعي وموضوع بعنوان علي وعمر. ❝
⏤ علي الوردي -
❞ المخدرات التي تدخل كل بيت من خلال الإعلام الذي بعد عن وظيفته الأساسية في تعليم الناس، وبث الوعي بينهم، وتقديم الحق النافع الصحيح لهم ليُــحيوا وقته لا أن يُـضيعوه بالسفسطة والضلال. مع أن القانون يجرم ما يحض على الخصومة والكراهية أو الطعن الشارد بغير حق، وقد جاء في القانون المصري: «لا يجوز بأى حال من الأحوال الترخيص أو التصريح بإنشاء أية وسيلة صحفية أو إعلامية أو موقع إلكتروني، أو السماح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه متى كان يقوم على أساس تمييز ديني أو مذهبي، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفي أو عِرْقي، أو تعصب جَهوي، أو إلى ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو على نشاط ذي طابع سري، أو تحريض على الإباحية، أو على الكراهية أو العنف، أو تدعو إلى أي من ذلك أو تسمح به». فهل نأمل أن يرجع هذا الإعلام لوظيفته المنشودة؟ وهل يبصر القائمون على هذا الصرح الكبير هذه السفسطة التي تحمل معها التعصب الجاهل والفكر الهادم، كما هي مهمتهم الموضوعة في القانون والذي ينص على: «وللمجلس الأعلى، للاعتبارات التي يقتضيها الأمن القومي، أن يمنع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التي تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام، أو التي تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب»؟!. ❝. ❝ ⏤محمد أحمد عبيد❞ المخدرات التي تدخل كل بيت من خلال الإعلام الذي بعد عن وظيفته الأساسية في تعليم الناس، وبث الوعي بينهم، وتقديم الحق النافع الصحيح لهم ليُــحيوا وقته لا أن يُـضيعوه بالسفسطة والضلال.
مع أن القانون يجرم ما يحض على الخصومة والكراهية أو الطعن الشارد بغير حق، وقد جاء في القانون المصري: «لا يجوز بأى حال من الأحوال الترخيص أو التصريح بإنشاء أية وسيلة صحفية أو إعلامية أو موقع إلكتروني، أو السماح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه متى كان يقوم على أساس تمييز ديني أو مذهبي، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفي أو عِرْقي، أو تعصب جَهوي، أو إلى ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو على نشاط ذي طابع سري، أو تحريض على الإباحية، أو على الكراهية أو العنف، أو تدعو إلى أي من ذلك أو تسمح به».
فهل نأمل أن يرجع هذا الإعلام لوظيفته المنشودة؟
وهل يبصر القائمون على هذا الصرح الكبير هذه السفسطة التي تحمل معها التعصب الجاهل والفكر الهادم، كما هي مهمتهم الموضوعة في القانون والذي ينص على: «وللمجلس الأعلى، للاعتبارات التي يقتضيها الأمن القومي، أن يمنع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التي تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام، أو التي تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب»؟!. ❝
⏤ محمد أحمد عبيد -
❞ كان ذلك من زمن بعيد لست أذكره .. ربما كنت أدرج من الثالثة عشرة إلى الرابعة عشرة وربما قبل ذلك .. في مَطَالِعْ المراهقة .. حينما بدأت أتساءل في تمرد : - تقولون إن الله خلق الدنيا لأنه لابد لكل مخلوق من خالق ولا بد لكل صنعة من صانع ولا بد لكل موجود من موجِد .. صدقنا وآمنا .. فلتقولوا لي إذن مَن خلق الله .. أم أنه جاء بذاته ؟! .. فإذا كان قد جاء بذاته وصحّ في تصوركم أن يتم هذا الأمر .. فلماذا لا يصح في تصوركم أيضاً أن الدنيا جاءت بذاتها بلا خالق وينتهي الإشكال . كنت أقول هذا فتصفر من حولي الوجوه وتنطلق الألسُن تمطرني باللعنات وتتسابق إليّ اللكمات عن يمين وشمال .. ويستغفر لي أصحاب القلوب التقية ويطلبون لي الهدى .. ويتبرأ مني المتزمتون ويجتمع حولي المتمردون .. فنغرق معاً في جدل لا ينتهي إلا ليبدأ ولا يبدأ إلا ليسترسل . وتغيب عني تلك الأيام الحقيقة الأولى وراء ذلك الجدل . إن زهوي بعقلي الذي بدأ يتفتح وإعجابي بموهبة الكلام ومقارعة الحجج التي انفردت بها .. كان هو الحافز دائماً .. وكان هو المشجِع .. وكان هو الدافع .. وليس البحث عن الحقيقة ولا كشف الصواب . لقد رَفَضْتُ عبادة الله لأني إستغرقت في عبادة نفسي وأُعجبت بومضة النور التي بدأت تومض في فكري مع انفتاح الوعي وبداية الصحوة من مهد الطفولة . كانت هذه هي الحالة النفسية وراء المشهد الجدلي الذي يتكرر كل يوم . وغابت عني أيضاً أصول المنطق وأنا أعالج المنطق .. ولم أدرك أني أتناقض مع نفسي إذ كيف أعترف بالخالق ثم أقول : ومن خلق الخالق فأجعل منه مخلوقاً في الوقت الذي أسميه خالقاً .. وهي السفسطة بعينها . ثم إن القول بسبب أول للوجود يقتضي أن يكون هذا السبب واجب الوجود في ذاته وليس معتمداً ولا محتاجاً لغيره لكي يوجد . أما أن يكون السبب في حاجة إلى سبب فإن هذا يجعله واحدة من حلقات السببية ولا يجعل منه سبباً أول . هذه هي أبعاد القضية الفلسفية التي إنتهت بأرسطو إلى القول بالسبب الأول والمحرك الأول للوجود . ولم تكن هذه الأبعاد واضحة في ذهني في ذلك الحين . ولم أكُن قد عرفت بعد من هو أرسطو ولا ما هي القوانين الأولى للمنطق والجدل . واحتاج الأمر إلى ثلاثين سنة من الغرق في الكتب وآلاف الليالي من الخلوةِ والتأمل والحوار مع النفس وإعادة النظر ثُمَّ إعادة النظر في إعادة النظر .. ثُمَّ تقليب الفكر على كل وجه لأقطع فيه الطريق الشائكة من ( الله والإنسان ) إلى ( لغز الحياة ) إلى ( لغز الموت ) إلى ما أكتب من كلمات على درب اليقين ، لم يكن الأمر سهلاً .. لأني لم أشأ أن آخذ الأمر مأخذاً سهلاً . ولو أني أصغيت إلى صوت الفطرة وتركت البداهة تقودني لأعفيت نفسي من عناء الجدل .. ولقادتني الفطرة إلى الله .. ولكنني جئت في زمن تَعَقّدِتْ فيه كل شيء وضَعِفَ صوت الفطرة حتى صار همساً وإرتفع صوت العقل حتى صار لجاجة وغروراً واعتداداً .. والعقل معذور في إسرافه إذ يرى نفسه واقفاً على هرم هائل من المنجزات وإذ يرى نفسه مانحاً للحضارة بما فيها من صناعة وكهرباء وصواريخ وطائرات وغواصات وإذ يرى نفسه قد اقتحم البر والبحر والجو والماء وما تحت الماء .. فتصور نفسه القادر على كل شيء وزج نفسه في كل شيء وأقام نفسه حاكماً على ما يعلم وما لا يعلم . وغرقت في مكتبة البلدية بطنطا وأنا صبي أقرأ لشبلي شميل وسلامة موسى وأتعرف على فرويد وداروين . وشغفت بالكيمياء والطبيعة والبيولوجيا .. وكان لي معمل صغير في غرفتي أجضر فيه غاز ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وأقتل الصراصير بالكلور وأشرِّح فيه الضفادع ، وكانت الصيحة التي غمرت العالم هي .. العلم .. العلم .. العلم .. ولا شيء غير العلم !! النظرة الموضوعية هي الطريق . لنرفض الغيبيات ولنكُف عن إطلاق البخور وترديد الخرافات . من يعطينا دبابات وطائرات ويأخذ منا الأديان والعبادات ؟؟ وكان ما يصلنا من أنباء العلم الغربي باهراً يخطف أبصارنا وكنا نأخذ عن الغرب كل شيء .. الكتب والدواء والملابس والمنسوجات والقاطرات والسيارات .. وحتى الأطعمة المعلبة .. حتى قلم الرصاص والدبوس والإبرة .. حتى نظم التعليم وقوالب التأليف الأدبي من قصة ومسرحية ورواية .. حتى ورق الصحف . وحول أبطال الغرب وعبقرياته كنا ننسج أحلامنا ومُثُلِنا العليا .. حول باستير وماركوني ورونتجن وأديسون .. وحول نابليون وإبراهام لنكولن .. وكرستوفر كولمبس وماجلان . كان الغرب هو التقدم ، وكان الشرق العربي هو التخلف والضعف والتخاذل والإنهيار تحت أقدام الإستعمار ، وكان طبيعيّاً أن نتصور أن كل ما يأتينا من الغرب هو النور والحق .. وهو السبيل إلى القوة والخلاص . ودخلت كلية الطب لأتلقى العلوم بلغة إنجليزية وأدرس التشريح في مراجع إنجليزية وأتكلم مع أستاذي في المشفى باللغة الإنجليزية .. ليس لأن إنجلترا كانت تحتل القناة لكن لسبب آخر مشروع وعادل .. هو أن علم الطب الحديث كان صناعة غربية تماماً .. وما بدأه العرب في هذه العلوم أيام ابن سينا , كان مجرد أوليّات لا تفي بحاجات العصر . وقد التقط علماء الغرب الخيط من حيث انتهى ابن سينا والباحثون العرب ثم استأنفوا الطريق بإمكانيات متطورة ومعامل ومختبرات وملايين الجنيهات المرصودة للبحث , فسبقوا الأولين من العرب والفُرس والعُجم , وأقاموا صرح علم الطب الحديث والفسيولوجيا والتشريح والباثولوجيا وأصبحوا بحق مرجعاً . وتعلمت ما تعلمت في كتب الطب .. النظرة العلمية .. وأنه لا يصح إقامة حكم بدون حيثيات من الواقع وشواهد من الحس . وأن العلم يبدأ من المحسوس والمنظور والملموس وأن العلم ذاته هو عملية جمع شواهد واستخراج قوانين ، وما لا يقع تحت الحس فهو في النظرة العلمية غير موجود ، وأن الغيب لا حساب له في الحكم العلمي . بهذا العقل العلمي المادي البحت بدأت رحلتي في عالم العقيدة وبالرغم من هذه الأرضية المادية والإنطلاق من المحسوسات الذي ينكر كل ما هو غيب فإني لم أستطع أن أنفي أو أستبعد القوة الإلهية . كان العلم يقدم صورة عن الكون بالغة الإحكام والإنضباط .. كل شيء من ورقة الشجر إلى جناح الفراشة إلى ذرة الرمل فيها تناسق ونظام وجمال الكون كله مبني وفق هندسة وقوانين دقيقة . وكل شيء يتحرك بحساب من الذرة المتناهية في الصغر إلى الفلَك العظيم إلى الشمس وكواكبها إلى المجرة الهائلة التي يقول لنا الفَلك إن فيها أكثر من ألف مليون مجرة . كل هذا الوجود اللامتناهي من أصغر إلكترون إلى أعظم جرم سماوي كنت أراه أشبه بمعزوفة متناسقة الأنغام مضبوطة التوزيع كل حركة فيها بمقدار .. أشبه بالبدن المتكامل الذي فيه روح . كان العلم يمدني بوسيلة أتصور بها الله بطريقة مادية . وفي هذه المرحلة تصورت أن الله هو الطاقة الباطنة في الكون التي تنظمه في منظومات جميلة من أحياء وجمادات وأراضٍ وسماوات .. هو الحركة التي كشفها العلم في الذرة وفي البروتوبلازم وفي الأفلاك .. هو الحيوية الخالقة الباطنة في كل شيء ..أو بعبارة القديس توماس " الفعل الخالص الذي ظل يتحول في الميكروب حتى أصبح إنساناً ومازال يتحول وسيظل يتحول إلى ما لانهاية " . والوجود كان في تصوري لامحدوداً لانهائياً . إذ لا يمكن أن يحد الوجود إلا العدم .. والعدم معدوم .. ومن هنا يلزم منطقياً أن يكون الوجود غير محدود ولانهائي . ولا يصح أن نسأل .. مَن الذي خلق الكون . إذ أن السؤال يستتبع أن الكون كان معدوماً في البداية ثم وُجِد .. وكيف يكون لمعدوم كيان ؟! . إن العدم معدوم في الزمان والمكان وساقط في حساب الكلام ولا يصح القول بأنه كان . وبهذا جعلت من الوجود حدثاً قديماً أبدياً أزلياً ممتداً في الزمان لا حدود له ولا نهاية . وأصبح الله في هذه النظرة هو الكل ونحن تجلياته . الله هو الوجود .. والعدم قبله معدوم . هو الوجود المادي الممتد أزلاً وأبداً بلا بدء وبلا نهاية . وهكذا أقمت لنفسي نظرية تكتفي بالموجود .. وترى أن الله هو الوجود .. دون حاجة إلى افتراض الغيب والمغيبات .. ودون حاجة إلى التماس اللامنظور . وبذلك وقعت في أسر فكرة وحدة الوجود الهندية وفلسفة سبينوزا .. وفكرة برجسون عن الطاقة الباطنة الخلاّقة .. وكلها فلسفات تبدأ من الأرض .. من الحواس الخمس .. ولا تعترف بالمغيبات ، ووحدة الوجود الهندية تمضي إلى أكثر من ذلك فتلغي الثنائية بين المخلوق والخالق .. فكل المخلوقات في نظرها هي عيني الخالق . وفي سفر اليوبانيشاد صلاة هندية قديمة تشرح هذا المعنى في أبيات رقيقة من الشعر ... إن الإله براهماً الذي يسكن قلب العالم يتحدث في همس قائلاً : إذا ظن القاتل أنه قاتل ...... والمقتول أنه قتيل ......... فليسا يدريان ما خفي من أساليبي .... حيث أكون الصدر لمن يموت ........ والسلاح لمن يقتل ....... والجناح لمن يطير ...... وحيث أكون لمن يشك في وجودي ...... كل شيء حتى الشك نفسه .... وحيث أكون أنا الواحد ..... وأنا الأشياء ..... إنه إله يشبه النور الأبيض .. واحد .. وبسيط .. ولكنه يحتوى في داخله على ألوان الطيف السبعة ، وعشت سنوات في هذا الضباب الهندي وهذه الماريجوانا الصوفية ومارست اليوجا وقرأتها في أصولها وتلقيت تعاليمها على أيدي أساتذة هنود . وسيطرَت عليَّ فكرة التناسخ مدة طويلة وظهرت روايات لي مثل ( العنكبوت ) و ( الخروج من التابوت ) ، ثم بدأت أفيق على حالة من عدم الرضا وعدم الإقتناع . واعترفت بيني وبين نفسي أن هذه الفكرة عن الله فيها الكثير من الخلط . ومرة أخرى كان العلم هو دليلي ومنقذي ومرشدي ، عكوفي على العلم وعلى الشريحة الحية تحت الميكروسكوب قال لي شيئاً آخر . وحدة الوجود الهندية كانت عبارة شعرية صوفية .. ولكنها غير صادقة .. والحقيقة المؤكدة التي يقولها العلم أن هناك وحدة في الخامة لا أكثر .. وحدة في النسيج والسُنن الأولية والقوانين .. وحدة في المادة الأولية التي بُنيَ منها كل شيء .. فكل الحياة من نبات وحيوان وإنسان بنيت من تواليف الكربون مع الآيدروجين والأكسجين .. ولهذا تتحول كلها إلى فحم بالإحتراق .. وكل صنوف الحياة تقوم على الخلية الواحدة ومضاعفاتها . ومرة أخرى نتعلم من الفلَك والكيمياء والعلوم النووية أن الكربون ذاته وكذلك جميع العناصر المختلفة جاءت من طبخ عنصر واحد في باطن الأفران النجمية الهائلة هو الآيدروجين . الآيدروجين يتحول في باطن الأفران النجمية إلى هليوم وكربون وسليكون وكوبالت ونيكل وحديد إلى آخر قائمة العناصر وذلك بتفكيكه وإعادة تركيبه في درجات حرارة وضغوط هائلة ، وهذا يرد جميع صنوف الموجودات إلى خامة واحدة .. إلى فتلة واحدة حريرية غُزِل منها الكون في تفصيلات وتصميمات وطُرُز مختلفة . والخلاف بين صنف وصنف وبين مخلوق ومخلوق هو خلاف في العلاقات الكيفية والكمية .. في المعادلة والشفرة التكوينية .. لكن الخامة واحدة .. وهذا سر الشعور بالنَسَب والقرابة والمصاهرة وصلة الرحم بين الإنسان والحيوان وبين الوَحش ومُروِضه وبين الأنف التي تشم والوهرة العاطرة وبين العين ومنظر الغروب الجميل . هذا هو سر الهارموني والإنسجام ، إن كل الوجود أفراد أسرة واحدة من أب واحد ، وهو أمر لا يستتبع أبداً أن نقول إن الله هو الوجود , وأن الخالق هو المخلوق فهذا خلط صوفيّ غير وارد . والأمر شبيه بحالة الناقد الذواقة الذي دخل معرضاً للرسم فاكتشف وحدة فنية بين جميع اللوحات .. واكتشف أنها جميعاً مرسومة على الخامة نفسها .. وبذات المجموعة الواحدة من الألوان , وأكثر من هذا أن أسلوب الرسم واحد . والنتيجة الطبيعية أن يقفز إلى ذهن الناقد أن خالق جميع هذه اللوحات واحد . وأن الرسّام هو بيكاسو أو شاجال أو موديلياني .. مثلاً ، فالوحدة بين الموجودات تعني وحدة خالقها . ولكنها لا تعني أبداً أن هذه الموجدات هي ذاتها الخالق ، ولا يقول الناقد أبداً إن هذه الرسوم هي الرسّام ، إن وحدة الوجود الهندية شطحة صوفيّة خرافية .. وهي تبسيط وجداني لا يصادق عليه العلم ولا يرتاح إليه العقل . وإنما تقول النظرة العلمية المتأملة لظواهر الخلق والمخلوقات , إن هناك وحدة بينها .. وحدة أسلوب ووحدة قوانين ووحدة خامات تعني جميعها أن خالقها واحد لم يشرك معه شريكاً يسمح بأسلوب غير أسلوبه . وتقول لنا أيضاً إن هذا الخالق هو عقل كلّي شامل ومحيط , يُلهم مخلوقاته ويهديها في رحلة تطورها ويسلّحها بوسائل البقاء , فهو يخلق لبذور الأشجار الصحراوية أجنحةً لتستطيع أن تعبر الصحاري الجرداء بحثاً عن ماء وعن ظروف إنبات موالية . وهو يزود بيضة البعوضة بكيسين للطفو لتطفو على الماء لحظة وضعها ولا تغرق . وما كان من الممكن للبعوضة أن تدرك قوانين أرشميدس للطفو فتصنع لبيضها تلك الأكياس . وإنما هو العقل الكلي الشامل المحيط الذي خلق .. هو الذي يزود كل مخلوق بأسباب حياته .. وهو خالق متعالٍ على مخلوقاته .. يعلم ما لا تعلم ويقدر على ما لا تقدر ويرى ما لا ترى ، فهو واحد أحد قادر عالم محيط سميع بصير خبير .. وهو متعال يعطي الصفات ولا تحيط به صفات . * * * والصلة دائماً معقودة بين هذا الخالق ومخلوقاته فهو أقرب إليها من دمها الذي يجري فيها ، وهو المبدِع الذي عزف الإبداع هذه المعزوفة الكونية الرائعة ، هو العادل الذي أحكم قوانينها وأقامها على نواميس دقيقة لا تخطئ ، وهكذا قدم لي العلم الفكرة الإسلامية الكاملة عن الله . * * * أما القول بأزلية الوجود لأن العدم معدوم والوجود موجود , فهو جدل لفظي لا يقوم إلا على اللعب بالألفاظ ، والعدم في واقع الأمر غير معدوم ، وقيام العدم في التصور والفكر ينفي كونه معدوماً . والعدم هو على الأكثر نفي ٌ لما نعلم ولكنه نفياً مطلقاً مساوياً للمحو المطلق . وفكرة العدم المطلق فرضية مثل فرضية الصفر الرياضي .. ولا يصح الخلط بين الإفتراض والواقع ولا يصح تحميل الواقع فرضاً نظرياً , فنقول اعتسافاً إن العدم معدوم , ونعتبر أن هذا الكلام قضية وجودية نبني عليها أحكاماً في الواقع .. هذا تناقض صريح وسفسطة جدلية ، وبالمثل القول بأن الوجود موجود .. هنا نفس الخلط .. فالوجود تجريد ذهني والموجود واقع حسيّ .. وكلمة العدم وكلمة الوجود تجريدات ذهنية كالصفر ،واللانهاية لا يصح أن نخلط بينها وبين الواقع الملموس المتعيَّن ،والكون الكائن المحدد أمام الحواس ،، الكون إذن ليس أزليا ً،، وإنما هو كون مخلوق كان لا بد له بدء بدليل آخرمن قاموس العلم هو ما نعرفه باسم القانون الثاني للديناميكا الحرارية ،، ويقرر هذا القانون أن الحرارة تنتقل من الساخن إلى البارد من الحرارة الأعلى إلى الحرارة الأدنى حتى يتعادل المستويان فيتوقف التبادل الحراري . ولو كان الكون أبديا أزليا بدون ابتداء لكان التبادل الحراري قد توقف في تلك الآباد الطويلة المتاحة وبالتالي لتوقفت كل صور الحياة ولبردت النجوم وصارت بدرجة حرارة الصقيع والخواء حولها وانتهى كل شيء ،،إن هذا القانون هو ذاته دليل على أن الكون له بدء . والقيامة الصغرى التي نراها حولنا في موت الحضارات وموت الأفراد وموت النجوم وموت الحيوان والنبات وتناهي اللحظات والحُقَبْ والدهور .. هي لمحة أُخرى تدلنا على القيامة الكبرى التي لابد أن ينتهي إليها الكون .. إن العلم الحَق لم يكن أبداً مناقضاً للدين بل إنه دالٌ عليه مؤكَد بمعناه . وإنما نصف العلم هو الذي يوقع العقل في الشبهة والشك .. وبخاصة إن كان ذلك العقل مزهوّاً بنفسه معتدّاً بعقلانيته .. وبخاصة إذا دارت المعركة في عصر يتصور فيه العقل أنه كلّ شيء .. وإذا حاصرت الإنسان شواهد حضارة ماديّة صارخة تزأر فيها الطائرات وسفن الفضاء والأقمار الصناعيّة .. هاتفةً كلّ لحظة : أنا المادة .... أنا كل شيء .... مقال / اللــــــّـــــه من كتاب / رحلتي من الشك إلى الإيمان للدكتور / مصطفى محمود ( رحمه الله ). ❝ ⏤مصطفى محمود❞ كان ذلك من زمن بعيد لست أذكره . ربما كنت أدرج من الثالثة عشرة إلى الرابعة عشرة وربما قبل ذلك . في مَطَالِعْ المراهقة . حينما بدأت أتساءل في تمرد :
- تقولون إن الله خلق الدنيا لأنه لابد لكل مخلوق من خالق ولا بد لكل صنعة من صانع ولا بد لكل موجود من موجِد . صدقنا وآمنا . فلتقولوا لي إذن مَن خلق الله . أم أنه جاء بذاته ؟! . فإذا كان قد جاء بذاته وصحّ في تصوركم أن يتم هذا الأمر . فلماذا لا يصح في تصوركم أيضاً أن الدنيا جاءت بذاتها بلا خالق وينتهي الإشكال .
كنت أقول هذا فتصفر من حولي الوجوه وتنطلق الألسُن تمطرني باللعنات وتتسابق إليّ اللكمات عن يمين وشمال . ويستغفر لي أصحاب القلوب التقية ويطلبون لي الهدى . ويتبرأ مني المتزمتون ويجتمع حولي المتمردون . فنغرق معاً في جدل لا ينتهي إلا ليبدأ ولا يبدأ إلا ليسترسل .
وتغيب عني تلك الأيام الحقيقة الأولى وراء ذلك الجدل .
إن زهوي بعقلي الذي بدأ يتفتح وإعجابي بموهبة الكلام ومقارعة الحجج التي انفردت بها . كان هو الحافز دائماً . وكان هو المشجِع . وكان هو الدافع . وليس البحث عن الحقيقة ولا كشف الصواب .
لقد رَفَضْتُ عبادة الله لأني إستغرقت في عبادة نفسي وأُعجبت بومضة النور التي بدأت تومض في فكري مع انفتاح الوعي وبداية الصحوة من مهد الطفولة .
كانت هذه هي الحالة النفسية وراء المشهد الجدلي الذي يتكرر كل يوم . وغابت عني أيضاً أصول المنطق وأنا أعالج المنطق . ولم أدرك أني أتناقض مع نفسي إذ كيف أعترف بالخالق ثم أقول : ومن خلق الخالق فأجعل منه مخلوقاً في الوقت الذي أسميه خالقاً . وهي السفسطة بعينها .
ثم إن القول بسبب أول للوجود يقتضي أن يكون هذا السبب واجب الوجود في ذاته وليس معتمداً ولا محتاجاً لغيره لكي يوجد . أما أن يكون السبب في حاجة إلى سبب فإن هذا يجعله واحدة من حلقات السببية ولا يجعل منه سبباً أول .
هذه هي أبعاد القضية الفلسفية التي إنتهت بأرسطو إلى القول بالسبب الأول والمحرك الأول للوجود .
ولم تكن هذه الأبعاد واضحة في ذهني في ذلك الحين .
ولم أكُن قد عرفت بعد من هو أرسطو ولا ما هي القوانين الأولى للمنطق والجدل .
واحتاج الأمر إلى ثلاثين سنة من الغرق في الكتب وآلاف الليالي من الخلوةِ والتأمل والحوار مع النفس وإعادة النظر ثُمَّ إعادة النظر في إعادة النظر .
ثُمَّ تقليب الفكر على كل وجه لأقطع فيه الطريق الشائكة من ( الله والإنسان ) إلى ( لغز الحياة ) إلى ( لغز الموت ) إلى ما أكتب من كلمات على درب اليقين ، لم يكن الأمر سهلاً . لأني لم أشأ أن آخذ الأمر مأخذاً سهلاً .
ولو أني أصغيت إلى صوت الفطرة وتركت البداهة تقودني لأعفيت نفسي من عناء الجدل . ولقادتني الفطرة إلى الله .
ولكنني جئت في زمن تَعَقّدِتْ فيه كل شيء وضَعِفَ صوت الفطرة حتى صار همساً وإرتفع صوت العقل حتى صار لجاجة وغروراً واعتداداً .
والعقل معذور في إسرافه إذ يرى نفسه واقفاً على هرم هائل من المنجزات وإذ يرى نفسه مانحاً للحضارة بما فيها من صناعة وكهرباء وصواريخ وطائرات وغواصات وإذ يرى نفسه قد اقتحم البر والبحر والجو والماء وما تحت الماء . فتصور نفسه القادر على كل شيء وزج نفسه في كل شيء وأقام نفسه حاكماً على ما يعلم وما لا يعلم .
وغرقت في مكتبة البلدية بطنطا وأنا صبي أقرأ لشبلي شميل وسلامة موسى وأتعرف على فرويد وداروين .
وشغفت بالكيمياء والطبيعة والبيولوجيا . وكان لي معمل صغير في غرفتي أجضر فيه غاز ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وأقتل الصراصير بالكلور وأشرِّح فيه الضفادع ، وكانت الصيحة التي غمرت العالم هي . العلم . العلم . العلم . ولا شيء غير العلم !!
النظرة الموضوعية هي الطريق .
لنرفض الغيبيات ولنكُف عن إطلاق البخور وترديد الخرافات .
من يعطينا دبابات وطائرات ويأخذ منا الأديان والعبادات ؟؟
وكان ما يصلنا من أنباء العلم الغربي باهراً يخطف أبصارنا وكنا نأخذ عن الغرب كل شيء . الكتب والدواء والملابس والمنسوجات والقاطرات والسيارات . وحتى الأطعمة المعلبة . حتى قلم الرصاص والدبوس والإبرة . حتى نظم التعليم وقوالب التأليف الأدبي من قصة ومسرحية ورواية . حتى ورق الصحف .
وحول أبطال الغرب وعبقرياته كنا ننسج أحلامنا ومُثُلِنا العليا . حول باستير وماركوني ورونتجن وأديسون . وحول نابليون وإبراهام لنكولن . وكرستوفر كولمبس وماجلان .
كان الغرب هو التقدم ، وكان الشرق العربي هو التخلف والضعف والتخاذل والإنهيار تحت أقدام الإستعمار ، وكان طبيعيّاً أن نتصور أن كل ما يأتينا من الغرب هو النور والحق . وهو السبيل إلى القوة والخلاص .
ودخلت كلية الطب لأتلقى العلوم بلغة إنجليزية وأدرس التشريح في مراجع إنجليزية وأتكلم مع أستاذي في المشفى باللغة الإنجليزية . ليس لأن إنجلترا كانت تحتل القناة لكن لسبب آخر مشروع وعادل . هو أن علم الطب الحديث كان صناعة غربية تماماً . وما بدأه العرب في هذه العلوم أيام ابن سينا , كان مجرد أوليّات لا تفي بحاجات العصر .
وقد التقط علماء الغرب الخيط من حيث انتهى ابن سينا والباحثون العرب ثم استأنفوا الطريق بإمكانيات متطورة ومعامل ومختبرات وملايين الجنيهات المرصودة للبحث , فسبقوا الأولين من العرب والفُرس والعُجم , وأقاموا صرح علم الطب الحديث والفسيولوجيا والتشريح والباثولوجيا وأصبحوا بحق مرجعاً .
وتعلمت ما تعلمت في كتب الطب . النظرة العلمية . وأنه لا يصح إقامة حكم بدون حيثيات من الواقع وشواهد من الحس .
وأن العلم يبدأ من المحسوس والمنظور والملموس وأن العلم ذاته هو عملية جمع شواهد واستخراج قوانين ، وما لا يقع تحت الحس فهو في النظرة العلمية غير موجود ، وأن الغيب لا حساب له في الحكم العلمي .
بهذا العقل العلمي المادي البحت بدأت رحلتي في عالم العقيدة وبالرغم من هذه الأرضية المادية والإنطلاق من المحسوسات الذي ينكر كل ما هو غيب فإني لم أستطع أن أنفي أو أستبعد القوة الإلهية .
كان العلم يقدم صورة عن الكون بالغة الإحكام والإنضباط . كل شيء من ورقة الشجر إلى جناح الفراشة إلى ذرة الرمل فيها تناسق ونظام وجمال الكون كله مبني وفق هندسة وقوانين دقيقة .
وكل شيء يتحرك بحساب من الذرة المتناهية في الصغر إلى الفلَك العظيم إلى الشمس وكواكبها إلى المجرة الهائلة التي يقول لنا الفَلك إن فيها أكثر من ألف مليون مجرة .
كل هذا الوجود اللامتناهي من أصغر إلكترون إلى أعظم جرم سماوي كنت أراه أشبه بمعزوفة متناسقة الأنغام مضبوطة التوزيع كل حركة فيها بمقدار . أشبه بالبدن المتكامل الذي فيه روح .
كان العلم يمدني بوسيلة أتصور بها الله بطريقة مادية .
وفي هذه المرحلة تصورت أن الله هو الطاقة الباطنة في الكون التي تنظمه في منظومات جميلة من أحياء وجمادات وأراضٍ وسماوات . هو الحركة التي كشفها العلم في الذرة وفي البروتوبلازم وفي الأفلاك .
هو الحيوية الخالقة الباطنة في كل شيء .أو بعبارة القديس توماس ˝ الفعل الخالص الذي ظل يتحول في الميكروب حتى أصبح إنساناً ومازال يتحول وسيظل يتحول إلى ما لانهاية ˝ .
والوجود كان في تصوري لامحدوداً لانهائياً . إذ لا يمكن أن يحد الوجود إلا العدم . والعدم معدوم . ومن هنا يلزم منطقياً أن يكون الوجود غير محدود ولانهائي .
ولا يصح أن نسأل . مَن الذي خلق الكون . إذ أن السؤال يستتبع أن الكون كان معدوماً في البداية ثم وُجِد . وكيف يكون لمعدوم كيان ؟! .
إن العدم معدوم في الزمان والمكان وساقط في حساب الكلام ولا يصح القول بأنه كان .
وبهذا جعلت من الوجود حدثاً قديماً أبدياً أزلياً ممتداً في الزمان لا حدود له ولا نهاية .
وأصبح الله في هذه النظرة هو الكل ونحن تجلياته .
الله هو الوجود . والعدم قبله معدوم .
هو الوجود المادي الممتد أزلاً وأبداً بلا بدء وبلا نهاية .
وهكذا أقمت لنفسي نظرية تكتفي بالموجود . وترى أن الله هو الوجود . دون حاجة إلى افتراض الغيب والمغيبات . ودون حاجة إلى التماس اللامنظور .
وبذلك وقعت في أسر فكرة وحدة الوجود الهندية وفلسفة سبينوزا . وفكرة برجسون عن الطاقة الباطنة الخلاّقة .
وكلها فلسفات تبدأ من الأرض . من الحواس الخمس . ولا تعترف بالمغيبات ، ووحدة الوجود الهندية تمضي إلى أكثر من ذلك فتلغي الثنائية بين المخلوق والخالق . فكل المخلوقات في نظرها هي عيني الخالق .
وفي سفر اليوبانيشاد صلاة هندية قديمة تشرح هذا المعنى في أبيات رقيقة من الشعر ..
إن الإله براهماً الذي يسكن قلب العالم يتحدث في همس قائلاً :
إذا ظن القاتل أنه قاتل ...
والمقتول أنه قتيل .....
فليسا يدريان ما خفي من أساليبي ..
حيث أكون الصدر لمن يموت ....
والسلاح لمن يقتل ....
والجناح لمن يطير ...
وحيث أكون لمن يشك في وجودي ...
كل شيء حتى الشك نفسه ..
وحيث أكون أنا الواحد ...
وأنا الأشياء ...
إنه إله يشبه النور الأبيض . واحد . وبسيط . ولكنه يحتوى في داخله على ألوان الطيف السبعة ، وعشت سنوات في هذا الضباب الهندي وهذه الماريجوانا الصوفية ومارست اليوجا وقرأتها في أصولها وتلقيت تعاليمها على أيدي أساتذة هنود .
وسيطرَت عليَّ فكرة التناسخ مدة طويلة وظهرت روايات لي مثل ( العنكبوت ) و ( الخروج من التابوت ) ، ثم بدأت أفيق على حالة من عدم الرضا وعدم الإقتناع .
واعترفت بيني وبين نفسي أن هذه الفكرة عن الله فيها الكثير من الخلط . ومرة أخرى كان العلم هو دليلي ومنقذي ومرشدي ، عكوفي على العلم وعلى الشريحة الحية تحت الميكروسكوب قال لي شيئاً آخر .
وحدة الوجود الهندية كانت عبارة شعرية صوفية . ولكنها غير صادقة .
والحقيقة المؤكدة التي يقولها العلم أن هناك وحدة في الخامة لا أكثر . وحدة في النسيج والسُنن الأولية والقوانين . وحدة في المادة الأولية التي بُنيَ منها كل شيء . فكل الحياة من نبات وحيوان وإنسان بنيت من تواليف الكربون مع الآيدروجين والأكسجين . ولهذا تتحول كلها إلى فحم بالإحتراق . وكل صنوف الحياة تقوم على الخلية الواحدة ومضاعفاتها .
ومرة أخرى نتعلم من الفلَك والكيمياء والعلوم النووية أن الكربون ذاته وكذلك جميع العناصر المختلفة جاءت من طبخ عنصر واحد في باطن الأفران النجمية الهائلة هو الآيدروجين .
الآيدروجين يتحول في باطن الأفران النجمية إلى هليوم وكربون وسليكون وكوبالت ونيكل وحديد إلى آخر قائمة العناصر وذلك بتفكيكه وإعادة تركيبه في درجات حرارة وضغوط هائلة ، وهذا يرد جميع صنوف الموجودات إلى خامة واحدة . إلى فتلة واحدة حريرية غُزِل منها الكون في تفصيلات وتصميمات وطُرُز مختلفة .
والخلاف بين صنف وصنف وبين مخلوق ومخلوق هو خلاف في العلاقات الكيفية والكمية . في المعادلة والشفرة التكوينية . لكن الخامة واحدة . وهذا سر الشعور بالنَسَب والقرابة والمصاهرة وصلة الرحم بين الإنسان والحيوان وبين الوَحش ومُروِضه وبين الأنف التي تشم والوهرة العاطرة وبين العين ومنظر الغروب الجميل .
هذا هو سر الهارموني والإنسجام ، إن كل الوجود أفراد أسرة واحدة من أب واحد ، وهو أمر لا يستتبع أبداً أن نقول إن الله هو الوجود , وأن الخالق هو المخلوق فهذا خلط صوفيّ غير وارد .
والأمر شبيه بحالة الناقد الذواقة الذي دخل معرضاً للرسم فاكتشف وحدة فنية بين جميع اللوحات . واكتشف أنها جميعاً مرسومة على الخامة نفسها . وبذات المجموعة الواحدة من الألوان , وأكثر من هذا أن أسلوب الرسم واحد .
والنتيجة الطبيعية أن يقفز إلى ذهن الناقد أن خالق جميع هذه اللوحات واحد . وأن الرسّام هو بيكاسو أو شاجال أو موديلياني . مثلاً ، فالوحدة بين الموجودات تعني وحدة خالقها .
ولكنها لا تعني أبداً أن هذه الموجدات هي ذاتها الخالق ، ولا يقول الناقد أبداً إن هذه الرسوم هي الرسّام ، إن وحدة الوجود الهندية شطحة صوفيّة خرافية . وهي تبسيط وجداني لا يصادق عليه العلم ولا يرتاح إليه العقل .
وإنما تقول النظرة العلمية المتأملة لظواهر الخلق والمخلوقات , إن هناك وحدة بينها . وحدة أسلوب ووحدة قوانين ووحدة خامات تعني جميعها أن خالقها واحد لم يشرك معه شريكاً يسمح بأسلوب غير أسلوبه .
وتقول لنا أيضاً إن هذا الخالق هو عقل كلّي شامل ومحيط , يُلهم مخلوقاته ويهديها في رحلة تطورها ويسلّحها بوسائل البقاء , فهو يخلق لبذور الأشجار الصحراوية أجنحةً لتستطيع أن تعبر الصحاري الجرداء بحثاً عن ماء وعن ظروف إنبات موالية .
وهو يزود بيضة البعوضة بكيسين للطفو لتطفو على الماء لحظة وضعها ولا تغرق . وما كان من الممكن للبعوضة أن تدرك قوانين أرشميدس للطفو فتصنع لبيضها تلك الأكياس .
وإنما هو العقل الكلي الشامل المحيط الذي خلق . هو الذي يزود كل مخلوق بأسباب حياته . وهو خالق متعالٍ على مخلوقاته . يعلم ما لا تعلم ويقدر على ما لا تقدر ويرى ما لا ترى ، فهو واحد أحد قادر عالم محيط سميع بصير خبير . وهو متعال يعطي الصفات ولا تحيط به صفات .
* *
والصلة دائماً معقودة بين هذا الخالق ومخلوقاته فهو أقرب إليها من دمها الذي يجري فيها ، وهو المبدِع الذي عزف الإبداع هذه المعزوفة الكونية الرائعة ، هو العادل الذي أحكم قوانينها وأقامها على نواميس دقيقة لا تخطئ ، وهكذا قدم لي العلم الفكرة الإسلامية الكاملة عن الله .
* *
أما القول بأزلية الوجود لأن العدم معدوم والوجود موجود , فهو جدل لفظي لا يقوم إلا على اللعب بالألفاظ ، والعدم في واقع الأمر غير معدوم ، وقيام العدم في التصور والفكر ينفي كونه معدوماً .
والعدم هو على الأكثر نفي ٌ لما نعلم ولكنه نفياً مطلقاً مساوياً للمحو المطلق . وفكرة العدم المطلق فرضية مثل فرضية الصفر الرياضي . ولا يصح الخلط بين الإفتراض والواقع ولا يصح تحميل الواقع فرضاً نظرياً , فنقول اعتسافاً إن العدم معدوم , ونعتبر أن هذا الكلام قضية وجودية نبني عليها أحكاماً في الواقع . هذا تناقض صريح وسفسطة جدلية ، وبالمثل القول بأن الوجود موجود . هنا نفس الخلط . فالوجود تجريد ذهني والموجود واقع حسيّ .
وكلمة العدم وكلمة الوجود تجريدات ذهنية كالصفر ،واللانهاية لا يصح أن نخلط بينها وبين الواقع الملموس المتعيَّن ،والكون الكائن المحدد أمام الحواس ،، الكون إذن ليس أزليا ً،، وإنما هو كون مخلوق كان لا بد له بدء بدليل آخرمن قاموس العلم هو ما نعرفه باسم القانون الثاني للديناميكا الحرارية ،، ويقرر هذا القانون أن الحرارة تنتقل من الساخن إلى البارد من الحرارة الأعلى إلى الحرارة الأدنى حتى يتعادل المستويان فيتوقف التبادل الحراري .
ولو كان الكون أبديا أزليا بدون ابتداء لكان التبادل الحراري قد توقف في تلك الآباد الطويلة المتاحة وبالتالي لتوقفت كل صور الحياة ولبردت النجوم وصارت بدرجة حرارة الصقيع والخواء حولها وانتهى كل شيء ،،إن هذا القانون هو ذاته دليل على أن الكون له بدء .
والقيامة الصغرى التي نراها حولنا في موت الحضارات وموت الأفراد وموت النجوم وموت الحيوان والنبات وتناهي اللحظات والحُقَبْ والدهور . هي لمحة أُخرى تدلنا على القيامة الكبرى التي لابد أن ينتهي إليها الكون .
إن العلم الحَق لم يكن أبداً مناقضاً للدين بل إنه دالٌ عليه مؤكَد بمعناه .
وإنما نصف العلم هو الذي يوقع العقل في الشبهة والشك .
وبخاصة إن كان ذلك العقل مزهوّاً بنفسه معتدّاً بعقلانيته . وبخاصة إذا دارت المعركة في عصر يتصور فيه العقل أنه كلّ شيء . وإذا حاصرت الإنسان شواهد حضارة ماديّة صارخة تزأر فيها الطائرات وسفن الفضاء والأقمار الصناعيّة . هاتفةً كلّ لحظة :
أنا المادة ..
أنا كل شيء ..
مقال / اللــــــّـــــه
من كتاب / رحلتي من الشك إلى الإيمان
للدكتور / مصطفى محمود ( رحمه الله ). ❝
⏤ مصطفى محمود -
❞ ان قضية العصر الحاضر لا تعدو ان تكون سفسطة علمية Scientific Sophism ذلك أن علماء هذا العصر يعالجون قضاياهم في ضوء العلم الحديث، غير أن هذه المعالجة لا تجدي نفعا، لأنها قائمة على العلم المحض و حسب، على حين لا بد من اعتبار أشياء أخرى، ومثال ذلك: ان نشرع في دراسة علمية لأشياء علمية ناقصة، فسوف تؤدي هذه المطالعة العلمية إلى نتائج غير علمية،، ناقصة، باطلة.. لقد عقد في دلهي في يناير 1964 مؤتمر دولي للمستشرقين، اشترك فيه الف ومائتان من العلماء من جميع انحاء العالم. وقدم أحدهم في هذا المؤتمر بحثا يدعي فيه مآثر كثيرة لمسلمي الهند ليست من عمل المسلمين، وانما هي من عمل الملوك الهندوس. وضرب لذلك مثلا بمنارة قطب في دلهي المنسوبة إلى الملك قطب الدين ايبك، على حين بناها الملك الهندوسي سامودرا جوبت قبل 23 قرنا،. وقد أخطأ المؤرخون المسلمون فنسبوها إلى الملك قطب الدين. ويستدل هذا البحث بان في المنارة المذكورة بعض أحجار قديمة نحتت قبل عصر الملك قطب الدين. وهذا كما يبدو استدلال علمي. إذ أن بعض أحجار المنارة فعلا من الصنف الذي ذكره العالم، ولكن هل يكفي مشاهدة بعض أحجار المنارة للبت في امر بانيها؟ أو انه لا بد من نواح أخرى كثيرة لنشاهدها في هذا الصدد. ومن هنا فان هذا التفسير لا يصدق على منارة قطب ككل. هذا تفسير. وهناك تفسير آخر، هو ان هذه الأحجار القديمة التي يوجد بعضها في المنارة. انما جاءت من أنقاض أبنية قديمة، كما هو معروف في كثير من الأبنية التاريخية الحجرية. ولا مناص من أن نقبل هذا التفسير الثاني حين نشاهد منارة قطب الدين في ضوء طابعها المعماري ورسومها وتصميمها.، والمسجد الناقص بجوارها، والمنارة الثانية التي لم تكمل.، ثم ننتهي إلى أن التفسير الأول ليس إلا قياسا خاطئا قائما على المغالطات. وهذا هو امر قضية المعارضين، فإنهم نظروا إلى حقائق ناقصة وجزئية، لا يتصل بعضها بالموضوع مطلقا، واعتقدوا ان الدراسة العلمية الحديثة قد أبطلت الدين، على حين اننا لو نظرنا إلى الواقع جملة وتفصيلا فسوف نصل إلى نتيجة تختلف عن الأولى كل الاختلاف. ❝ ⏤وحيد الدين خان❞ ان قضية العصر الحاضر لا تعدو ان تكون سفسطة علمية Scientific Sophism ذلك أن علماء هذا العصر يعالجون قضاياهم في ضوء العلم الحديث، غير أن هذه المعالجة لا تجدي نفعا، لأنها قائمة على العلم المحض و حسب، على حين لا بد من اعتبار أشياء أخرى، ومثال ذلك: ان نشرع في دراسة علمية لأشياء علمية ناقصة، فسوف تؤدي هذه المطالعة العلمية إلى نتائج غير علمية،، ناقصة، باطلة.
لقد عقد في دلهي في يناير 1964 مؤتمر دولي للمستشرقين، اشترك فيه الف ومائتان من العلماء من جميع انحاء العالم. وقدم أحدهم في هذا المؤتمر بحثا يدعي فيه مآثر كثيرة لمسلمي الهند ليست من عمل المسلمين، وانما هي من عمل الملوك الهندوس. وضرب لذلك مثلا بمنارة قطب في دلهي المنسوبة إلى الملك قطب الدين ايبك، على حين بناها الملك الهندوسي سامودرا جوبت قبل 23 قرنا،. وقد أخطأ المؤرخون المسلمون فنسبوها إلى الملك قطب الدين. ويستدل هذا البحث بان في المنارة المذكورة بعض أحجار قديمة نحتت قبل عصر الملك قطب الدين.
وهذا كما يبدو استدلال علمي. إذ أن بعض أحجار المنارة فعلا من الصنف الذي ذكره العالم، ولكن هل يكفي مشاهدة بعض أحجار المنارة للبت في امر بانيها؟ أو انه لا بد من نواح أخرى كثيرة لنشاهدها في هذا الصدد. ومن هنا فان هذا التفسير لا يصدق على منارة قطب ككل. هذا تفسير. وهناك تفسير آخر، هو ان هذه الأحجار القديمة التي يوجد بعضها في المنارة. انما جاءت من أنقاض أبنية قديمة، كما هو معروف في كثير من الأبنية التاريخية الحجرية. ولا مناص من أن نقبل هذا التفسير الثاني حين نشاهد منارة قطب الدين في ضوء طابعها المعماري ورسومها وتصميمها.، والمسجد الناقص بجوارها، والمنارة الثانية التي لم تكمل.، ثم ننتهي إلى أن التفسير الأول ليس إلا قياسا خاطئا قائما على المغالطات.
وهذا هو امر قضية المعارضين، فإنهم نظروا إلى حقائق ناقصة وجزئية، لا يتصل بعضها بالموضوع مطلقا، واعتقدوا ان الدراسة العلمية الحديثة قد أبطلت الدين، على حين اننا لو نظرنا إلى الواقع جملة وتفصيلا فسوف نصل إلى نتيجة تختلف عن الأولى كل الاختلاف. ❝
⏤ وحيد الدين خان -
❞ خطر لي ذات مساء أن أقوم ببحث في سراديب ذاكرتي .. فأرصد في ورقة كل ما أحفظه من أرقام .. رقم الباسبور ورقم العربة ورقم الشقة ورقم البطاقة العائلية وتليفونات من أعرف من الأصدقاء والزملاء .. وتليفونات المصالح والجرائد .. وأرقام جدول الضرب التي أحفظها غيباً وعمليات الجمع والطرح والقسمة الأولية التي أعرفها بالبداهة .. وتواريخ ميلادي وميلاد أولادي .. وثوابت الرياضة والطبيعة مثل النسبة التقريبية وسرعة الضوء وسرعة الصوت ومجموع زوايا المثلث ودرجة غليان الماء .. وما تعلمته في كلية الطب عن نسبة سكر الدم وعدد الكريات الحمراء وعدد الكريات البيضاء وحجم الدم وسرعة النبض وسرعة التنفس وجرعات العقاقير .. وفي لحظات تجمعت تحت يدي عدة صفحات من مئات الأرقام .. تداعت في ذهني ولمعت كالبرق وكأني حاسب إلكتروني .. وكان المشهد مذهلاً . كيف أحفظ هذا الكم الهائل من الأعداد .. كل عدد يبلغ طوله ستة أو سبعة أرقام ؟ وأين تختفي هذه الأرقام في تلافيف المخ ؟ وكيف يتم استدعاؤها فتلمع في الوعي كالبرق الخاطف ؟ وبأي أسلوب تصطف هذه الأرقام في أعداد متمايزة .. كل عدد له مذكرة تفسيرية ملحقة به تشرح دلالته ومعناه ؟ وكيف تتراكم المئات والمئات من هذه الأرقام في ذاكرتنا ولا تختلط ولايطمس بعضها بعضاً؟ وغير الأرقام .. هناك الأسماء والإصطلاحات والكلمات .. والأشكال والوجوه .. تزدحم بها رأسنا . وهناك معالم الطبيعة التي طُفنا بها والأماكن التي زرناها .. وهناك الروائح .. ومع كل رائحة صورة لامرأة عرفناها أو مشهد نذكره ولواعج وأشواق وقصص وسيناريو من آلاف اللقطات .. وهناك الطعوم .. والنكهات .. يأتي الطعم في الفم فيسيل اللعاب شوقاً أو يتحرك الغثيان إشمئزازاً .. ومع كل طعم .. يجري شريط يحكي عن وليمة دسمة ذات يوم أو جرعة دواء مريرة ومرض طويل ممض وأوجاع أليمة .. حتى لمسة النسيم الحريرية ورائحة أصداف الشاطئ تحفظها لنا الذاكرة فتهب علينا لفحات الهواء الرطيب مع ذكراها وكأننا نعيشها من جديد . حتى الأصوات والهمسات والوشوشات والصخَب والصراخ والضجيج والعويل والنشيج . وفاصل من موسيقى .. ومقطع من أغنية .. ولطمة على وجه .. وقرقعة عصاً على الظهر .. وحشرجة ألم .. كل هذا تحفظه الذاكرة وتسجله في دقة شديدة وأمانة .. ومعه بطاقة بالتاريخ والمناسبة وأسماء الأشخاص وظروف الواقعة ومحضر بالأقوال .. معجزة .. إسمها الذاكرة . إن معنا رقيباً حقيقياً يكتب بالورقة والقلم كل دبة نمل في قلوبنا ؟ وما نتخيل أحياناً أننا نسيناه نكتشف أننا لم ننسه وأنه موجود يظهر لنا فجأة في لحظة استرخاء أو حلم أو بعد كأس أو في عيادة طبيب نفسي .. وأحياناً يظهر في زلة لسان أو خطأ إملائي . لا شيء يُنسَى أبداً .. ولا شيء يضيع .. والماضي مكتوب بالفعل لحظة بلحظة ودقة قلب بدقة قلب . والسؤال الكبير بل اللغز المحير هو .. أين توجد هذه الصور .. أين هذا الأرشيف السري ؟ وهو سؤال حاول أن يجيب عليه أكثر من عالِم وأكثر من فيلسوف . الفلاسفة الماديون قالوا إن الذاكرة في المخ .. وإنها ليست أكثر من تغيرات كيميائية كهربائية تحدث لمادة المخ نتيجة الفعل العصبي للحوادث تماماً كما يحدث لشريط ريكوردر عند التسجيل .. وإن هذه اللفائف المسجلة تُحفَظ بالمخ وإنها تدور تلقائياً لحظة محاولة التذكر فتعيد ما كان .. في أمانة ودِقة . الذاكرة مجرد نقش وحفر على مادة الخلايا . ومصيرها أن تَبلَى وتتآكل كما تبلى النقوش وتتآكل وينتهي شأنها حينما ينتهي الإنسان بالموت وتتآكل خلاياه . رأي مريح وسهل ولكنه أوقع أصحابه في مطلب لم يستطيعوا الخروج منه .. فإذا كانت الذاكرة هي مجرد طارئ مادي يطرأ على مادة الخلايا فينبغي أن تتلف الذاكرة لأي تلف مادي مناظر في الخلايا المخية .. وينبغي أن يكون هناك توازٍ بين الحادثين .. كل نقص في ذاكرة معينة لا بد أن يقابله تلف في الخلايا المختصة المقابلة .. وهو أمر لا يشاهَد في إصابات المخ وأمراضه .. بل ما يشاهد هو العكس . يصاب مركز الكلمات فلا تصاب ذاكرة الكلمات بأي تلف , وإنما الذي يحدث هو عاهة في النطق .. في الأداء الحركي للعضلات التي تنطق الكلمات . إن الموتور هو الذي يتلف بتلف الخلايا .. أما الذاكرة .. أما صورة الكلمات في الذهن فتظل سليمة . ♦♦ وهذا دليل على أن وظيفة المخ ليست الذاكرة ولا التذكر . وإنما المخ هو مجرد سنترال يعطي التوصيلة . هو مجرد أداة تُعَبّر به الكلمة عن نفسها في وسط مادي فتصبح صوتًا مسموعًا .. كما يفعل الراديو حينما يحوّل الموجة اللاسلكية إلى نبض كهربائي مسموع .. فإذا أصيب الراديو بعطل فلا يكون معنى هذا العطل أن تتعطل موجة الأثير .. وإنما فقط يحدث شلل في جهاز النطق في الراديو . أما الموجة فتظل سليمة على حالها يمكن أن يلتقطها راديو آخر سليم . وهذا حال الذاكرة .. فهي صور وأفكار ورُؤى مستقلة مسكنها ومستقرها الروح وليس المخ ولا الجسد بحال .. وما المخ إلا وسيلة لنقل هذه الصور لتصبح كلمات منطوقة مسموعة في عالم ماديّ . فإذا أصيب المخ بتلف .. يصاب النطق بالتلف ولا تصاب الذاكرة لأن الذاكرة حكمها حكم الروح ولا يجري عليها ما يجري على الجسد . التوازي مفقود بين الإثنين مما يدل على أننا أمام مستويين (جسد .. وروح ) لا مستوى واحد إسمه المادة . وفي حوادث النسيان المرحلي .. الذي تنسى فيه مرحلة زمنية بعينها ( وهو الموضوع المحبب عند مؤلفي السينما المصريين ) .. ينسى المصاب فترة زمنية بعينها فتُمحى تمامًا من وعيه وتكشط من ذاكرته . وكان يتحتم تبعًا للنظرية المادية أن نعثر على تلف مخي جزئي مقابل ومناظر للفترة المنسية . لكن من الملاحَظ أن أغلب تلك الحالات هي حالات صدمة نفسية عامة وليست تلفًا جزئيًا محددًا . مرة أخرى نجد أن التوازي مفقود بين حجم الحادث وبين حجم التلف المادي . وفي حالات التلف المادي الشديد للمخ نتيجة الكسور أو الإلتهابات أو النمو السرطاني , حينما يبدأ النسيان الكامل يلاحظ دائمًا أن هذا النسيان يتخذ نظامًا خاصًا فتُنسَى في البداية أسماء الأعلام وآخر ما يُنسَى هي الكلمات الدالة على الأفعال . وهذا التسلسل المنتظم في النسيان في مقابل إصابة غير منتظمة .. وفي مقابل تلف مشوش أصاب المخ كيفما اتفق , هو مرة أخرى عدم توازٍ له معنى .. فهنا إصابة في الذاكرة لا علاقة لها من حيث المدى والكم والنظام بالإصابة المادية للمخ . وهكذا تتحطم النظرية المادية للذاكرة على حائط مسدود . ونجد أنفسنا أمام ظاهرة متعالية على الجسد وعلى خلايا المخ . وسوف تموت وتتعفن الخلايا المخية وتظل الذاكرة شاخصة حية بتفصيلاتها ودقائقها تذكرنا في حياتنا الروحية الثانية بكل ما فعلناه . ولم يكن الجسد إلا جهازاً تنفيذيّاً للفعل وللإفصاح عن النوايا في عالم الدنيا المادي .. كان مجرد أداة للروح ومطية لها . لم يكن المخ إلا سنترالًا .. وكابلات توصيل . وكل دوره هو أن يعطي التوصيلة من عالم الروح إلى عالم المادة أو كما يقول برجسون DONNER LA COMMUNICATION ....... يعطي الخط . كابلات الأعصاب تنقل مكنون الروح وتحوله إلى نبض إلكتروني لتنطق به عضلات اللسان على الطرف الآخر .. كما يفعل الراديو بالموجة اللاسلكية .. وهكذا نتبادل الكلام كأجساد في عالم مادي .. فإذا ماتت أجسادنا عدنا أرواحًا .. لنتذاكر ما فعلناه في دنيانا لحظة بلحظة حيث كل حرف وكل فعل مسجل . بل إن هناك نظريات علمية تمضي لأكثر من هذا فترى أن التحصيل هو في ذاته عملية تذكر لعلم قديم مكنوز ومسطور في الروح .. وليس تعلماً من السبورة .. فنحن لا نكتشف أن 2 × 2 = 4 من عدم , وإنما نولد بها .. وكل ما نفعله أننا نتذكرها .. وكذلك بداهات الرياضة والهندسة والمنطق .. كلها بداهات نولد بها مكنوزة فينا .. وكل ما يحدث أننا نتذكرها .. تُذكِرنا بها الخبرة الدنيوية كل لحظة . وبالمثل شخصيتنا .. نولد بها مسطورة في روحنا .. وكل ما يحدث أن الواقع الدنيوي يقدم المناسبات والملابسات والقالب المادي لتفصح هذه الشخصية عن خيرها وشرها .. فيسجل عليها فعلها . والتسجيل هو الأمر الجديد الذي يتم في الدنيا . الإنتقال من حالة النية إلى حالة التلبس . وهذا ما تُعبِّر عنه الأديان بأن يحق القول على المذنب بعد الإبتلاء والإختبار في الدنيا .. فتحق عليه الضلالة وتلزمه رتبته . وهو أمر قد سبق إليه علم الله .. علم الحصر لا علم الإلزام .. فالله لا يلزم أحداً بخطيئة ولا يقهره على شر .. وإنما كل واحد يتصرف على وفاق طبيعته الداخلية .. فعله هو ذاته .. وليس في ذلك أي معنى من معاني الجبر .. لأن هذه الطبيعة الداخلية هي التي نسميها أحيانًا الضمير وأحيانًا السريرة وأحيانًا الفؤاد .. ويسميها الله (( السر )) . (( يعلم السر وأخفَى )) . ونقول عنها في تعبيراتنا الشعبية عن الموت (( طلع السر الإلهي )) أي صعدت الروح إلى بارئها .. هذا السر المطلسم هو ابتداء حر ومبادرة أعتقها الله من كل القيود ليكون فعلها هو ذاتها وليكون هواها دالاً عليها . ومِن هنا لا يصح القول بالحتميات في المجال الإنساني أمثال حتمية الصراع الطبقي والجبرية التاريخية .. لأن الإنسان مجال حر وليس مسمارًا أو ترسًا في ماكينة . وكما لا يمكن التنبؤ بما يأتي به الغد في حياة فرد فإنه يستحيل القول بالحتم أو الجبر في مجال المجتمعات والتاريخ .. وكل ما يمكن القول به هو الترجيح والإحتمال بناء على مقدمات إحصائية .. وهو ترجيح يخطئ ويصيب ويحدث فيه تفاوت في طرفيه .. فمعدل عمر الإنسان في إنجلترا مثلاً هو ستون سنة .. وهذا المعدل معدل إحصائي مأخوذ من متوسطات أرقام .. وهو غير ملزم بالنسبة للفرد , فقد يعيش فرد مثل برناردشو في إنجلترا أكثر من تسعين سنة ويتجاوز المعدل . وقد يموت في سن العشرين في حادثة . وقد يموت وهو طفل بمرضٍ معدٍ .. ثم إن المعدل ذاته قابل للتذبذب من طرفيه صعودًا وهبوطًا من سنة لأخرى .. فلا يصح القول بالحتمية والجَبر في هذا الموضوع .. ولا يجوز إخضاع المجال الإنساني سواء كان فرداً أو مجتمعاً أو تاريخاً لقالب نظري أو معادلة أو حسبة إحصائية أو فرض فلسفي . إنما تأتي فكرة الحتمية الخاطئة من التصور الخاطئ للإنسان على أنه جسد بلا نفس وبلا روح وبلا عقل ..واعتبار النفس والعقل مجرد مجموعة الوظائف العليا للجهاز العصبي. ومن الواقع المشاهد من خضوع الجسم للقوانين الفسيولوجية يستنتج المفكر المادي أن الإنسان والإنسانية بأسرها مغلولة في القوانين المادية. وهكذا يجعل من الإنسان كتلة مادية أشبه بكتلة القمر محكومة في دورانه حول الأرض والشمس بالحتميات الفلكية. وينسى أن الإنسان يعيش في مستويين. مستوى الزمن الخارجي الموضوعي المادي .. زمن الساعة .. وفي هذا الزمن يرتبط بالمواعيد والضرورات الإجتماعية ويعيش في أَسر القوانين والحتميات . ومستوى زمنه الخاص الداخلي .. زمن الشعور وزمن الحلم .. وفي هذا المستوى يعيش حياة حرة بالفعل .. فيفكر ويحلم ويبتكر ويخترع و يقف من كل المجتمع و التاريخ موقف الثورة .. بل يستطيع أن ينقل هذه الثورة الداخلية إلى فعل خارجي فيقلب المجتمع و يغير التاريخ من أساسه كما حدث في كل الثورات التقدمية . هذه الثنائية هي صفة ينفرد بها الإنسان . وهذه الحياة الداخلية الحرة يختص بها الإنسان دون الجماد وهذه النفس التي يملكها تتصف بصفات مختلفة مغايرة لصفت الجماد .. فهنا نحن أمام وحدة لا امتداد لها في المكان .. هي الـ (( أنا )) تتصف بالحضور والديمومة والشخوص والكينونة والمثول الدائم في الوعي .. ثم هي تفرض نفسها على الواقع الخارجي وتغيره .. وتفرض نفسها على الجسد وتحكمه وتقوده وتعلو على ضروراته .. فتفرض عليه الصوم والحرمان إختياراً . بل قد تقوده إلى الموت فداء وتضحية .. مثل هذه النفس لا يمكن أن تكون مجرد ناتج ثانوي من نواتج الجسد وذيلًا تابعًا له ومادة تطورت منه .. مثل هذه النظريات المادية لا تفسر لنا شيئًا .. وإنما لابد لنا أن نسلم أن هذه النفس عالية على الجسد متعالية عليه وأنها من جوهر مفارق لجوهر الجسد وحاكم عليه .. فهي في واقع الأمر تستخدم الجسد كأداة لأغراضها ومطية لأهدافها كما يستخدم العقل المخ مجرد توصيلة أو سنترال . ولا بد أن يتداعى إلى ذهننا الإحتمال البديهي من أن هذه النفس لا يمكن أن يجري عليها ما يجري على الجسد من موت وتآكل وتعفن بحكم جوهرها الذي تشعر به متصفًا بالحضور والديمومة والشخوص في الوعي طوال الوقت .. فلا تتآكل كما يتآكل الجسد ولا هي تقع كما يقع الشعر ولا هي تبلى كما تبلى الأسنان . وإنه لأمر بديهي تمامًا أن نتصور بقاءها بعد الموت . فإذا نحن تأملنا ما يصاحب أفعالنا من تردد قبل اختيار القرار ثم شعور بالمسئولية في أثناء العمل ثم ندم أو راحة بعد تمامه .. فنحن نستنتج أننا أمام حالة مراقبة فطرية وفكرة ملحة بالحساب وبأن هناك خطأ وصوابًا . وإننا نعلم بداهةً وبالفطرة التي ولدنا بها أن العدل والنظام هو ناموس الوجود .. وأن المسئولية هي القاعدة . ويفترض لنا هذا الشعور الفطري القهري أن الظالم الذي أفلت من عقاب الأرض .. والقاتل الذي أفلت من محاسبة القانون البري الأرضي .. لابد أن يعاقَب ويحاسَب .. لأن العالم الذي نعيش فيه يفصح عن النظام والإنضباط من أصغر ذرة إلى أكبر فلك .. والعبث غير موجود إلا في عقولنا وأحكامنا المنحرفة . وفكرة العدل والنظام وضرورة العدل عالم آخر يتم فيه العدل والنظام والمحاسبة . كل هذا علم نولد به .. وحقيقة تقول بها الفطرة والبداهة . ولا غرابة في أن يعترف مفكر غربي ألماني وهو (( عمانويل كانت )) بهذه الحقيقة في كتابة (( نقد العقل العلمي )) . ولا غرابة في أن يصل إلى هذه النتيجة السليمة دون أن يقرأ قرآنًا . إنها الفطرة والبداهة التي تقوم عليها جميع العلوم . ولا حاجة لأن يقرأ العقل السليم الكتاب المقدس ليكتشف أن له روحًا و أن له حياة بعد الموت و أن هناك حساباًَ .. فالفطرة السليمة تضيء لصاحبها الطريق إلى هذه الحقائق . وهذا العلم الذي نولد به .. وهذه البداهة التي نولد بها .. تقوم شاهدة على جميع العلوم المكتسبة وملزمة لها .. فجميع العلوم المكتسبة يجوز فيها الخطأ والصواب .. أما العلم الذي نولد به فهو جزء من نظام الكون المحكم .. وهو الحقيقة الأولى التي نعمل على ضوئها نرى جميع الحقائق الفرعية .. وهي المعيار والمقياس .. وإذا فسد المعيار فسد كل شيء وأصبح كل شيء عبثًا في عبث وهو أمر غير صحيح . وإذا اتهمنا بالبداهة فإن جميع العلوم والمعارف سوف ينسحب عليها الإتهام وسوف تنهدم لأنها تقوم أصلاً على البداهات . فنحن هنا أمام أصل من أصول المعرفة ومرجع لا يجوز الشك فيه ( لأن هذا المرجع شأنه شأن الحياة ذاتها ) نحن أمام متن هو لحم المعرفة ودمها . وكما نأتي إلى الحياة مزودين بعضلات لنتحرك بها وندافع عن أنفسنا كذلك نولد مزودين بالبداهات الأولى لنحتكم إليها في إدراك الحق من الباطل والصواب من الخطأ . وأعلى درجات المعرفة هي ما يأتيك من داخلك , فأنت تستطيع أن تدرك وضعك ( هل أنت واقف أو جالس أو راقد ) دون أن تنظر إلى نفسك .. يأتيك هذا الإدراك وأنت مغمض العينين .. يأتيك من داخلك .. وتقوم هذه المعرفة حجة على أية مشاهدة . وحينما تقول .. أنا سعيد .. أنا شقيّ .. أنا أتألم .. فكلامك يقوم حجة بالغة ولا يجوز تكذيبه بحجة منطقية .. بل إن تناول هذا الأمر بالمنطق هو تنطع ولجاجة لا معنى لها .. فلا أحد أعرف بحال نفسك من نفسك ذاتها . وبالمثل شهادة الفطرة وحكم البداهة هي حجة على أعلى مستوى .. وحينما تقول الفطرة والبداهة مؤيدة بالعلم والفكر والتأمل حينما تقول بوجود الروح والنفس .. وبالحرية وبالمسئولية والمحاسبة , وحينما توحي بالتصرف على أساس أن في الكون نظامًا .. فنحن هنا أمام حجة على أعلى مستوى من اليقين . وهو يقين مثل يقين العيَان أو أكثر .. فالفطرة عضو مثل العين نولد به . وهو يقين أعلى من يقين العلم .. لأن الصدق العلمي هو صدق إحصائي والنظريات العلمية تُستنتَج من متوسطات الأرقام .. أما حكم البداهة فله صفة القطع والإطلاق 2 × 2 = 4 هي حقيقة مطلقة صادقة صدقًا مطلقًا , لا يجوز عليها ما يجوز من نسخ وتطور وتغير في نظريات العلم لأنها مقبولة بديهية . 1 + 1 = 2 مسألة لا تقبل الشك لأنها حقيقة ألقتها إلينا الفطرة من داخلنا وأوحت بها البداهة . وهي معرفة أولى جاءت إلينا مع شهادة الميلاد . لو أدرك الإنسان هذا لأراح واستراح .. ولوفّر على نفسه كثيراً من الجدل والشقشقة والسفسطة والمكابرة في مسألة الروح والجسد .. والعقل والمخ .. والحرية والجبر .. والمسئولية والحساب .. ولاكتفى بالإصغاء إلى ما تهمس به فطرته وما يُفتي به قلبه وما تشير به بصيرته . وذرة من الإخلاص أفضل من قناطير من الكتب . لنصغي إلى صوت نفوسنا وهمس بصائرنا في إخلاص شديد دون محاولة تشويه ذلك الصوت البكر بحبائل المنطق وشراك الحجج . وعلى من يشك في كلامي .. وعلى هواة الجدل والنقاش والمقارعة المنطقية أن يعودوا فيقرأوا مقالي من أوله . .. مقال / الروح من كتاب : رحلتي من الشك إلى الإيمان للدكتور : مصطفى محمود (رحمه الله ). ❝ ⏤مصطفى محمود❞ خطر لي ذات مساء أن أقوم ببحث في سراديب ذاكرتي . فأرصد في ورقة كل ما أحفظه من أرقام .
رقم الباسبور ورقم العربة ورقم الشقة ورقم البطاقة العائلية وتليفونات من أعرف من الأصدقاء والزملاء . وتليفونات المصالح والجرائد . وأرقام جدول الضرب التي أحفظها غيباً وعمليات الجمع والطرح والقسمة الأولية التي أعرفها بالبداهة . وتواريخ ميلادي وميلاد أولادي . وثوابت الرياضة والطبيعة مثل النسبة التقريبية وسرعة الضوء وسرعة الصوت ومجموع زوايا المثلث ودرجة غليان الماء . وما تعلمته في كلية الطب عن نسبة سكر الدم وعدد الكريات الحمراء وعدد الكريات البيضاء وحجم الدم وسرعة النبض وسرعة التنفس وجرعات العقاقير .
وفي لحظات تجمعت تحت يدي عدة صفحات من مئات الأرقام . تداعت في ذهني ولمعت كالبرق وكأني حاسب إلكتروني . وكان المشهد مذهلاً .
كيف أحفظ هذا الكم الهائل من الأعداد . كل عدد يبلغ طوله ستة أو سبعة أرقام ؟
وأين تختفي هذه الأرقام في تلافيف المخ ؟
وكيف يتم استدعاؤها فتلمع في الوعي كالبرق الخاطف ؟
وبأي أسلوب تصطف هذه الأرقام في أعداد متمايزة . كل عدد له مذكرة تفسيرية ملحقة به تشرح دلالته ومعناه ؟
وكيف تتراكم المئات والمئات من هذه الأرقام في ذاكرتنا ولا تختلط ولايطمس بعضها بعضاً؟
وغير الأرقام . هناك الأسماء والإصطلاحات والكلمات . والأشكال والوجوه . تزدحم بها رأسنا . وهناك معالم الطبيعة التي طُفنا بها والأماكن التي زرناها . وهناك الروائح . ومع كل رائحة صورة لامرأة عرفناها أو مشهد نذكره ولواعج وأشواق وقصص وسيناريو من آلاف اللقطات . وهناك الطعوم . والنكهات . يأتي الطعم في الفم فيسيل اللعاب شوقاً أو يتحرك الغثيان إشمئزازاً . ومع كل طعم . يجري شريط يحكي عن وليمة دسمة ذات يوم أو جرعة دواء مريرة ومرض طويل ممض وأوجاع أليمة . حتى لمسة النسيم الحريرية ورائحة أصداف الشاطئ تحفظها لنا الذاكرة فتهب علينا لفحات الهواء الرطيب مع ذكراها وكأننا نعيشها من جديد .
حتى الأصوات والهمسات والوشوشات والصخَب والصراخ والضجيج والعويل والنشيج .
وفاصل من موسيقى .
ومقطع من أغنية .
ولطمة على وجه .
وقرقعة عصاً على الظهر .
وحشرجة ألم .
كل هذا تحفظه الذاكرة وتسجله في دقة شديدة وأمانة . ومعه بطاقة بالتاريخ والمناسبة وأسماء الأشخاص وظروف الواقعة ومحضر بالأقوال . معجزة . إسمها الذاكرة .
إن معنا رقيباً حقيقياً يكتب بالورقة والقلم كل دبة نمل في قلوبنا ؟
وما نتخيل أحياناً أننا نسيناه نكتشف أننا لم ننسه وأنه موجود يظهر لنا فجأة في لحظة استرخاء أو حلم أو بعد كأس أو في عيادة طبيب نفسي . وأحياناً يظهر في زلة لسان أو خطأ إملائي .
لا شيء يُنسَى أبداً . ولا شيء يضيع . والماضي مكتوب بالفعل لحظة بلحظة ودقة قلب بدقة قلب .
والسؤال الكبير بل اللغز المحير هو . أين توجد هذه الصور . أين هذا الأرشيف السري ؟
وهو سؤال حاول أن يجيب عليه أكثر من عالِم وأكثر من فيلسوف .
الفلاسفة الماديون قالوا إن الذاكرة في المخ . وإنها ليست أكثر من تغيرات كيميائية كهربائية تحدث لمادة المخ نتيجة الفعل العصبي للحوادث تماماً كما يحدث لشريط ريكوردر عند التسجيل . وإن هذه اللفائف المسجلة تُحفَظ بالمخ وإنها تدور تلقائياً لحظة محاولة التذكر فتعيد ما كان . في أمانة ودِقة .
الذاكرة مجرد نقش وحفر على مادة الخلايا .
ومصيرها أن تَبلَى وتتآكل كما تبلى النقوش وتتآكل وينتهي شأنها حينما ينتهي الإنسان بالموت وتتآكل خلاياه .
رأي مريح وسهل ولكنه أوقع أصحابه في مطلب لم يستطيعوا الخروج منه .
فإذا كانت الذاكرة هي مجرد طارئ مادي يطرأ على مادة الخلايا فينبغي أن تتلف الذاكرة لأي تلف مادي مناظر في الخلايا المخية . وينبغي أن يكون هناك توازٍ بين الحادثين . كل نقص في ذاكرة معينة لا بد أن يقابله تلف في الخلايا المختصة المقابلة . وهو أمر لا يشاهَد في إصابات المخ وأمراضه . بل ما يشاهد هو العكس .
يصاب مركز الكلمات فلا تصاب ذاكرة الكلمات بأي تلف , وإنما الذي يحدث هو عاهة في النطق . في الأداء الحركي للعضلات التي تنطق الكلمات . إن الموتور هو الذي يتلف بتلف الخلايا . أما الذاكرة . أما صورة الكلمات في الذهن فتظل سليمة .
♦♦ وهذا دليل على أن وظيفة المخ ليست الذاكرة ولا التذكر .
وإنما المخ هو مجرد سنترال يعطي التوصيلة .
هو مجرد أداة تُعَبّر به الكلمة عن نفسها في وسط مادي فتصبح صوتًا مسموعًا . كما يفعل الراديو حينما يحوّل الموجة اللاسلكية إلى نبض كهربائي مسموع . فإذا أصيب الراديو بعطل فلا يكون معنى هذا العطل أن تتعطل موجة الأثير . وإنما فقط يحدث شلل في جهاز النطق في الراديو . أما الموجة فتظل سليمة على حالها يمكن أن يلتقطها راديو آخر سليم .
وهذا حال الذاكرة . فهي صور وأفكار ورُؤى مستقلة مسكنها ومستقرها الروح وليس المخ ولا الجسد بحال . وما المخ إلا وسيلة لنقل هذه الصور لتصبح كلمات منطوقة مسموعة في عالم ماديّ .
فإذا أصيب المخ بتلف . يصاب النطق بالتلف ولا تصاب الذاكرة لأن الذاكرة حكمها حكم الروح ولا يجري عليها ما يجري على الجسد .
التوازي مفقود بين الإثنين مما يدل على أننا أمام مستويين (جسد . وروح ) لا مستوى واحد إسمه المادة .
وفي حوادث النسيان المرحلي . الذي تنسى فيه مرحلة زمنية بعينها ( وهو الموضوع المحبب عند مؤلفي السينما المصريين ) . ينسى المصاب فترة زمنية بعينها فتُمحى تمامًا من وعيه وتكشط من ذاكرته .
وكان يتحتم تبعًا للنظرية المادية أن نعثر على تلف مخي جزئي مقابل ومناظر للفترة المنسية .
لكن من الملاحَظ أن أغلب تلك الحالات هي حالات صدمة نفسية عامة وليست تلفًا جزئيًا محددًا .
مرة أخرى نجد أن التوازي مفقود بين حجم الحادث وبين حجم التلف المادي .
وفي حالات التلف المادي الشديد للمخ نتيجة الكسور أو الإلتهابات أو النمو السرطاني , حينما يبدأ النسيان الكامل يلاحظ دائمًا أن هذا النسيان يتخذ نظامًا خاصًا فتُنسَى في البداية أسماء الأعلام وآخر ما يُنسَى هي الكلمات الدالة على الأفعال .
وهذا التسلسل المنتظم في النسيان في مقابل إصابة غير منتظمة . وفي مقابل تلف مشوش أصاب المخ كيفما اتفق , هو مرة أخرى عدم توازٍ له معنى . فهنا إصابة في الذاكرة لا علاقة لها من حيث المدى والكم والنظام بالإصابة المادية للمخ .
وهكذا تتحطم النظرية المادية للذاكرة على حائط مسدود .
ونجد أنفسنا أمام ظاهرة متعالية على الجسد وعلى خلايا المخ .
وسوف تموت وتتعفن الخلايا المخية وتظل الذاكرة شاخصة حية بتفصيلاتها ودقائقها تذكرنا في حياتنا الروحية الثانية بكل ما فعلناه .
ولم يكن الجسد إلا جهازاً تنفيذيّاً للفعل وللإفصاح عن النوايا في عالم الدنيا المادي . كان مجرد أداة للروح ومطية لها .
لم يكن المخ إلا سنترالًا . وكابلات توصيل .
وكل دوره هو أن يعطي التوصيلة من عالم الروح إلى عالم المادة أو كما يقول برجسون DONNER LA COMMUNICATION .... يعطي الخط .
كابلات الأعصاب تنقل مكنون الروح وتحوله إلى نبض إلكتروني لتنطق به عضلات اللسان على الطرف الآخر . كما يفعل الراديو بالموجة اللاسلكية .
وهكذا نتبادل الكلام كأجساد في عالم مادي . فإذا ماتت أجسادنا عدنا أرواحًا . لنتذاكر ما فعلناه في دنيانا لحظة بلحظة حيث كل حرف وكل فعل مسجل .
بل إن هناك نظريات علمية تمضي لأكثر من هذا فترى أن التحصيل هو في ذاته عملية تذكر لعلم قديم مكنوز ومسطور في الروح . وليس تعلماً من السبورة . فنحن لا نكتشف أن 2 × 2 = 4 من عدم , وإنما نولد بها . وكل ما نفعله أننا نتذكرها . وكذلك بداهات الرياضة والهندسة والمنطق . كلها بداهات نولد بها مكنوزة فينا . وكل ما يحدث أننا نتذكرها . تُذكِرنا بها الخبرة الدنيوية كل لحظة .
وبالمثل شخصيتنا . نولد بها مسطورة في روحنا . وكل ما يحدث أن الواقع الدنيوي يقدم المناسبات والملابسات والقالب المادي لتفصح هذه الشخصية عن خيرها وشرها . فيسجل عليها فعلها .
والتسجيل هو الأمر الجديد الذي يتم في الدنيا .
الإنتقال من حالة النية إلى حالة التلبس .
وهذا ما تُعبِّر عنه الأديان بأن يحق القول على المذنب بعد الإبتلاء والإختبار في الدنيا . فتحق عليه الضلالة وتلزمه رتبته .
وهو أمر قد سبق إليه علم الله . علم الحصر لا علم الإلزام . فالله لا يلزم أحداً بخطيئة ولا يقهره على شر . وإنما كل واحد يتصرف على وفاق طبيعته الداخلية . فعله هو ذاته . وليس في ذلك أي معنى من معاني الجبر . لأن هذه الطبيعة الداخلية هي التي نسميها أحيانًا الضمير وأحيانًا السريرة وأحيانًا الفؤاد . ويسميها الله (( السر )) .
(( يعلم السر وأخفَى )) .
ونقول عنها في تعبيراتنا الشعبية عن الموت (( طلع السر الإلهي )) أي صعدت الروح إلى بارئها .
هذا السر المطلسم هو ابتداء حر ومبادرة أعتقها الله من كل القيود ليكون فعلها هو ذاتها وليكون هواها دالاً عليها .
ومِن هنا لا يصح القول بالحتميات في المجال الإنساني أمثال حتمية الصراع الطبقي والجبرية التاريخية . لأن الإنسان مجال حر وليس مسمارًا أو ترسًا في ماكينة .
وكما لا يمكن التنبؤ بما يأتي به الغد في حياة فرد فإنه يستحيل القول بالحتم أو الجبر في مجال المجتمعات والتاريخ . وكل ما يمكن القول به هو الترجيح والإحتمال بناء على مقدمات إحصائية . وهو ترجيح يخطئ ويصيب ويحدث فيه تفاوت في طرفيه . فمعدل عمر الإنسان في إنجلترا مثلاً هو ستون سنة . وهذا المعدل معدل إحصائي مأخوذ من متوسطات أرقام . وهو غير ملزم بالنسبة للفرد , فقد يعيش فرد مثل برناردشو في إنجلترا أكثر من تسعين سنة ويتجاوز المعدل . وقد يموت في سن العشرين في حادثة . وقد يموت وهو طفل بمرضٍ معدٍ .
ثم إن المعدل ذاته قابل للتذبذب من طرفيه صعودًا وهبوطًا من سنة لأخرى .
فلا يصح القول بالحتمية والجَبر في هذا الموضوع . ولا يجوز إخضاع المجال الإنساني سواء كان فرداً أو مجتمعاً أو تاريخاً لقالب نظري أو معادلة أو حسبة إحصائية أو فرض فلسفي .
إنما تأتي فكرة الحتمية الخاطئة من التصور الخاطئ للإنسان على أنه جسد بلا نفس وبلا روح وبلا عقل .واعتبار النفس والعقل مجرد مجموعة الوظائف العليا للجهاز العصبي.
ومن الواقع المشاهد من خضوع الجسم للقوانين الفسيولوجية يستنتج المفكر المادي أن الإنسان والإنسانية بأسرها مغلولة في القوانين المادية.
وهكذا يجعل من الإنسان كتلة مادية أشبه بكتلة القمر محكومة في دورانه حول الأرض والشمس بالحتميات الفلكية.
وينسى أن الإنسان يعيش في مستويين.
مستوى الزمن الخارجي الموضوعي المادي . زمن الساعة . وفي هذا الزمن يرتبط بالمواعيد والضرورات الإجتماعية ويعيش في أَسر القوانين والحتميات .
ومستوى زمنه الخاص الداخلي . زمن الشعور وزمن الحلم . وفي هذا المستوى يعيش حياة حرة بالفعل . فيفكر ويحلم ويبتكر ويخترع و يقف من كل المجتمع و التاريخ موقف الثورة . بل يستطيع أن ينقل هذه الثورة الداخلية إلى فعل خارجي فيقلب المجتمع و يغير التاريخ من أساسه كما حدث في كل الثورات التقدمية .
هذه الثنائية هي صفة ينفرد بها الإنسان .
وهذه الحياة الداخلية الحرة يختص بها الإنسان دون الجماد
وهذه النفس التي يملكها تتصف بصفات مختلفة مغايرة لصفت الجماد . فهنا نحن أمام وحدة لا امتداد لها في المكان .
هي الـ (( أنا )) تتصف بالحضور والديمومة والشخوص والكينونة والمثول الدائم في الوعي . ثم هي تفرض نفسها على الواقع الخارجي وتغيره . وتفرض نفسها على الجسد وتحكمه وتقوده وتعلو على ضروراته . فتفرض عليه الصوم والحرمان إختياراً .
بل قد تقوده إلى الموت فداء وتضحية .
مثل هذه النفس لا يمكن أن تكون مجرد ناتج ثانوي من نواتج الجسد وذيلًا تابعًا له ومادة تطورت منه . مثل هذه النظريات المادية لا تفسر لنا شيئًا . وإنما لابد لنا أن نسلم أن هذه النفس عالية على الجسد متعالية عليه وأنها من جوهر مفارق لجوهر الجسد وحاكم عليه . فهي في واقع الأمر تستخدم الجسد كأداة لأغراضها ومطية لأهدافها كما يستخدم العقل المخ مجرد توصيلة أو سنترال .
ولا بد أن يتداعى إلى ذهننا الإحتمال البديهي من أن هذه النفس لا يمكن أن يجري عليها ما يجري على الجسد من موت وتآكل وتعفن بحكم جوهرها الذي تشعر به متصفًا بالحضور والديمومة والشخوص في الوعي طوال الوقت . فلا تتآكل كما يتآكل الجسد ولا هي تقع كما يقع الشعر ولا هي تبلى كما تبلى الأسنان .
وإنه لأمر بديهي تمامًا أن نتصور بقاءها بعد الموت .
فإذا نحن تأملنا ما يصاحب أفعالنا من تردد قبل اختيار القرار ثم شعور بالمسئولية في أثناء العمل ثم ندم أو راحة بعد تمامه . فنحن نستنتج أننا أمام حالة مراقبة فطرية وفكرة ملحة بالحساب وبأن هناك خطأ وصوابًا . وإننا نعلم بداهةً وبالفطرة التي ولدنا بها أن العدل والنظام هو ناموس الوجود . وأن المسئولية هي القاعدة .
ويفترض لنا هذا الشعور الفطري القهري أن الظالم الذي أفلت من عقاب الأرض . والقاتل الذي أفلت من محاسبة القانون البري الأرضي . لابد أن يعاقَب ويحاسَب . لأن العالم الذي نعيش فيه يفصح عن النظام والإنضباط من أصغر ذرة إلى أكبر فلك . والعبث غير موجود إلا في عقولنا وأحكامنا المنحرفة .
وفكرة العدل والنظام وضرورة العدل عالم آخر يتم فيه العدل والنظام والمحاسبة .
كل هذا علم نولد به . وحقيقة تقول بها الفطرة والبداهة .
ولا غرابة في أن يعترف مفكر غربي ألماني وهو (( عمانويل كانت )) بهذه الحقيقة في كتابة (( نقد العقل العلمي )) .
ولا غرابة في أن يصل إلى هذه النتيجة السليمة دون أن يقرأ قرآنًا .
إنها الفطرة والبداهة التي تقوم عليها جميع العلوم .
ولا حاجة لأن يقرأ العقل السليم الكتاب المقدس ليكتشف أن له روحًا و أن له حياة بعد الموت و أن هناك حساباًَ . فالفطرة السليمة تضيء لصاحبها الطريق إلى هذه الحقائق .
وهذا العلم الذي نولد به . وهذه البداهة التي نولد بها . تقوم شاهدة على جميع العلوم المكتسبة وملزمة لها . فجميع العلوم المكتسبة يجوز فيها الخطأ والصواب . أما العلم الذي نولد به فهو جزء من نظام الكون المحكم . وهو الحقيقة الأولى التي نعمل على ضوئها نرى جميع الحقائق الفرعية . وهي المعيار والمقياس . وإذا فسد المعيار فسد كل شيء وأصبح كل شيء عبثًا في عبث وهو أمر غير صحيح .
وإذا اتهمنا بالبداهة فإن جميع العلوم والمعارف سوف ينسحب عليها الإتهام وسوف تنهدم لأنها تقوم أصلاً على البداهات .
فنحن هنا أمام أصل من أصول المعرفة ومرجع لا يجوز الشك فيه ( لأن هذا المرجع شأنه شأن الحياة ذاتها ) نحن أمام متن هو لحم المعرفة ودمها . وكما نأتي إلى الحياة مزودين بعضلات لنتحرك بها وندافع عن أنفسنا كذلك نولد مزودين بالبداهات الأولى لنحتكم إليها في إدراك الحق من الباطل والصواب من الخطأ .
وأعلى درجات المعرفة هي ما يأتيك من داخلك , فأنت تستطيع أن تدرك وضعك ( هل أنت واقف أو جالس أو راقد ) دون أن تنظر إلى نفسك . يأتيك هذا الإدراك وأنت مغمض العينين . يأتيك من داخلك . وتقوم هذه المعرفة حجة على أية مشاهدة .
وحينما تقول . أنا سعيد . أنا شقيّ . أنا أتألم . فكلامك يقوم حجة بالغة ولا يجوز تكذيبه بحجة منطقية . بل إن تناول هذا الأمر بالمنطق هو تنطع ولجاجة لا معنى لها . فلا أحد أعرف بحال نفسك من نفسك ذاتها .
وبالمثل شهادة الفطرة وحكم البداهة هي حجة على أعلى مستوى . وحينما تقول الفطرة والبداهة مؤيدة بالعلم والفكر والتأمل حينما تقول بوجود الروح والنفس . وبالحرية وبالمسئولية والمحاسبة , وحينما توحي بالتصرف على أساس أن في الكون نظامًا . فنحن هنا أمام حجة على أعلى مستوى من اليقين .
وهو يقين مثل يقين العيَان أو أكثر . فالفطرة عضو مثل العين نولد به .
وهو يقين أعلى من يقين العلم . لأن الصدق العلمي هو صدق إحصائي والنظريات العلمية تُستنتَج من متوسطات الأرقام . أما حكم البداهة فله صفة القطع والإطلاق
2 × 2 = 4 هي حقيقة مطلقة صادقة صدقًا مطلقًا , لا يجوز عليها ما يجوز من نسخ وتطور وتغير في نظريات العلم لأنها مقبولة بديهية .
1 + 1 = 2 مسألة لا تقبل الشك لأنها حقيقة ألقتها إلينا الفطرة من داخلنا وأوحت بها البداهة .
وهي معرفة أولى جاءت إلينا مع شهادة الميلاد .
لو أدرك الإنسان هذا لأراح واستراح . ولوفّر على نفسه كثيراً من الجدل والشقشقة والسفسطة والمكابرة في مسألة الروح والجسد . والعقل والمخ . والحرية والجبر . والمسئولية والحساب . ولاكتفى بالإصغاء إلى ما تهمس به فطرته وما يُفتي به قلبه وما تشير به بصيرته .
وذرة من الإخلاص أفضل من قناطير من الكتب .
لنصغي إلى صوت نفوسنا وهمس بصائرنا في إخلاص شديد دون محاولة تشويه ذلك الصوت البكر بحبائل المنطق وشراك الحجج .
وعلى من يشك في كلامي . وعلى هواة الجدل والنقاش والمقارعة المنطقية أن يعودوا فيقرأوا مقالي من أوله .
.
مقال / الروح
من كتاب : رحلتي من الشك إلى الإيمان
للدكتور : مصطفى محمود (رحمه الله ). ❝
⏤ مصطفى محمود