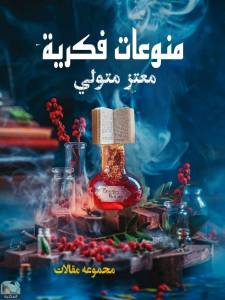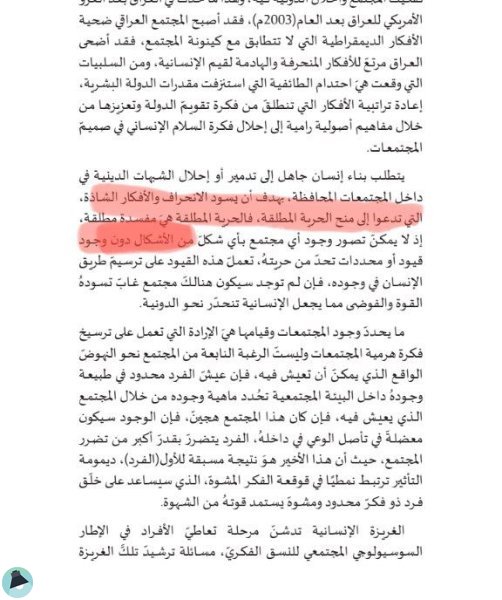❞ الدينية ❝ 💬 اقتباسات من الكتب 📖
- الدينية 💬 اقتباسات من الكتب 📖
█ حصريا تحميل كتاب مجاناً PDF اونلاين 2025
إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
اقتباسات في ❞الدينية❝
-
❞ الثقافة الإجتماعية الثقافة الإجتماعية جزءا هام في حياتنا اليوميه لاتنتهي أبدا تتجدد دائما مع تغيير الأفراد والحقب الزمنية والظروف البيئية، فهى عملية إبداعية متجددة تعبر عن آداب الحياة الإجتماعية؛ حيث أن الثقافة بمفهومها الإجتماعي تعكس مدى معرفة أبناء المجتمع للمنظومة الإجتماعية التى يعيشون فيها من عادات وتقاليد ولغة وأعراف ومكتسبات ونظم إجتماعية سائدة تطغى على المكونات الشخصية والسلوكية الفردية لأفراد المجتمع دون أن تخل تلك المكتسبات الشخصية والأطر العامة التى تحرك السلوك العام في المجتمع بالثوابت العامة والرئيسية كالعقائد الدينية والتشريعات والقوانين الوضعية....وغيرها، وينبغي على أفراد المجتمع أن يتماشوا مع التجديد بهدف التطوير والتعايش والبناء يقول العالم الإجتماعي البريطاني الانثربولوجى ˝لإدوارد تايلور ˝ [ الثقافة أو الحضارة بمعناها الإناسى الأوسع، هى ذلك الكل المركب الذى يشمل المعرفة والمعتقدات والفن والأخلاق والقانون والأعراف والقدرات والعادات الأخرى التى يكتسبها الإنسان بإعتباره عضوا في المجتمع ] إن الثقافة الإجتماعية ليست مجموعة من الأفكار فحسب ولكنها نظرية في السلوك ترسم طريق الحياة إجمالا. ولم تعد ثقافتتا الإجتماعية منغلقة على نفسها، معزولة عما يدور حولها من متغيرات في جميع مجالات الحياة، وذلك في ظل ظروف العصر الحديث والتقدم العلمي والتكنولوجي وثورة الإتصالات وهنا يمكننا القول أن الثقافة تمثل قوام الحياة الإجتماعية وظيفة وحركة، فليس من عمل إجتماعي يتم خارج دائرتها، حيث تيسر للإنسان سبل التفاعل مع محيطة مادة وبشرا ومؤسسات إن السلوكيات الإجتماعية اليومية للأفراد تعتمد على مدى ثقافتهم الإجتماعية وإدراكهم لطبيعة الأمور التى يتواجدون فيها بتعاملهم فيما بينهم وتقبلهم للآخر والحوار، وتسخيرهم للمقدرات الطبيعية مما يجعل الفرد يستطيع أن يحقق التوازن بين نفسه والمجتمع الذى يعيش فيه.. ❝ ⏤معتز متولي❞ الثقافة الإجتماعية
الثقافة الإجتماعية جزءا هام في حياتنا اليوميه لاتنتهي أبدا تتجدد دائما مع تغيير الأفراد والحقب الزمنية والظروف البيئية، فهى عملية إبداعية متجددة تعبر عن آداب الحياة الإجتماعية؛ حيث أن الثقافة بمفهومها الإجتماعي تعكس مدى معرفة أبناء المجتمع للمنظومة الإجتماعية التى يعيشون فيها من عادات وتقاليد ولغة وأعراف ومكتسبات ونظم إجتماعية سائدة تطغى على المكونات الشخصية والسلوكية الفردية لأفراد المجتمع دون أن تخل تلك المكتسبات الشخصية والأطر العامة التى تحرك السلوك العام في المجتمع بالثوابت العامة والرئيسية كالعقائد الدينية والتشريعات والقوانين الوضعية..وغيرها، وينبغي على أفراد المجتمع أن يتماشوا مع التجديد بهدف التطوير والتعايش والبناء
يقول العالم الإجتماعي البريطاني الانثربولوجى ˝لإدوارد تايلور ˝
[ الثقافة أو الحضارة بمعناها الإناسى الأوسع، هى ذلك الكل المركب الذى يشمل المعرفة والمعتقدات والفن والأخلاق والقانون والأعراف والقدرات والعادات الأخرى التى يكتسبها الإنسان بإعتباره عضوا في المجتمع ]
إن الثقافة الإجتماعية ليست مجموعة من الأفكار فحسب ولكنها نظرية في السلوك ترسم طريق الحياة إجمالا. ولم تعد ثقافتتا الإجتماعية منغلقة على نفسها، معزولة عما يدور حولها من متغيرات في جميع مجالات الحياة، وذلك في ظل ظروف العصر الحديث والتقدم العلمي والتكنولوجي وثورة الإتصالات
وهنا يمكننا القول أن الثقافة تمثل قوام الحياة الإجتماعية وظيفة وحركة، فليس من عمل إجتماعي يتم خارج دائرتها، حيث تيسر للإنسان سبل التفاعل مع محيطة مادة وبشرا ومؤسسات
إن السلوكيات الإجتماعية اليومية للأفراد تعتمد على مدى ثقافتهم الإجتماعية وإدراكهم لطبيعة الأمور التى يتواجدون فيها بتعاملهم فيما بينهم وتقبلهم للآخر والحوار، وتسخيرهم للمقدرات الطبيعية مما يجعل الفرد يستطيع أن يحقق التوازن بين نفسه والمجتمع الذى يعيش فيه. ❝
⏤ معتز متولي -
❞ فإن السيرة النبوية وسير الصحابة وتاريخهم من أقوى مصادر القوة الإيمانية والعاطفة الدينية التي لا تزال هذه الأمة والدعوات الدينية تقتبس منها شعلة الإيمان وتشعل بها مجامر القلوب التي يسرع انطفاؤها وخمودها في مهب الرياح والعواطف المادية والتي إذا انطفأت فقدت هذه الأمة قوتها وميزتها وتأثيرها وأصبحت جثة هامدة تحملها الحياة على أكتافها.. ❝ ⏤محمد يوسف الكاندهلوى❞ فإن السيرة النبوية وسير الصحابة وتاريخهم من أقوى مصادر القوة الإيمانية والعاطفة الدينية التي لا تزال هذه الأمة والدعوات الدينية تقتبس منها شعلة الإيمان وتشعل بها مجامر القلوب التي يسرع انطفاؤها وخمودها في مهب الرياح والعواطف المادية والتي إذا انطفأت فقدت هذه الأمة قوتها وميزتها وتأثيرها وأصبحت جثة هامدة تحملها الحياة على أكتافها. ❝
⏤ محمد يوسف الكاندهلوى -
❞ عرّف بعض الفلاسفة الفن بأنه هو التعبير المادي لفكرة دينية. والدين والفن توأمان منذ البداية, فالفن يولد في معظم الحالات في خدمة الدين, فتماثيل الآلهة وصورها وأماكن العبادة ومستلزماتها كانت أهم مظاهر الفن منذ البداية. كان للدين الإسلامي موقف حيال الفنون التطبيقية, يختلف عن موقف الدينين السابقين؛ فهو لم يستعملها في طقوسه الدينية كما هو الحال في المسيحية, كما أنه لم ينكرها كما فعل الدين اليهودي. أما عن كراهية التصوير عند المسلمين فأساسها أحاديث تنسب إلى النبي عليه السلام, والقصد منها البعد عن الوثنية وعبادة الأصنام, ذلك فضلا عن كراهية الترف في ذلك العصر الذي ساد فيه الزهد والتقشف. والجهاد في سبيل الله. أما القول بأن الإسلام حرم التصوير فليس له أساس من الصحة, إذ لم يعرض القرآن الكريم للتصوير بشيء, وقد كان لهذه الكراهية أثرها في الفن الإسلامي, الذي ابتعد عن نحت التماثيل المجسمة, وكذلك اللوحات الفنية المستقلة قام الفن الإسلامي على أسس من الفنون التي كانت سائدة في البلاد التي فتحها العرب والتي أصبحت تكون جزءا من الدولة الإسلامية, وهي الفن الساساني والبيزنطي والروماني والفن الهندي وفنون الصين وآسيا الصغري, وإن اختلف علماء الآثار في تحديد نصيب كل فن من الفنون القديمة في بناء الفن الإسلامي الجديد. ❝ ⏤حامد سعيد❞ عرّف بعض الفلاسفة الفن بأنه هو التعبير المادي لفكرة دينية. والدين والفن توأمان منذ البداية, فالفن يولد في معظم الحالات في خدمة الدين, فتماثيل الآلهة وصورها وأماكن العبادة ومستلزماتها كانت أهم مظاهر الفن منذ البداية.
كان للدين الإسلامي موقف حيال الفنون التطبيقية, يختلف عن موقف الدينين السابقين؛ فهو لم يستعملها في طقوسه الدينية كما هو الحال في المسيحية, كما أنه لم ينكرها كما فعل الدين اليهودي. أما عن كراهية التصوير عند المسلمين فأساسها أحاديث تنسب إلى النبي عليه السلام, والقصد منها البعد عن الوثنية وعبادة الأصنام, ذلك فضلا عن كراهية الترف في ذلك العصر الذي ساد فيه الزهد والتقشف. والجهاد في سبيل الله. أما القول بأن الإسلام حرم التصوير فليس له أساس من الصحة, إذ لم يعرض القرآن الكريم للتصوير بشيء, وقد كان لهذه الكراهية أثرها في الفن الإسلامي, الذي ابتعد عن نحت التماثيل المجسمة, وكذلك اللوحات الفنية المستقلة
قام الفن الإسلامي على أسس من الفنون التي كانت سائدة في البلاد التي فتحها العرب والتي أصبحت تكون جزءا من الدولة الإسلامية, وهي الفن الساساني والبيزنطي والروماني والفن الهندي وفنون الصين وآسيا الصغري, وإن اختلف علماء الآثار في تحديد نصيب كل فن من الفنون القديمة في بناء الفن الإسلامي الجديد. ❝
⏤ حامد سعيد -
❞ لماذا نجد البعض يكره الفلسفة؟ تُعتبر الفلسفة من أقدم العلوم الإنسانية التي تسعى إلى فهم الوجود والإنسان والعالم من حوله عبر التفكير العقلاني والنقدي. وعلى الرغم من أنها قد ارتبطت تاريخيًا بتطور الفكر البشري وتقدمه، إلا أنها قد وُجهت بكثير من الرفض والعداء في بعض المجتمعات، خاصة تلك التي تستند إلى الدين كمحور رئيسي في تكوينها الثقافي والفكري. فكيف يمكن تفسير هذه العلاقة المتوترة بين الدين والفلسفة؟ ولماذا نجد في العديد من الأحيان أن الأنظمة التي بنت ركائزها على الدين تعمل على تهميش الفلسفة في مناهجها التعليمية؟ الدين والفلسفة، على الرغم من أنهما يسعيان إلى الإجابة عن الأسئلة الكبرى المتعلقة بالحياة والوجود، إلا أنهما يفعلان ذلك بطرق مختلفة. الدين يقدم إجابات قائمة على الإيمان والتسليم بسلطة عليا تتجاوز حدود العقل البشري، في حين تسعى الفلسفة إلى فهم هذه الأسئلة عبر المنطق والتحليل العقلاني. هذا التباين في المناهج أدى إلى نوع من التعارض الظاهري بين الطرفين. يرى البعض أن الفلسفة تطرح تساؤلات قد تُضعف الإيمان الديني، لأنها تدعو إلى التفكير النقدي وتفحص المعتقدات والأسس التي تقوم عليها. ولأن الدين يتطلب في كثير من الأحيان إيمانًا وتسليمًا دون تساؤل، فإن هذا النقد الفلسفي قد يُنظر إليه على أنه تهديد للاستقرار الديني والعقائدي من ناحية أخرى، تلعب الأنظمة الدينية دورًا كبيرًا في تشكيل القيم والأخلاق والهويات الفردية والجماعية في المجتمعات. ولهذا، قد تنظر هذه الأنظمة إلى الفلسفة باعتبارها تحديًا لهذا النظام المتكامل، لأنها قد تدعو إلى إعادة النظر في بعض الأسس العقائدية أو الاجتماعية التي تُعتبر مقدسة أو ثابتة. في هذا السياق، يصبح تغييب الفلسفة من المناهج التعليمية وسيلة للحفاظ على هيمنة الفكر الديني، وذلك لضمان بقاء الأجيال الجديدة متشبثة بالقيم والعقائد التي تمثلها هذه الأنظمة. فالأنظمة التي بنت ركائزها على الدين قد ترى في الفلسفة خطرًا يمكن أن يُزعزع استقرار المجتمع أو يؤدي إلى نشر أفكار تُعتبر غير متوافقة مع المبادئ الدينية. لكن على الرغم من هذا التعارض، يمكن القول إن هناك إمكانية لتكامل بين الدين والفلسفة. فالفلسفة قد تسهم في تعميق الفهم الديني، من خلال تحليل الأسس الأخلاقية والفكرية للدين، وتقديم أدوات للتعامل مع الأسئلة المعقدة التي يطرحها العالم الحديث. كما أن الدين يمكن أن يستفيد من الفلسفة لتطوير خطاب ديني أكثر انسجامًا مع تطورات العصر. يمكن أن يتعايش الدين والفلسفة بسلام إذا ما تم التعامل معهما باعتبارهما مجالين معرفيين يكملان بعضهما البعض. إن إدراج الفلسفة في المناهج التعليمية بجانب الدراسات الدينية قد يساعد في بناء مجتمع متوازن، قادر على التفكير النقدي وفي نفس الوقت متمسك بالقيم الأخلاقية والروحية. في المجتمعات التي تغيب فيها الفلسفة من المناهج التعليمية بسبب الخوف من تأثيرها على الإيمان الديني، يتم تفويت فرصة ثمينة لتعزيز التفكير النقدي وتعميق الفهم الروحي والأخلاقي. قد يكون الحل في إعادة النظر في هذا التوازن بين الدين والفلسفة، والعمل على بناء مجتمع يتبنى قيم التسامح والاحترام المتبادل بين مختلف المجالات المعرفية.. ❝ ⏤الكاتبه و الدكتورة المصريه. آلاء اسماعيل حنفي ( أصغر باحثة علمية مصرية)❞ لماذا نجد البعض يكره الفلسفة؟
تُعتبر الفلسفة من أقدم العلوم الإنسانية التي تسعى إلى فهم الوجود والإنسان والعالم من حوله عبر التفكير العقلاني والنقدي. وعلى الرغم من أنها قد ارتبطت تاريخيًا بتطور الفكر البشري وتقدمه، إلا أنها قد وُجهت بكثير من الرفض والعداء في بعض المجتمعات، خاصة تلك التي تستند إلى الدين كمحور رئيسي في تكوينها الثقافي والفكري. فكيف يمكن تفسير هذه العلاقة المتوترة بين الدين والفلسفة؟ ولماذا نجد في العديد من الأحيان أن الأنظمة التي بنت ركائزها على الدين تعمل على تهميش الفلسفة في مناهجها التعليمية؟
الدين والفلسفة، على الرغم من أنهما يسعيان إلى الإجابة عن الأسئلة الكبرى المتعلقة بالحياة والوجود، إلا أنهما يفعلان ذلك بطرق مختلفة. الدين يقدم إجابات قائمة على الإيمان والتسليم بسلطة عليا تتجاوز حدود العقل البشري، في حين تسعى الفلسفة إلى فهم هذه الأسئلة عبر المنطق والتحليل العقلاني. هذا التباين في المناهج أدى إلى نوع من التعارض الظاهري بين الطرفين.
يرى البعض أن الفلسفة تطرح تساؤلات قد تُضعف الإيمان الديني، لأنها تدعو إلى التفكير النقدي وتفحص المعتقدات والأسس التي تقوم عليها. ولأن الدين يتطلب في كثير من الأحيان إيمانًا وتسليمًا دون تساؤل، فإن هذا النقد الفلسفي قد يُنظر إليه على أنه تهديد للاستقرار الديني والعقائدي
من ناحية أخرى، تلعب الأنظمة الدينية دورًا كبيرًا في تشكيل القيم والأخلاق والهويات الفردية والجماعية في المجتمعات. ولهذا، قد تنظر هذه الأنظمة إلى الفلسفة باعتبارها تحديًا لهذا النظام المتكامل، لأنها قد تدعو إلى إعادة النظر في بعض الأسس العقائدية أو الاجتماعية التي تُعتبر مقدسة أو ثابتة.
في هذا السياق، يصبح تغييب الفلسفة من المناهج التعليمية وسيلة للحفاظ على هيمنة الفكر الديني، وذلك لضمان بقاء الأجيال الجديدة متشبثة بالقيم والعقائد التي تمثلها هذه الأنظمة. فالأنظمة التي بنت ركائزها على الدين قد ترى في الفلسفة خطرًا يمكن أن يُزعزع استقرار المجتمع أو يؤدي إلى نشر أفكار تُعتبر غير متوافقة مع المبادئ الدينية.
لكن على الرغم من هذا التعارض، يمكن القول إن هناك إمكانية لتكامل بين الدين والفلسفة. فالفلسفة قد تسهم في تعميق الفهم الديني، من خلال تحليل الأسس الأخلاقية والفكرية للدين، وتقديم أدوات للتعامل مع الأسئلة المعقدة التي يطرحها العالم الحديث. كما أن الدين يمكن أن يستفيد من الفلسفة لتطوير خطاب ديني أكثر انسجامًا مع تطورات العصر.
يمكن أن يتعايش الدين والفلسفة بسلام إذا ما تم التعامل معهما باعتبارهما مجالين معرفيين يكملان بعضهما البعض. إن إدراج الفلسفة في المناهج التعليمية بجانب الدراسات الدينية قد يساعد في بناء مجتمع متوازن، قادر على التفكير النقدي وفي نفس الوقت متمسك بالقيم الأخلاقية والروحية.
في المجتمعات التي تغيب فيها الفلسفة من المناهج التعليمية بسبب الخوف من تأثيرها على الإيمان الديني، يتم تفويت فرصة ثمينة لتعزيز التفكير النقدي وتعميق الفهم الروحي والأخلاقي. قد يكون الحل في إعادة النظر في هذا التوازن بين الدين والفلسفة، والعمل على بناء مجتمع يتبنى قيم التسامح والاحترام المتبادل بين مختلف المجالات المعرفية. ❝
⏤ الكاتبه و الدكتورة المصريه. آلاء اسماعيل حنفي ( أصغر باحثة علمية مصرية) -